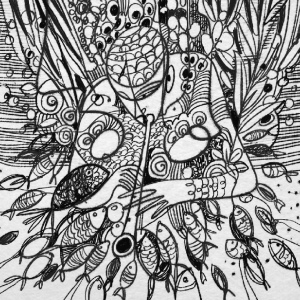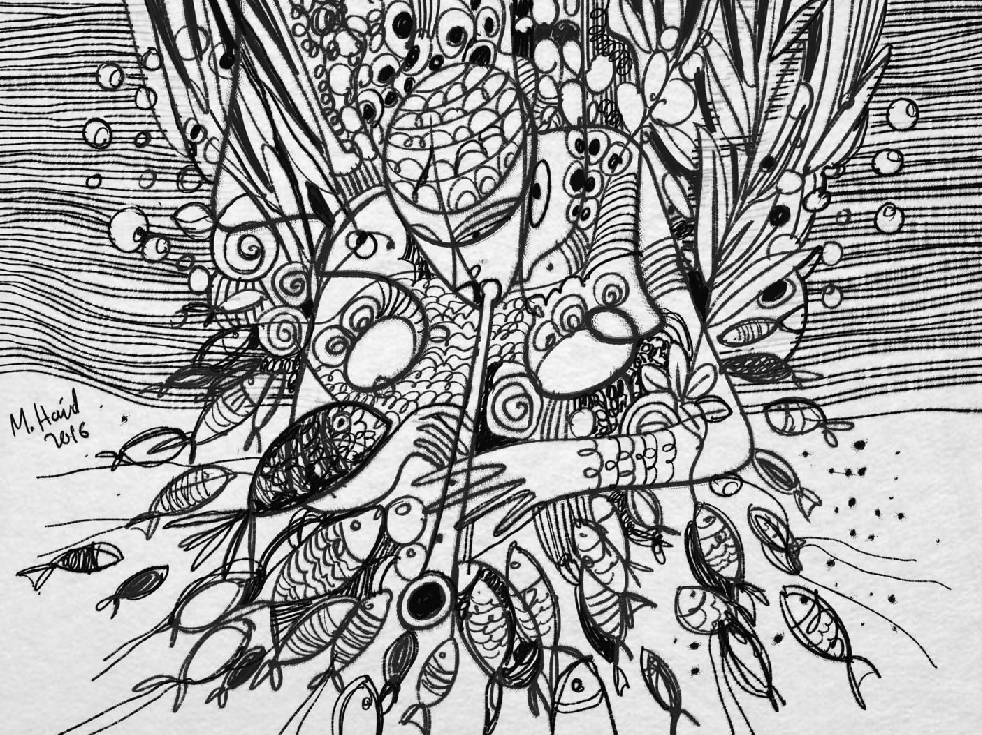
ما من موضوعٍ أعجزَ العلماءَ وأفحمَ الفلاسفة وأيأسهم جميعَهم من الوصولِ إلى فهمٍ موحَّدٍ بشأنِه مثل مفهومِ الزَّمان؛ فهو كثيرٌ، وليس واحداً؛ وهو أيضاً تعاقبٌ من جانب، ثمَّ هو تزامنٌ من جانبٍ آخر؛ وهو كذلك انتقالٌ مطَّرد نحو المستقبل، وهو المدَّةُ الَّتي يستغرِقُها ذلك الانتقال؛ وهو في آنٍ يتكثَّفُ “بلحظةٍ مرَّت وفي هذا الشُّروق”، وفي آنٍ آخرَ ينثالُ على “كلِّ ما تنفكُّ عنه شرانقُ الزَّمنِ الوهوب”؛ والزُّمانُ بُعدٌ رابعٌ في المعادلاتِ الفيزيائيَّة إلى جانبِ الطُّول والعرض والارتفاع، وهو إلى ذلك سهمٌ ينطلقُ في اتِّجاهٍ واحد: من ماضٍ عبر آنٍ إلى آتٍ- أو هكذا هو الفهمُ السَّائد والمعروفُ بالحِسِّ العام، إلَّا أنَّ لِغالبيَّةِ العلماءِ والفلاسفةِ المعاصرينَ رأياً مُخالِفاً للفطرةِ السَّليمة، إذ يعتقدونَ أنَّ الزَّمانَ شبيهٌ بالمكان؛ فمثلما أنَّ هناك دائماً أماكنَ أخرى يُمكِنُ الذَّهابُ إليها، فكذلك هناك “أزمنةٌ” يُمكِنُ نظريَّاً السَّفرُ إليها في كلِّ آن، سواءً كانت في الماضي السَّحيقِ أو المستقبلِ المفتوحِ الآفاق. ويُشيرُ مَن يتبنَّونَ هذا الاعتقادَ إلى قولِ ألبرت آينشتاين بأنَّ “التَّمييزَ بين الماضي والحاضرِ والمستقبل ما هو إلَّا وهمٌ مُقيم”، بينما يُنبِّه آخرونَ إلى أنَّ مقولتَه الشَّهيرةَ هذه قد قِيلت في سياقِ فَقدِ صديقٍ حميم، هو ميكيلي بيسو، وأنَّها موجَّهةٌ في الأساسِ ضمنَ رسالةٍ إلى أُختِ صديقِه بيسو، بهدفِ تعزيتِها في ذلك الفقدِ الأليم.
يستندُ المعتمدونَ على مقولةِ آينشتاين إلى مذهبِ “الأبديَّة” (“إتيرناليزم”)، الَّذي يذهبُ المعتقدونَ به إلى القولِ بأنَّ الزَّمانَ، على تعدُّدِه الظَّاهرِ للعيان،ِ مُدمَجٌ بكليَّاتِه داخل كونٍ مُتَكَتِّل (“بلوك يونيفيرس”)، بحيثُ يتساوى بداخلِه الماضي والحاضرِ والمستقبل، وبحيثُ يُمكِنُ الانتقالُ فيه من أيِّ واحدٍ منها إلى الآخر، وإن تعثَّرتِ السُّبُلُ العمليَّةُ لتحقيقِ ذلك حتَّى الآن؛ بينما يستندُ الآخرونَ إلى مذهبِ “الحاضريَّة” (“بريزنتزم”)، الَّذي لا يقِرُّ المعتقدونَ به بوجودِ أيِّ واقعٍ فعليٍّ سوى واقعِ الحاضرِ سريعِ الزَّوالِ والماثلِ بشكلٍ متجدِّد أمامَ الحواس. والزَّمانُ هو مقياسُ الحركةِ عند أرسطو مُنشئِ علمِ الفيزياء، إلَّا أنَّه بناءٌ رياضيٌّ مستقلٌّ عن حركةِ الأشياءِ عند نيوتن مُدشِّنِ الفيزياءِ الحديثة، بينما هو مُندَمِجٌ فيها عند آينشتاين، وتتأثَّرُ أجهزةُ قياسِه بسرعةِ الأجسامِ وبُعدِها أو قُربِها من مركزِ الجاذبيَّة أو موجاتِها (“الزَّمكان”)؛ وعندما نصِلُ إلى فيزياءِ الكوانتم (أي ميكانيكا الكم) يتهدَّدُ الزَّمانُ ذاتُه بالتَّلاشي (أي اختفاؤه من المعادلاتِ الفيزيائيَّة) إذا صحَّ أنَّ له خواصَّ كوانتيَّة (أي أنَّه جُسيمٌ متناهٍ في الصِّغر، لا يُمكِنُ تحديدُ مَوضعِه أو سُرعتِه إلَّا بتفاعُلِه مع أشياءَ أخرى). وعلى المستوى النَّفسي، تمضي ساعاتُ البهجةِ والسُّرورِ سِراعاً، بينما تتباطأُ السَّاعاتُ بُطئاً قاتلاً عند انتظارِ نتائجَ مصيريَّةٍ أو عندما يرزحُ مُصابٌ بلا رفيقٍ بمَرضٍ عُضالٍ تحت وطأةِ الألم.
يختلفُ الواقعُ الافتراضيُّ الَّذي يتمُّ التَّعبيرُ عنه عبر معادلاتٍ رياضيَّةٍ ثابتة عن الواقعِ الفعليِّ المتغيِّر، ولا تقتربُ منه إلَّا بدرجاتٍ من الاحتمالِ لا تصِلُ أبداً إلى التَّطابقِ معه؛ وإن حدثَ ذلك، فلا سبيلَ إلى الاستيقانِ من حدوثِه. وحتَّى يكونَ للمعادلاتِ الفيزيائيَّة قوَّةُ المنطقِ الرِّياضي، افترضَ إسحق نيوتن أنَّ هناك مكاناً مُطلَقاً يقبعُ خلف ما يُحيطُ بأشياءِ الكون، كما أنَّ هناك زماناً مُطلَقاً يمضي بإيقاعٍ منتظم بمعزلٍ عن علاقتِه بالأشياءِ المحسوسة. إلَّا أنَّ آينشتاين وضعَ افتراضاً آخرَ تمَّ لاحقاً التَّحقُّقُ منه وإثباتُه، وهو أنَّ الأجرامَ الضَّخمة تؤدِّي إلى تمويجِ (“التواءِ”) المكانِ حولها؛ وبالتَّالي، تقودُ إلى اختلافِ قراءاتِ آلاتِ القياسِ الَّتي تُخبِرُ عنِ الزَّمانِ تَبَعَاً لقُربِها أو بُعدِها من مركزِ تلك الأجرام. وكان آينشتاين قد افترضَ أيضاً اختلافَ السَّاعاتِ، تَبَعَاً لسرعةِ حاملِها وقتَ القياس؛ وقد أُثبِتَ ذلك الافتراضُ مِراراً وتَكراراً بعد موتِه. في المقابل، تتمتَّعُ الأرضُ بساعتَيْنِ كوكبيَّتَيْن، لا تُخبِرانِ فقط عنِ الزَّمانِ وإنَّما تمنحانِ ساكنيها ضياءً ونوراً: “هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ”؛ (سورة “يونس”، الآية رقم “٥”). ففي كلِّ كَسرٍ من الثَّانية، ينعَمُ قِسمٌ من الأرضِ بشُحنةِ ضوءٍ لاستدامةِ الحياةِ على سطحِها؛ وفي كلِّ كَسرٍ من الثَّانية، يشهدُ قِسمٌ آخرُ منها مغيبَ شمسٍ، إيذاناً بانتهاءِ يومٍ وهبوطِ مسائه. هذا بشأنِ دورانِ الأرضِ حول مِحورِها؛ وعند دورانِها حول الشَّمس، تتتابعُ الفصول: “فيختالُ الرَّبيعُ “ضاحِكاً”، فيعقُبُه صيفٌ قائظ؛ ثم يأتي خريفٌ ماطِرٌ، لِيعقُبُه شتاءٌ قارِس. أمَّا القمرُ الَّذي يشِعُّ نورُه على الأرضِ عبر منازلَ، فهو أساسُ التَّقسيمِ الشَّهريِّ والأقربُ إلى دورةِ الإنجابِ البشري، هذا إضافةً إلى اعتمادِه توقيتاً للعبادات: الصَّومُ والحجُّ وتحديدُ الشَّهرِ الحَرَام.
تَبَعَاً لاختلافِ الزَّمانِ وتعدُّدِه، أصبحت هناك طريقتانِ لإنتاجِ المعرفة: الأولى، تتَّبَعُ مسار الفيزياء الكلاسيكيَّة بشأنِ الزَّمان، فتستقصي عن تاريخِ الظَّواهرِ والأمم، وأصلِ اللُّغاتِ والممارساتِ الاجتماعيَّة للنَّاطقينَ بها، بحيثُ يُفسِّرُ السَّابقُ منها اللَّاحقَ وفقاً لمبدأ السَّببيَّة المعروف؛ ومن أشهرِ المذاهبِ المُتَّبِعة لهذه الطَّريقة: علمُ الأحياءِ الدَّارويني، الَّذي يبحثُ في أصلِ الأنواع؛ والماركسيَّة، الَّتي تُحلِّلُ الصِّراعَ الطَّبقيَّ وتؤمنُ بوجودِ حتميَّةٍ تاريخيَّةٍ لتطوُّرِ المجتمعاتِ البشريَّة؛ والظَّاهراتيَّة، الَّتي تُنَصِّبُ الزَّمانَ مناطاً للكينونة؛ والوجوديَّة، الَّتي خرجت من مِعطفِ الظَّاهراتيَّة بوضعِها حياةَ الفردِ وتجارِبَه الذَّاتيَّة في مواجهةٍ دائمة مع الزَّمانِ الَّذي يُهدِّدُ بالقضاءِ عليها وعلى كلِّ ما بنته من قيمٍ زائلة. أمَّا الطَّريقةُ الثَّانية، فتتَّبِعُ المسارَ الرِّياضي، فتقضي بتجميدِ الزَّمانِ في قوانينَ شاملة، لا تُفسِّرُ الظَّواهرَ فقط وإنَّما تصدرُ منها الأفعالُ كذلك؛ ومن أشهرِ المذاهبِ المُتَّبِعة لهذه الطَّريقة: الكانتيَّة، الَّتي تنصُّ على أنَّ التَّصرُّفاتِ العقلانيَّة تصدرُ عن قانونٍ أخلاقيٍّ شامل؛ والبنيويَّة، الَّتي تُجَمِّدُ موضوعاتِها في آنٍ ثمَّ تبحثُ عن العلاقاتِ الَّتي تُحكِمُ البناءَ بمعزلٍ عن الصَّيرورة؛ والتَّفكيكيَّة، الَّتي تدرسُ الفروقَ والآثارَ القائمة في البناءِ وتؤدِّي إلى تقويضِه من غيرِ رجوعٍ لماضٍ أو تنبُّؤٍ بمستقبل. غير أنَّ هناك طريقةَ تشومسكي الَّتي أحدثت ثورةً في عِلمِ اللِّسانيَّاتِ وتستعصي بمفردِها على التَّصنيف؛ لكنَّها بتركيزِها على التَّركيبِ النَّحوي (“السِّنتاكس”)، ابتدعت قواعدَ لغويَّةً أو نحواً شاملاً يتضمَّنُ قوانينَ رياضيَّةً معقَّدة، لا يحتاجُ الطِّفلُ إلى تعلُّمها، لأنَّه بحسب صاحبِ النَّحوِ التَّوليديِّ قد وُلِدَ مُشَبَّعاً بها، إذ إنَّها مُتشابِكَةٌ لديهِ منذُ البدءِ في مساراتِه العصبيَّةِ الدُّماغيَّة.
على خلافِ الزَّمانِ الدُّنيويِّ المتعدِّد، فإنَّ الزَّمانَ الَّذي يليقُ بالإله الواحدِ الصَّمد هو زمانٌ سرمدي؛ لذلك، فإنَّ ما سُطِّرَ بعلمٍ في أمِّ الكتابِ منذُ الأزلِ يستدعي عند تنزيلِه إلى الأرضِ في وقتٍ معلوم إلى تناسقٍ تامٍّ في مفهومَيِ الزَّمانِ والمكان، إضافةً إلى الإمساكِ بطرفَيِ التَّزامنِ والتَّعاقبِ اللَّذينِ أحدثا في الأرضِ طريقتينِ لإنتاجِ المعرفةِ البشريَّة؛ وما من واقعةٍ تكشِفُ عن هذا التَّناسقَ لدى مَنِ اكتملَ إيمانُهم مثل واقعةِ الإسراءِ والمِعراج؛ فقد سارعَ أبو بكرٍ إلى تصديقِها، فسُمِّي بذلك “صِدِّيقاً”. والإسراءُ في حقيقتِه سيرٌ بِلَيلٍ عبر مكانٍ بسرعةٍ فائقةٍ أمكَنَ التَّدليلُ عليها بوصفِ خارطةِ الطَّريقِ من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى؛ أمَّا المِعراجُ، فلم يكُن هناك سبيلٌ إلى إثباتِه إلَّا بالدَّليلِ الظَّرفيِّ لواقعةِ الإسراءِ نفسِها، ممَّا استدعى وجودَ درجةٍ عاليةٍ من التَّصديقِ لم ينَلْها وقتَها سوى أبي بكر؛ وللاقتداءِ به، ينبغي للمُلمِّينَ بالعلومِ الحديثةِ عدمُ التَّقيُّدِ مُطلقاً بسلحفائيَّةِ سرعةِ الضَّوء (٣٠٠ ألف كيلومتر في الثَّانية أو ١٨٦ ألف ميل في الثَّانية من خلال فضاءٍ “فارغ”) الَّتي تُوصِلُهُ إلى أقربِ مَجَرَّةٍ في مليونَي عام؛ وما من آيةٍ تُمسِكُ بطرفَيِ التَّزامنِ والتَّعاقبِ مثل ما جاء في سورةِ “الإسراء”: “وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا”؛ (سورة “الإسراء”، الآية رقم “١٠٦”). فما كانَ مجموعاً في مكانٍ واحد (لوحٍ محفوظ) يتمُّ تفريقُه في فترةٍ تصِلُ إلى ٢٣ عاماً، ولا يتمُّ الاستجابةُ إلى مُشرِكِي مكَّة بتنزيلِه جملةً واحدة، وإنَّما يتمُّ تنزيلُه تنزيلاً لِتَسهُلَ قراءتُه واستيعابُه، ولِيَصعُبَ على المُشرِكينَ تحريفُه؛ فيُصبِحُ التَّنزيلُ قرءاناً بجمعِه في صدورِ المؤمنين (ولاحقاً بتثبيتِه في المصاحفِ العثمانيَّة)، ثمَّ هو أيضاً فرقانٌ بحكم التَّنزيلِ المتفرِّقِ عبر عددٍ من السِّنين.
نَزَلَ القرءانُ أوَّلَ مرَّةٍ في مكَّةَ على أُمِّ القرى وما حولَها، ثمَّ تتابَعَ نُزُولُه لاحقاً في المدينة؛ على أنَّ الأمرَ الحاسمَ فيه ليس هو عمَّا إذا كان مكِّيَّاً أم مدنيَّاً (سفريَّاً أم حضريَّاً) وهو تقسيمٌ مكانيٌّ أو عمَّا إذا كان قد نَزَلَ قبل الهجرةِ أم نَزَلَ بعدَها (ليليَّاً أو نهاريَّاً) وهو تقسيمٌ زمانيٌّ، وإنَّما الأمرُ الحاسمُ هو تفريقُه فُرقاناً أم جمعُه قُرءاناً (ومنه أتتِ التَّسميةُ الغالبةُ للتَّنزيل)؛ فبِحُكمِ تفريقِه فُرقاناً، يكتسِبُ الزَّمانُ أهمِّيَّةً قصوى، وتشتدُّ الحاجةُ إلى معرفةِ أسبابِ النُّزولِ حتَّى تتأسَّسَ عليها الأحكامُ الشَّرعيَّة، حيثُ يضطَّلعُ النَّسخُ والإنساءُ بدورٍ مِحوريٍّ في مواكبةِ الأحكام مع ما يكشفُ عنه الزَّمانُ من تغيُّرٍ في المكانِ وفي طبائعِ قاطنِيه؛ وبِحُكمِ جمعِه قُرءاناً في صدورِ حَفَظَتِه، بناسخِه ومنسوخِه، يتمُّ تأكيدٌ لأصلِه العُلويِّ في لوحِه المحفوظ، وتعزيزٌ لصيرورتِه الأرضيَّة سدَّاً منيعاً ضدَّ عصفِ الزَّمان، إذ إنَّه موجَّهٌ في الأساسِ إلى النَّاسِ قاطبةً في أزمنتهِمِ المتعاقِبة؛ وما تجربةُ تطبيقِ أحكامِه في المدينةِ إلَّا أُنموذجاً يُحتذَى به في كيفيَّة إدارةِ المدن، بتمثُّلِ الفُرقانِ عند الأخذِ من القُرءان، أي بإيجادِ نظائرَ عقليَّةٍ أو اتِّفاقاتٍ يتمُّ التَّوصُّلُ إليها بإجماعِ العارفينَ المتحرِّرينَ من رغباتِ الحُكَّامِ وتسلُّطِهم لِتقترِبَ بقدرِ المُستطاعِ ممَّا قام به النَّسخُ والإنساء، إذا ما اشتدَّتِ الحاجةُ إليهما مع تغيُّرِ الزَّمان. ويُلاحظُ أيضاً أنَّ تقسيمَ القُرءانِ إلى مكِّيٍّ ومدنيٍّ غير أنَّه تقسيمٌ مكاني، هو أيضاً تقسيمٌ خارجيٍّ تمَّ إسقاطُه إلى داخلِ المَتن، في حين أنَّه تحدَّثَ عن نفسِه بوصفِه فُرقاناً وبوصفِه قُرءاناً، وهو تمييزٌ زمنيٌّ داخلي، الأوَّلُ يُشيرُ إلى زمنٍ محدَّدٍ لا يتعدَّى ٢٣ عاماً، بينما يُشيرُ الآخرُ إلى كلِّ الأزمنة؛ وعلى المستوى المكاني، تتمُّ دائماً الإشارةُ البعيدةُ إلى الكتابِ وآياتِه (“ذلك الكتاب”؛ و”تلك آياتُ الكتاب”، خصوصاً بعد الحروفِ المقطَّعةِ في أوائلِ السُّوَر) تأكيداً لأصلِه العُلُوي، بينما تُستخدَمُ الإشارةُ القريبةُ إلى القُرءانِ أو قَرنِ الكتابِ بالإنزال (“هذا القُرءان”؛ “وهذا كتابٌ أنزلناه”) للدَّلالةِ على تنزيلِه وتوفُّرِه الدَّائمِ على الأرض.
أمَّا المصاحفُ المتوفِّرةُ لدينا اليوم، فقد تأخَّرَ ظهورُها لِسببَيْن، الأوَّلُ مرتبطٌ بعهدِ الرَّسولِ والثَّاني قد نشأ في أعقابِ مَمَاتِه؛ فقد تعنَّتَ مُشرِكو مكَّةَ بادئ الأمرِ وغالوا في رفضِ دعوةِ محمَّد، وقالوا له لن نقتنعَ بدعوتِك حتَّى إذا ارتقيتَ إلى السَّماء: “وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ”؛ (سورة “الإسراء”، الآية رقم “٩٣”)؛ وكانتِ الخَشيةُ أن يتعاملوا معه كما تَعاملَ وُجهاءُ مكَّةَ وتُجَّارُها مع النَّسيء (وهو تأخيرُ شهرٍ من الأشهُرِ الحُرُمِ الأربعة)، “يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا”؛ (سورة “التَّوبة”، الآية رقم “٣٧”)؛ وقد عَلِمَ مَن لا يخفَى عليه شيءٌ مقصدَهم، وهو التَّصرُّف في آياتِه: ” تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا”؛ (سورة “الأنعام”، الآية رقم “٩١”). وبعدِ وفاةِ الرَّسول، خشِيَ أبو بكرٍ من الإقدامِ على نشرِ المُصحَفِ والاضطِّلاعِ بعملٍ لم يقُم به رسولُ اللهِ بنفسِه، إلَّا أنَّ خليفتَه عمرَ كان يَلِحُّ عند أبي بكرٍ في طلبِ نشرِه لِخَشيتِه من توالي مَمَاتِ حَفَظَتِه المعروفين، إلَّا أنَّ عمليَّةَ جمعِ مخطوطاتِه الَّتي دوَّنَها كُتَّابُ الوحيِ ومضاهاتِها للتَّأكُّدِ من صحَّتِها وخُلُوِّها من الأخطاء الإملائيَّة لم تتمَّ إلَّا أثناء خلافتِه، ولم يكتمل صدورُ أوَّلِ ستِّ نُسَخٍ من المُصحَفِ إلَّا في عهدِ الخليفة عثمان، وهي ما بات يُعرَفُ لاحقاً بالمصاحفِ العثمانيَّة الَّتي تُنتَسَخُ منها بقيَّةُ المصاحف. وقد أثبت مرورُ الأيَّامِ وتتالي الأزمنةِ والحقبِ أنَّ قرارَ النَّشرِ كان قراراً إداريَّاً صائباً وعملاً دينيَّاً بالغَ الأهميَّة، حيثُ انتقلتِ النُّسَخُ من البَصرةِ إلى شيرازَ، ومن الكوفةِ إلى نيسابورَ، ومن الشَّامِ إلى الأندلسِ، ومن مكَّةَ إلى فاسٍ، ومن المدينةِ إلى تمبكتو؛ إلى أن وصلتنا اليومَ عبر المطابعِ الحديثةِ والأسطواناتِ المضغوطة وأشرطةِ الكاسيت والفيديو وعبرِ شبكةِ الإنترنت.
في الختام، نُذكِّرُ بما قلناه بأنَّ تقسيمَ القُرءانِ إلى مكِّيٍّ ومدنيٍّ قد جاء إسقاطاً على مَتنِه من خارجِه؛ ونُنبِّهُ كذلك إلى أنَّ غالبيَّةَ المفرداتِ المُستخدَمةِ لوصفِ كلامِ اللهِ هي دَوالٌ ارتبطت بالوسائل، ولم ترتبط بالدَّلالة، وهي غايةُ الكلامِ الإلهي: فاللَّوحُ هو وسيلةٌ لحفظِ الكلام؛ والكتابُ كذلك مكانٌ لحفظِ حروفِه؛ والفُرقانُ وسيلةٌ لتوصيلِ الكلام مُفَرَّقاً في أوقاتٍ معلومة؛ والقُرءانُ وسيلةٌ لجمعِ الكلامِ في الصُّدورِ أوَّلاً؛ والمُصحفُ هو جَمعُه على صُحفٍ في مرحلةٍ تالية؛ والتَّنزيل بواسطةِ الوحيِ وسيلةٌ لنقلِه من السَّماء إلى الأرض؛ وكذلك كلُّ المصطلحاتِ المُستخدمةِ في التَّوصيف، مثلُ الكلامِ والقَول (على فرقٍ شاسعٍ بينهما)، والمَتنِ والنَّصِّ والخطاب. أمَّا المفردةُ الوحيدةُ المرتبطةُ بالدَّلالة، فهي الذِّكرُ: ” إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ “؛ (سورة “الحِجر”، الآية رقم “٩”)؛ وهو غايةُ الكلامِ الإلهي: ” وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ”؛ (سورة “القمر”، الآية رقم “١٧”)؛ والرَّسولُ نفسُه بصفتِه وسيلةً ينحصرُ دورُه في الأساسِ بالتَّذكيرِ بهذا الذِّكرِ وليس إكراهَ النَّاسِ عليه: ” فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ؛ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ”؛ (سورة “الغاشية”، الآيتانِ رقم “٢١” و”٢٢”)؛ إلَّا أنَّ وسيلةَ الذِّكرِ الرَّئيسيَّة بعد اتِّباع النَّبيِّ هي العقلُ البشري: “كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ” (سورة “ص”، الآية رقم “٢٩”)؛ وعظمةُ هذه الوسائلُ مجتمِعَةً تُعزِّزُ أضعافاً مُضاعفةً من الغايةِ الكبرى، وهي الذِّكر: “الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ”، الآية رقم “٢٨”).