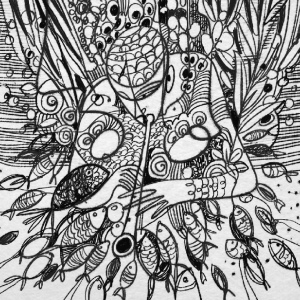المعنى والرمز
“يقول زهير، في معلقته، إنه رأى القدر، خلال انصرام ثمانين حولاً من الألم والمجد، يصطدم مراراً وعلى حين غرة بأناس مثلما تَخبِط ناقة عشواء؛ ويعتقد عبد الملك أن هذه الصورة لم يعد بإمكانها أن تثير دهشة أحد. بوسعي أن أجيب على هذه الملاحظة بأمور عدة: الأمر الأول، أنه إذا كانت غاية القصيدة إثارة الاستغراب فزمنها لن يقاس بالقرون وإنما بالأيام والساعات وربما الدقائق. أما الأمر الثاني فهو أن الشاعر الذائع الصيت مكتشف أكثر مما هو مخترع”.
- (بحث ابن رشد)[i]، (المرايا والمتاهات)، بورخيس، تر: إبراهيم الخطيب
كانت لِتكونَ معاني لا رموزاً، لو أن حياتنا متصلة بالأسلاف، ولكن للانقطاعات المستمرة بفعل التاريخ، تحولت إلى رموز نتوق لتحويلها إلى معانٍ، فكل ما لا يعاش ويوجد في الوعي مجلوبا كتابةً يصير رمزاً. وهذا ما ضلل تميم البرغوثي[i] في قراءته لبردة كعب بن زهير في مدح الرسول، فظن أن سعاد ترمز لزمن الجاهلية الذي يودعه الشاعر وأن الرحلة التي قطعها على ناقته، موجهاً لها صوب المدينة لا تجاه سعاد؛ التي أمست بأرضٍ لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل؛ اللواتي يسرن زمنيا للخلف، وأن تقطع النياق الزمن وترجع به للوراء صورة عجيبة للغاية، وتشبه حلماً رأيته بأني كنت في الليل وأنظر لشمس الصباح المشرقة، هناك في البعيد. ظنها رحلة ترمز للانتقال بين زمنين، قراءة تميم للبردة جميلة جداً لكنها غير صائبة تاريخياً ومُشجية، فلم يحدث التغيير كما نظن نحن، كأنه قفزة هائلة في وعي العرب، وإنما بقي بعضهم على جاهليته زمناً، وعاد بعضهم إليها في أزمنة لاحقة. وهي مُشجية لأني وددت لو كانت معاني قريبة المنال، نطلبها بالمعيشة، لا ما صارت إليه رموزاً، هناك في الأعلى، تجتاح أحلامنا، ولنذكر مجازات مصطفى سعيد ومجازات الراوي في (موسم الهجرة إلى الشمال). كانت مجازات الراوي مستمدة من الطبيعة القريبة إليه، لقد شبه وجوده بوجود النخلة، “مستمراً ومتصلاً ومتكاملاً وذا أهمية” كما وصف نفسه أثناء وجوده قرب النيل، لكنه نسي انقطاعاً عايشه هو وأسلافه بفعل الاستعمار والحداثة، وكلاهما يمثلان في جوهرهما انقطاعاً عن الطبيعة. جاء مصطفى سعيد ليذكره بالانقطاع، رغم أن مصطفى نفسه كان الانقطاع بالنسبة إليه موغلاً في البعد، فمجازاته مستمدة من طبيعة قديمة للغاية، رماح ونشّاب وبعير مسرجة، كان كائناً تاريخياً يحن لمصير أجداده الغازين، ولكن دون رسالة.
يشعر كلُّ من قرأ (موسم الهجرة إلى الشمال) أنه يقرأ قصيدة، ولقد حاولت مراراً أن أصفها بالقصيدة فاستعصى عليَّ ذلك، لأن بها حيلاً في الزمن والسرد ليست في القصائد، ولكن بها شبه بالقصائد في عدة أوجه. أولاً، الابتداء بالعودة للديار كما فعل شعراء العرب، أي الوقوف على الأطلال. وفي حقيقة الأمر فإن مفتتح الرواية غاية في الشعر، ومطابق لمطالع القصائد القديمة، حتى أنني وجدت قولاً للطيب صالح في حوار له يؤكد هذا، قال: “كنت أقف أمام القرية، كمن يقف أمام طلل”. أمر آخر هو أن أغلب مقاطعها تأملية غنائية، وأن لحظاتٍ معدودةً في الرواية امتدت فيها حركة الزمن واتسعت، لكن الجزء الأعظم منها كان غاية في التكثيف وموغلاً في المجاز والرمز، وقائماً على المونولوج الداخلي أو المناجاة إن صح التعبير، أيضاً فإن حبكتها لا تقوم على تتابع أفعال تؤدي لذروة ما، كانت الذروة هي لحظة حكي مصطفى سعيد لقصته للراوي[i]، أما بعدها فكله استرجاع للنص المنسي وجدال معه، وتكشّف لمعانيه بتدرج، وفي النهاية فإن مختتمها شعري أيضاً.
هوامش وإحالات
[1]إضاعة المعنى وقصور الخيال/ التمثل عن مفارقة منابعه: الجسد والذاكرة، وعجز الوعي عنالعبور نحو أزمنة لم يعشها، والحيرة أمام الزمن. هذي المعاني تمثل مدار قصة بورخيس محكمة البناء “بحث ابن رشد”، ففيها يبحث بورخيس عن ابن رشد أثناء بحث الأخير عن معنى كلمتي ” الكوميديا والتراجيديا”، يتخيل بورخيس يوما في حياة ابن رشد؛ بادئا بلحظة حميمية هي استغراقه في المحاججة ودحض آراء الغزالي في كتابه “تهافت الفلاسفة” فيما يلي علم الله ومعرفته بالكليات والجزئيات، هذه الأسطر يليها شعور غامر بالمكان يجتاح ابن رشد، بصوت الماء المتدفق من نافورة إلى امتداد مدينة قرطبة ومبانيها–شعور ذو صلة ببورخيس أولا، كما سوف يوضح في نهاية القصة، ومتصل كذلك بمسألة علم الله بكل العالم، وأجزائه التي انتهى ابن رشد من التفكير فيها توا، أي محاولة لتعريض الإنسان الفاني ومحدود القدرة لهذه المعرفة، هذه اللحظات تمثل أوج وعي ابن رشد المتخيل. إن الشخصية الخيالية فيها شديدة الحضور ومكتملة: تكتب وتقرأ وتتأمل، دون أن تنسى جسدها- لكن هذا الشعور الكلي بالعالم، بالجسد، يتلاشى أو يقل شيئا فشيئا –في مقطع لاحق، لا يستبين ابن رشد صورته في المرآة، لأنه في حقيقة الأمر ليس ابن رشد، وإنما بورخيس الأعمى، والذي بطبيعة الحال لم ير وجه ابن رشد، وفقد بمرور الزمن دهشة إبصار وجهه- ويبصر ابن رشد المتخيل ويسمع ويناقش داخل يوم بورخيس، عدة مشاهد تمثل مفهوم المحاكاة –المفهوم البادئ والمؤسس للمسرح، والذي بإدراكه تماما يتضح معنى الكلمتين اللتين يبحث عنهما ابن رشد-، فهو يرى أطفالا يمثلون شكل المئذنة، والمؤذن معتليا لها، وجماعة المصلين واقفة وراء الإمام، لكن تلك اللعبة لا تترابط داخل ذهنه بما يشغله، أي بإيجاد معنى لكلمتين جاءتا في كتاب أرسطو للشعر، هذا العمى الماثل في عدم القدرة على الربط بين المرئي والمفكر مفهوم جوهري في القصة، يسمع ابن رشد في الجزء الثاني في القصة، والذي يتموضع داخل حفل أقامه أحد الأمراء، حكاية لرحالة يصف فيها أعجوبة قابلته في بلاد الصين، وهي قيام مجموعة من الأشخاص بتمثيل أوضاع وحركات ومشاعر مختلفة، دون وجود دافع/مؤثر حقيقي لها، أي أنهم مثلا يدعون أنهم وراء قضبان ولا سجن، يستنكر ابن رشد والجماعة المصغية للحكاية هذا الفعل، لم الحاجة لجماعة لتمثيل قصة، فصوت رجل واحد وجسده كافيان لمحاكاة أي حدث، هكذا مرة أخرى يضيع ابن رشد المعنى، لتنتهي القصة في جزئها الأخير، داخل منزل ابن رشد، حيث يدون معنى الكلمتين بعد ظنه أنه قد فهمهما، فيسمي ” الكوميديا” هجاء، و”التراجيديا” مدحا، وهما غرضان شائعان في سياق الشعر العربي القديم –الذي يدافع ابن رشد عن بلاغته في الحفل حين يزعم أحدهم بأن الزمن قد أبلى معانيه وصوره، ليؤكد ابن رشد أن زمن الشعر لا يقاس بالفلك، ولكن بلحظات متناهية في الدقة تماثل الشعور الذي تستبطنه الكلمات والصور التي تحاكيها- ولكنهما بعيدان جدا عن المعنى الحقيقي لكلمتي أرسطو، أي المأساة والملهاة.
تنتهي القصة بملاحظة توضيحية –وهو أمر مستغرب، وإن درج بورخيس على فعله، أي تفسير ألغازه- يقول فيها بورخيس أن القصة تروي مسارا انهزاميا لمحاولته تخيُّل يوم في حياة ابن رشد –شخصية تاريخية- فهو لا يعرف عنه سوى ما قرأه في كتب بعينها، وأن تلك المحاولة آلت إلى خسارة، لكونه لم يتخيل سوى نفسه. يحمل بورخيس عنا عبء تفسير القصة، إنها ببساطة، تتراوح بين القدرة على تخييل لحظة ماضية، لم يعشها الوعي- يتحقق ابن رشد في جمل ومقاطع، بينما يستأثر بورخيس بأخرى- تشير القصة لمسائل تتعلق بتعريف الشخصية الخيالية، وللعلاقة بين المحاكاة والحكي، ولموضع الخيال في الزمن.
[1] عن(بردة كعب بن زهير)، أول الشعر، تميم البرغوثي
[1]حبكة الرواية قائمة على الاكتشاف المتدرج والإخبار المتفاوت بين التقديم والتأخير، غياب الحدث الذي إن وجد فهو مخبر عنه، انقضى وتم في الماضي، والحدث المركزي في الرواية هو محكي، قيل خلال ليلة واحدة، وتنبني الحبكة على أثر ذلك المحكي في نفس المستمع/القارئ، واسترجاعهالمتكرر للمحكي في ظروف ومواقف مختلفة. كل لحظة وصفية هي لحظة شعرية وتأملية وغنائية، ففي داخل اللحظة يمتزج الإدراك بالتأمل بالأحكام.