قراءة لقراءات: مسعى الفرد ومساعي الجماعة (4)


لا تَظلِموا المَوتى وَإِن طالَ المَدى.. إِنّي أَخافُ عَلَيكُمُ أَن تَلتَقوا
-المعري
لا أحب الأساطير اليونانية، هِباتٍ كانت أم لعنات، وإن كنتُ أستأنس بها أحياناً -أتذكر منها: نرسيس، ألكساندرا المتنبئة بالشرور، أورفيوس المغني، كيويبيد وأخريات، بعضها عرفته من قراءات قديمة للإلياذة، والبعض الآخر وجدته في استعارات لشعراء غربيين وهو أمر مفهوم عندي، وأحياناً عند شعراء عرب وهذا مستغرب! لكن إحداها شغلت ذهني هذا اليوم، أسطورة تحكي أن ملكاً يُدعى ميداس منحته الآلهة القدرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب، وهذه هبة في البداية تصير كارثة فيما بعد، لكونه يصبح غير قادرٍ على الأكل والشراب، وربما ولم لا؟ غير قادرٍ حتى على ملامسة جسده، ففي حال غفلته سيتحول هو أيضاً إلى تمثال ذهبي، كما تحولت ابنته التي جاءت لتحتضنه فانقلبت ذهباً. شغلتني هذه الأسطورة لأني فكرت في أنني أحول كل ما يقع تحت إدراكي إلى رمز، وأخشى ما أخشاه أن تصير حياتي كلها رمزاً لشيء لا أعرفه، الرمز كما أظن سكونٌ مُطلق، لحظة غير قابلة للامتداد، عمليات اختزال وحذف ونسيانٍ تترافق مع ضم وجمع وحضور لمعانٍ عديدة وعواطف ومُدرَكات. هذا هو الرمز عندي وأشياء أخَر لا أذكرها الآن. وأنا منذ دهر أطلب الحركة والتنقل من حالٍ إلى حال، أطلب امتداد اللحظة وانتشارها.
الروائي أو الشاعر عندما يمتلك هذه القدرة يكون قد بلغ مدى بعيداً في صِنعته، أما أنا فلستُ أيهما، لكن يفتنني الكُتّاب الذين امتلكوا هذه الصفة، ومنهم الطيب صالح، الذي كان منذ نصوصه الأولى صانعَ رموزٍ لا تفنى، وفي ذات الوقت ليست شخصياته حبيسة رمزيتها، إنها تفيضُ حياةً، وهذا شأو بعيد في الكِتابة الأدبية. يمكننا أن نقول كما قال جورج طرابيشي إن مصطفى سعيد رمز لجيل أو لتصور عن علاقة الشرق بالغرب[i]، ويمكننا مثله أن نجد براهين على ذلك داخل النص وخارجه، لكن مصطفى قادر على الإفلات من هذا الرمز، قادر على أن يقول جملاً أو يتصرف تصرفاتٍ مخالفة ومناقضة أحيانا للرمز المركوز فيه. وهذا ما يعجبني في شخوص وأعمال الطيب صالح: تضافر الواقع والرمز والخيال دون أن يلغي أحدها الآخر.

قدرة الطيب صالح على الترميز اتضحت لي عند مقارنتي بين قصة قصيرة له وأخرى لنجيب محفوظ، تُقاربان المفهوم ذاته: ممانعة الحداثة أو التحديث عند أهل قرية أو حارة في أزمنة القرن الماضي. القصتان هما (دومة ود حامد) و(حديقة الورد)، وفي القصتين يقدس السكان مكاناً أو موضعاً ينتمي للماضي: مقبرة أو ضريحاً، سأروي باختصار حبكة قصة محفوظ لأنها أكثر بساطة: يقترح أحد السكان وهو رجل متعلم ومكروه من قبل الآخرين بسبب هذه الصفة، أن يتم تحويل مقبرة الحي لحديقة للورد – وهذه الصورة الخيالية: تحول مقبرة لحديقة هي أجمل ما في القصة – يعترض السكان على هذا الاقتراح، ويوبخون صاحبه، لكن بعد مدة بسيطة تقرر الحكومة أن تنقل المقبرة إلى مكانٍ آخر لتحل محلها حديقة، لا سبيل لأهل حارة سوى التسليم والقبول، وهم يعرفون جيداً أن الأمر حدث اعتباطاً، وأنه من المستحيل أن يكون صاحب المقترح قد أوعز للحكومة بذلك، لكن صدورهم تمتلئ ضغناً عليه، ويقوم أحدهم بقتله، وتفشل التحقيقات في الوصول إلى الجاني مع معرفة الكل به حتى المفتش، لأنهم جميعاً متواطئون ويشعرون بالغضب لإهانة موتاهم وما ظنوه تدنيساً للمُقدّس، وهذه القصة نفسها تُروى من شيخ القرية لأحد سكانها داخل حديقة الورد – وهذا تلاعب لطيف بالزمن.
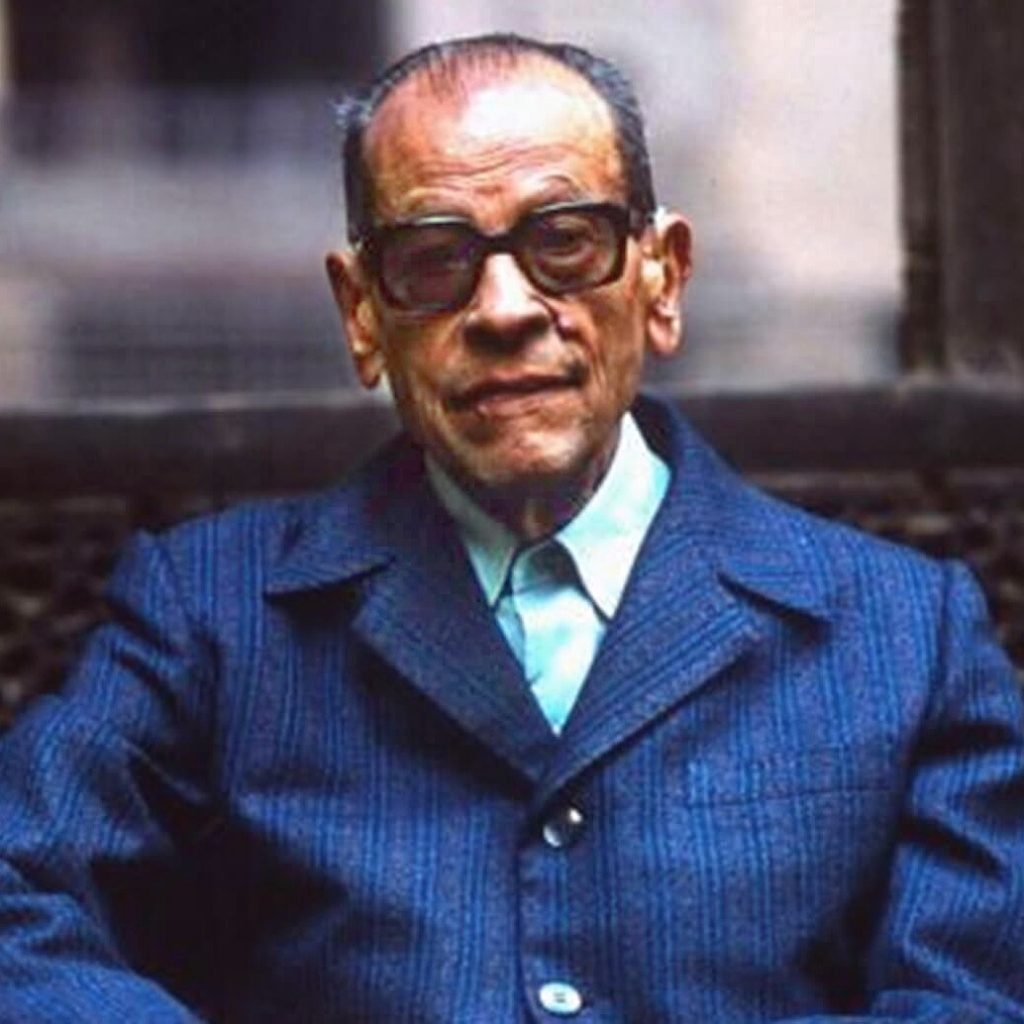
ماذا فعل الطيب صالح بالموضوع نفسه؟ أظنكم جميعاً قرأتم القصة من قبل، ولا أحب أن أعيد روايتها لأنها ليست مما يُروى، وهي تبتدئ بحيلة مُحبّبة للطيب، وهي التوجه بالحديث نحو شخص غائب – هو القارئ، هذا ما فعله في مطلع “الموسم”، وأيضاً في ضو البيت “بندرشاه” – هذه الحيلة التي تتضمن تلاعبا زمنيا أخاذاً يجعل القارئ يتوهم أنه يرافق السارد وتتكشف خلال تلك المرافقة الأشياء والأحداث، ويكون تمثل العالم قريبا للخيال، لأنه حاضر ويمكن الإشارة إليه باليد. لذا تكون جمل وصف العالم مقتضبة وتكثر الاستعارات، فالقارئ موجود مع السارد في نفس اللحظة، رغم أن السارد قد سبقه إلى هناك، إلى موضع القصة.
المهم، يبلغ السارد للغريب الزائر في سخرية الصعوبات التي سيواجهها في هذا المكان، لكنه يطلب منه أن يمضي معه إلى الموضع الوحيد الذي يستحق أن يُزار ويُرى في القرية: شجرة دوم ضخمة مشاطئة للنهر، ثم يروي له كيف أن الحكومة -وهي القائمة بأمر التغيير في كلتا القصتين – في عدة عهود، عهد الاستعمار والعهد الوطني – حاولت أن تقنع أهل القرية باجتثاث الشجرة لتحل مكانها ماكينة ماء أو محطة لباخرة، لكن الطلب قوبل بالرفض والاستنكار عدة مرات، وحين يسأل الزائر في ختام القصة السارد: “ومتى ستقيمون طلمبة الماء والمشروع الزراعي ومحطة الباخرة؟”، يجيبه :”حين ينام الناس فلا يرون الدومة في أحلامهم”، ليُضيف الغريب: “ومتى يكون هذا؟”، فيخبره بأن هذا سيحدث بعد جيلين من المتعلمين غرباء الروح، ليسأل الغريب مرة أخرى: “وهل تظن أن الدومة ستُقطع يوماً؟”، ليجيبه السارد إجابة عجيبة وتوفيقية، تمثل نظرة الطيب صالح للعلاقة بين الماضي والحاضر، وهي إجابة قريبة لتأملات راوي الموسم بعد لقاء مصطفى سعيد وتصوره بأن حدث الاستعمار هو حدث يمكن تجاوزه، هكذا بسهولة دون أن يُجهِدَ المستعمَر نفسَه في محاورة وجدال المستعمِر وآثاره الثقافية والحضارية، ليكون رؤية للوجود وطريقة في الحياة تخصه هو غير تابعة لسردية المستعمِر – علاقة الماضي بالحاضر والمستقبل بحثها الطيب بصورة أعمق في (ضو البيت بندر شاه)، ولم تكن الإجابة هناك هي نفس الإجابة. المهم، يقول السارد: “لن تكون ثمة ضرورة لقطع الدومة، ليس ثمة داعٍ لإزالة الضريح. الأمر الذي فات على هؤلاء الناس جميعاً أن المكان يتسع لكل هذه الأشياء، يتسع للدومة والضريح وماكينة الماء ومحطة الباخرة”.
حَوَّلَ الطيب صالح هذه الشجرةَ إلى رمز عن قصد – سيشير بعد سنواتٍ عديدة بشيء من الاعتزاز عندما يتحدث عن باريس وبرج إيفل، إلى أنه فعل كما فعل رولان بارت في حديثه عن البرج، حينما حوله لرمز يجتاح أحلام وتجارب وتواريخ سكان المدينة، ببساطة إلى أسطورة حديثة[i] – أما كيف فعل ذلك، فعبر الحلم – جميع أهل القرية يحلمون بالشجرة وبالولي الصالح المدفون قربها وفي أحلامهم تجيء كبشارة وكنذير لأمر سيحدث في المستقبل للحالم – والمبالغة في صفات المْدرَك الذي هو في هذه الحال الشجرة -إن ظلها يمتد ليشمل الشاطئين وليبلغ حتى القبور الكائنة في مسافة بعيدة جدا عنها-، وفي جعلها قائمة مع نشوء القرية، وأن الذاكرة مهما أوغلت في الماضي، لن تستطيع أن تتذكر هذه القرية دون وجود دومة ود حامد. وفي الرواية قصة مجهولة الأسانيد عن سبب نموها وقيامها في هذا المكان الذي لا يصلح للزراعة، قصة ترتبط بالمُقدّس وتُعزّزه.
كل هذا ينسجه الطيب صالح بإتقان فائق، لكن تبقى معضلة الإجابة الأخيرة التي قالها السارد بشيء من الحزن والتعب، كأنه عارف باستحالتها: هل المكان يتسع لجميع الأشياء؟ هل يمكن أن يتجاور الماضي والحاضر في سلام؟ إن لفي شك في هذا مريب.
[1](شرق وغرب، ذكورة وأنوثة: أزمة الجنس في الرواية العربية)، جورج طرابيشي، في مقال مطول يقرأ الرواية وفقا لسياقها التاريخي مستعينا بمدارس التحليل النفسي، واصفا إياها بأنها (قلعة من الرموز).
[1]يقول في مقالته عن باريس في كتاب (للمدن تفرد وحديث: الغرب)، بعد أن يورد مقاطع من وصف رولان بارت لبرج إيفل بترجمته، ومقاطع من قصته (دومة ود حامد) في وصف شجرة دوم في قرية بشمال السودان: “إنما أحسن من هذا وذاك، ما صنعه أبو عبادة البحتري منذ أكثر من ألف عام. لا يغرنك تذاكي (الحبر) الفرنسي، وتلاعبه بالكلمات والأفكار كمثل قوله (البرج جماد يَرى -بفتح الياء- ونظرة تُرى -بضم الياء- إنه فعل تام، لازم ومتعد). تحت هذا اللعب الذكي فكرة بسيطة، هي أن برج إيفل (رمز). كذلك فعل البحتري في قصيدته السينية العصيمة عن (الإيوان). الرمز عند العلامة الفرنسي (فارغ) يملأه الرائي بالصور والأحاسيس والمعاني، كيف يشاء. وهذه فكرة أساس في مذهب الأستاذ (بارت). أما البحتري فقد صنع رمزا داخله مجموعة رموز، مثل كهف مسحور مليء بالمفاجئات. لغز وراءه لغز. المتلقي لا يملأ بتخيلاته فراغا كاملا، ولكنه يملأ فراغات بين دروب المعاني التي اختطها الشاعر سلفا وعن عمد”.
منذ زمن طويل لم أقرأ مقال أدبي بهذا الجمال