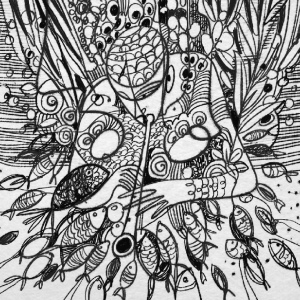الجزء الثاني من عرض كتاب بازل دافدسن. تعريب جمال محمد أحمد
تحت عنوان صغير هو” الكاتب والكتاب”، تحدث جمال محمد أحمد عن جدة آراء بازل دافدسُن، وردود الفعل التي صاحبت ظهور هذا الكتاب بين المؤرخين (الأوربيين طبعا)، مشيرا إلى مختصين متحمّسين للكتاب وصفوه بأنهفتح في تاريخ إفريقيا، إذ يتضمن الكتاب ألوانا من معارف العلماءالإنثربولجيين، والآثاريين، والمؤرخين، ويقدم نقدا معِينا على فهم ماضي القارة، وأنه جاء في وقت تجتاز فيه إفريقيا مرحلة مهمة في حياتها المعاصرة، وأن خلاصات هذه الدراسة مقنعة ومثيرة، تثبت أن أفريقيا لم تكن بمعزل عن موكب تقدم الإنسانية.
ويرى جمال أن لهذا الكتاب حسنات كثيرة، أهمها عند القارئ العربي، هو إبراز دور العرب في تاريخإفريقيا. ففي تقديمه للتعريب(2)، مضى جمال ينقّب ويطلب الجذورَ القديمة لهذه العلاقة، متوقفا عند تاريخ العرب في شرق إفريقيا، الذين أقاموا التجارة هناك، وبسطوا نفوذهم في القرن العاشر من منطقة القرن الإفريقي جنوب الجزيرة العربية حتى سفالا، ذاكرا أن الرحالة العرب كانوا منتشرين على ساحل إفريقيا الشرقي. وفي وسط إفريقيا،كان للعرب “إيرادُ الأمور وإصدارها“، وأقاموا الممالك، وزرعوا المحاصيل، ورغم تلوث سمعتهم بتجارة الرقيق التي لا تجارة غيرها آنذاك، إلا أنّ دارسي تلك العلاقة بين العربي والإفريقي يــشهــدون بأنها لم تكن فظيعة(!؟) مثل تلك التي ستشهدها القارة مع مجيء الأوربيين، حتىقال أحدهم إنه “يصعب التمييز بين الأرقاء وأسيادهم”، كل ذلك كان قبل تدفُق القناصل الأوربيين، والصدام الذي كان. وفي الغرب الإفريقي، نشأت علاقة مشهودة وقديمة بين القوميْـن، وتدفقت القوافلُ من فاس ومراكش والقيروان، تحمل الملح لغانا وجاوا وتمبكتو، وتعود بالذهب، والعاج وبضائع أخرى، واتخذ الأفارقة الإسلام دينا، وتحدثوا بالعربية المرموقة آنذاك، وخلّف بينهم العرب آثارا خالدة في الروح والثقافة. توقفَ جمال عند مكانة السودان في إفريقيا، ووصفه بأنه بطلٌ من أبطال الحضارة الإفريقية القديمة، وهذا ما فعله دافدسُن أيضا، إذ كانت مروي عند كلا الباحثين، همزة الوصل بين إفريقيا السوداءوالبحر المتوسط، وذات أثر مشهود في حياة بقية حضارات القارة. وتكمن أهميةُمقدمة جماللكتاب دافدسُن في تلك القطعة العظيمة النادرة التي قام بتعريبها وإثباتها في ذيل تقديمه، وهي عبارة عن محفورة عثر عليها الباحث أنولتمان في شمال أثيوبيا،منسوبة إلى عيزانا أول ملوك العهد المسيحي الأثيوبي، أيام الضعف في مروي (منتصف القرن الرابع الميلادي)، وهي افتخار يذكره عيزانا، يصف فيه حروبه مع مروي وانتصاره الأخير عليها. هذه القطعة التي عربهاجمال، تعطي فائدة ضخمة للباحثين في تاريخ مروي، والمنطقة كلها، وقد أخذت ست صفحات من الكتاب، وهي تستحق ذلك، وزودها جمال بإشارات وتوضيحات ثمينة.
تقول الصفحات الأولى من هذا الكتاب، إن هذا كتابٌ عن إفريقيا جنوب الصحراء، يتناول فيه المؤلف حياتها في الخمسة عشر قرنا التي سبقت الاستعمار الأوربي، ويعرض الكتابُ المدنيةَ الإفريقية، ويتتبعها، وما استطاعت تحقيقه عصْرئذ، واقفا على أرض ثابتةٍ من الحقائق التي أتاحها المؤرخون العرب القدامى والأوربيون المعاصرون، وكذلك ما أنجزه المنقبون والباحثونالأنثربولوجيون، خاصة في الفترة الحافلة بين 1940-1959م. يتكون الكتاب من مقدمة وأثني عشر فصلا، مزودا بخرائط توضيحية، وصور كثيرة تعرض الآثار التي يشير إليها الكاتب في ثنايا عرضه، وقائمة تضم عشرات المراجع والوثائق التي استند إليها دافدسُن، مما جعل النسخة العربية منه كتابا من الحجم الكبير (480 صفحة)، غير أن الأسلوب الأدبي الذي امتاز به دافدسُن ومعربُه يجعل قراءته عملا في غاية المتعة والفائدة للقارئ المتخصص وغير المتخصص، كما أن صفحاته تذخر بهوامش وملاحظات من صنع الكاتب حينا ومن صنع المعرّب حينا آخر. في مقدمته للكتاب، يشير دافدسُن إلى جهود مجموعة من الجغرافيين، والمؤرخين وعلماء الآثار، في التعريف بخفايا إفريقيا، وإضاءة كثير من جوانب حياتها، بعد أن سيطرت الخرافات والأساطير وأنصافُ الحقائق على تاريخ القارة القديم، مما ساهم في تكوين صورة جديدة عنها، ترسم كما يذهب دافدسُن “إنسانا بعظمته كلها وحقارته“، عاش مثله مثل الإنسان في كل مكانٍ، قويا حينا وضعيفا وقتا آخر. ولقد انتشر بين الناس أن هذا الإنسان الإفريقي “لا يعرف شيئا يقربه من الحضارة التي يعيشها الرجل الأبيض“، ظل مكتفيا فقط بالنظر “إلى موكب التاريخ يمر أمامه عبر قرون لا حصر لها“. هذه الصورة الأخيرة– كما يعلق دافدسُن– لم تكن بريئةً تماما، فقد دعمت الحق في غزو أرض هذا الإفريقي الذي ما يزال طفلا، وبرر بها روادُ الاستعمار ما فعلوه هناك في (قلب الظلام)، بعيدا عن مدن أوربا المغترة بالثورة الصناعية حينذاك.
يذكر دافدسُن عارضا منهجَه في عمل الكتاب، صفتين استحوذتا على البحوث الغربية في التاريخ الإفريقي، ويذكر أنه اجتهد ليكون معتدلا بينهما، وهما: الرومانسية التي لا ترى في ماضي إفريقيا “إلا كل زاهٍ منير“، والتي تنسُب مدنيات عالية (High Civilizations) إلى إفريقيا، فيما يرى هو أن حال إفريقيا القديم قد ساهم حقا في ما يسمى اليوم بالمدنية العالية مثلها مثل إسهاماتِ أماكن أخرى، وأن إفريقيا ليست بحاجة إلى “إطار الذهب الذي صنعه الرومانسيون” حولها، والصفة الأخرى كانت تلك المغرِضة المتحيزة التي تسرف في الميل عن الحقائق، فلا ترى في إفريقيا إلا الظلام الدامس. ويقصد دافدسُن بالاعتدال هنا، هو الاعتراف بأن قصة الحضارة الإفريقية “لا تختلف في جوهرها عن أية أسرة كبيرة من الأسر الإنسانية”، فيها النجاح والفشل، والتقدم والركود، وهي قصة “تبين لنا الرباط الجوهري والوحدة بين شعوب إفريقيا وشعوب بقية العالم“.
جاء الفصل الأول بعنوان: “شعوب إفريقيا القديمة”، وقد خصصه دافدسُن لدراسة “المسرح الذي دارت عليه حوادثالتاريخ الإفريقي آنذاك“، متتبعا الإشارات التي تقود إلى الإنسان الإفريقي الأول، وتلك التي تراقب تطور مجتمعه قبل العصر الحجري وبقاياه في وقتنا هذا. توقف دافدسُن عند النماذج البشرية القديمة التي وجدت في القارة، أهمها النموذج الزنجي أو شبه الزنجي الذي عُثر على آثاره قريبا من الخرطوم، حوالي عام 5000 قبل الميلاد. وقدمت دراساتٌ أخرى كشفا لآثار إفريقية قديمة تعرض “صورا لرجال ونساء وحيوانات، وعربات ورماح ودروع خلقتها أصابع فنانة حساسة“، وأعمالا فنية لآلهة وآدميين. يستمر الفصل في تتبع هجرة الإفريقيين الأوائل وتكاثرهم، وسبل عيشهم، وأيّ قوم هم، متوقفا عند الرأي القائل بوفود شعوب من خارج إفريقيا لتعميرها وتمدينها في الزمن القديم، ولا ينتصر دافدسُن لهذا “الرأي الساذج“، ويقول وأنقل بتصرف: “إن الإفريقيين وإن استعاروا كثيرا من غيرهم، فنا أو عقيدة، أخضعوا ما أخذوا لظروفهم ومحيطهم، وأخرجوا منه ثقافات وحضارات تميزت بأفريقيتها تميزا لا يُنكر“، ويقيم على ذلك الدلائل، ويذكر كثيرا من مظاهر النمو الحضاري والصناعي في أماكن كثيرة على أرض إفريقيا ويلفت دافدسُن النظر إلى أن هذا النمو كان غير متكافئ، فبعض الشعوب الإفريقية تأخرت لأسباب مختلفة. في حديثه عن الصحراء الإفريقية، ذكر أهميتها في سجل تاريخ إفريقيا الطويل، فعلى شمالها “التقت حضارات الهلال الخصيب“، وأن مجتمعاتها “ارتقت من بدائية غليظة إلى مفاخر عصر البرنز وبهائه“. يتواصل البحث في هذا الفصل عن الهجرات العديدة التي سبقت الاستقرار في القارة، وعن نمو مجتمعات تلك الشعوب القديمة، فقد كانت شعوبا نشِطة، زرعت الأرض وبحثت عن المعادن، و”بنَت نظما اجتماعية جديدة معقدة“، واخترعوا ما احتاجوا إليه من أدوات وفنون، فورث منها الزنجي المعاصر أديانه وفلسفاته، ذات الطابع الإفريقي الفريد.
في الفصل الثاني؛ خفايا مروي، توقف دافدسُن أولا عند المدنية المصرية القديمة، وعوامل ظهورها، ومحاولاتها غزو الشعوب غربا وجنوبا. واسترسل في الحديث عن أيام فراعنة الأسرة السادسة (2423- 2242) ق.م، وتوسعاتهم الجنوبية، وسياساتهم هناك. وهدف دافدسُن من هذه النقطة، – إضافة إلى التنويه بأن الطرق التي يصعب اليومَ تخيل وجودها، كانت معروفة للأفارقة القدماء، إذ عرفوا كيف يجتازون الصحراء والأدغال، – هو أن يعيد تـمَـوْضُـع الحضارة المصرية القديمة في سياق التاريخ الإفريقي، على غير عادة دارسي الحضارة المصرية، ويذهب دافدسُن إلى أنها كانت شديدة الصلة بجاراتها في الجنوب والغرب، سلما وحربا، حتى أن ليس مستبعدا امتدادها في فترة ما إلى مستنقعات أعالي النيل، وتلال دارفور. مستنطقا الآثار واللوحات الكثيرة في المنطقة بين الخرطوم ووسط مصر، يواصل دافدسُن سرد قصة صلة مصر بإفريقيا، متوقفا عند حوادث اجتماعية وسياسية واقتصادية ذات أثر عظيم في تلك العلاقة، قائلا بعبارة واضحة: “أخذت حضارة مصر من إفريقيا (يقصد بقية حضارات إفريقيا) كما أخذت عن آسيا“، وأن هذه الحضارة الوليدة هاجرت تنشر فنونها على شعوب العالم، فنُقلت أسسها الحضارية في عصر البرونز إلى جنوب أوربا وأصقاع بعيدة من العالم. يذخر هذا الفصل بمعلومات عن ثلاثة مراكز كبرى أخرى غير مصر، “ازدهرت لتحمل الثقافة والحضارة لداخل إفريقيا“؛ هي كوش والدول الليبية المغربية وحضارات اليمن في جنوب الجزيرة العربية. وقد تبادلت هذه المراكز الكبرى التأثير على بقية القارة، وكذلك بعضها في بعض، و” ترتب على هذا أن تغير وجه القارة الإفريقية“، وهذا التأثر والتأثير المتواصل جعل فصْلَ هذه العناصر التي التقت وكونت الحضارة الإفريقية أمرا غير ممكن.
“لمروي على الإنسانية أن ترعاها، وأن تكشف ما في بطونها من ذخائر، إنها أعظم ما خلف العالم القديم“، هكذا يبتدأ دافدسُن حديثه عن مروي، إذْ كانت بابَه الأول لتتبع حضارة إفريقيا. أطال الوقوف على أهرامها الملوكية، و”معبد الشمس الذي خرج هيروديتس يسأل عنه فيما كان يسأل“، وهناك حيث سترى ” أعمدة عريضة من الحجر الأسود القوي، قائمة على قواعد عالية فوق سطح الأرض، نُقشت عليها كتابة بحروف (تقرأ ولا تفهم)، يبحث العلماء اليوم عن سر هذه اللغة“. تحدث المؤلف عن صناعات المرويين، ومعمار القصور، وطرق الزراعة، والأسرة المالكة، والدين. وتوقف مليا عند المصوّرات الصفراء، التي وصف قصورها ومساكنها بأنها “كانت نقطة الالتقاء بين سفراء شرق البحر الأبيض المتوسط وتجار إفريقيا ومبعوثيها من جنوب مروي وغربها“، ووصف ملوك مروي بالمثقفين وأهل الذوق. كانت الحياة في مروي في العصر البرونزي ذاك حياة مليئة بالتقاليد والأعراف، وذات طراز خاص في الفنون والصنائع. بعد ذلك انتقل دافدسُن إلى الحديث عن كوش، التي لا يخفي إعجابه بحضارتها خلال عباراته، فهي عنده “غرْبَلة إفريقية للآراء والأساليب والمعتقدات التي كانت تسود العالم المتحضر”، وكانت كوش “غازية معتدية، …، أقلقت الرومان في مصر“. يرى دافدسُن أن تاريخ كوش يجذب اهتمام كثيرين، ليسوا بالضرورة سودانيين فقط، ذلك لدورها الكبير في تاريخ القارة، ولتراثها المحترم الذي ذهب إلى غرب القارة ووسطها، وأن التوسع في استكشافها هو المفتاح نحو تاريخ إفريقيا القديم، وأن دورها في المنطقة كان مثل دور أثينا مع اختلاف الزمان والمكان، كانت مؤثّرةً في جيرانها، وحيةً في ثقافة الشعوب حولها، فــ” تاريخ إفريقيا كلها مرتبط ارتباطا لا انفصام له بتاريخ كوش” كما أوجز دافدسُن القول.
هوامش الجزء الثاني
1- نسبة لكثرة العبارات التي اقتبسناها من الكتاب، ابتداء من هنا وخلال ما سيرد من عرض،فكل عبارة وُضعت بين تنصيصين ” ” هي مأخوذة مباشرة من الكتاب، ما لم نذكر خلاف ذلك، وليعذرنا القارئ على عدم تمكينه من الرجوع إلى أماكنها الدقيقة في الكتاب.
2- يمكن الاطّلاع أيضا على مقدمة جمال لكتاب دافدسُن في: عـلـي الـمـك، مختارات من الأدب السوداني (كتاب الدوحة، قطر، فبراير 2015) (توجد نسخة إلكترونية منه)، ص 78 – 103.