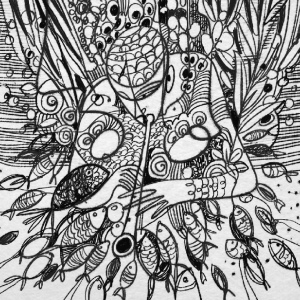نذرَعُ كلَّ يومٍ شارع “بورتوبيلو” بغربِ لندن من أوَّلِه إلى آخرِه، مُسرِعينَ في طريقِنا إلى العملِ ومُسرِعينَ بعضَ الشَّيء عند العودةِ إلى المنزل، ولا نحفلُ بما امتلأ به سوقُه الشَّهيرُ من تُحَفٍ ومصنوعاتٍ يدويَّة نادرة، غيرَ أنَّ هناك ثلاثةَ مشاهدَ تسترعي انتباهَنا وتُجبِرُنا على التَّأمُّلِ بشأنِها مهما كان الذِّهنُ شارداً بالهمومِ اليوميَّة؛ أوَّلُها تدفُّق السُّيَّاح المطَّرد على الشَّارع، وإصرارهم البريء على أخذِ صورٍ تذكاريَّة لهم بالقرب من المكتبة الَّتى تمَّ فيها تصويرُ مشاهدَ رومانسيَّةٍ من فيلم “نوتنغهيل”، تمثيل جوليا روبرتس وهيو غرانت؛ وثانيُها، بضعُ كاميراتٍ تلتقطُ صوراً أمام المنزلِ الَّذي كان يسكنُ فيه جورج أورويل، صاحبُ رواية “١٩٨٤” الَّتي تنبَّأت بانبثاق مجتمع المراقبة اللَّصيقة الَّتي تُحصِي أنفاسَ النَّاسِ بتسجيلِها لكلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ من تفاصيلِ حَيَواتِهم المعتادة، بغرضِ فرضِ السَّيطرةِ على المواطنِ العاديِّ وإخضاعِ حياتِه للهيمنةِ الشَّاملة للدَّولة؛ أمَّا ثالثُها -وهو أقلُّ ما يسترعي انتباهَ السُّيَّاح، وربَّما لبُعدِه قليلاً من بداية السُّوق، منظوراً إليها من منزلِنا الواقعِ شمالَه، لكنَّه الأكثرُ أهمِّيَّةً بالنِّسبةِ لموضوعِ هذا المقال- فهو شارعٌ جانبيٌّ تسمَّى باسم العالِمِ البريطانيِّ مايكل فاراداي.
كان فاراداي في بداية سيرتِه العلميَّة يقضي حياةً عاديَّة يشتغلُ فيها بتجليدِ الكتب، ويتشاغلُ عنها في وقتِ فراغِه بأسلاكٍ وبَكْراتٍ وقطبانَ صغيرةٍ من المغنطيس؛ لكنَّه فاجأ ذاتَ يومٍ مجتمعَ العلماءِ في الجمعيَّة الملكيَّة بأخطرِ الاكتشافاتِ العلميَّة على الإطلاق، حيث تمكَّن من إبهارِ الحاضرينَ برؤيةِ جسمٍ يتفاعلُ كهربائيَّاً بتحريكِ قطبٍ مغناطيسيٍّ من غيرِ أن يكونَ بينهما رابطٌ لتوصيلِ الأثر. لم يقف فاراداي عند خطوطِ القوَّةِ المحلِّيَّة الَّتي تكشَّفت عنها تلك التَّجربةُ المذهلة، بلِ افترضَ وجودَ شبكةٍ شاسعةٍ من خطوطِ قوًى تنتظمُ الكونَ بأسرِه؛ وهو ما بات يُعرَفُ لاحقاً بالموجاتِ الكهرومغنطيسيَّة؛ وهي مجالٌ واسع يحتوي في داخلِه أوَّلاً على ما قد يبدو أنَّه لا يحتاجُ إلى اكتشافٍ أصلاً، بل يجعلُ الاكتشافاتِ كلَّها ممكِنةً في الأساس، وهو الضَّوءُ المرئي؛ هذا إضافةً إلى أطيافٍ من أشكالِ الطَّاقةِ غيرِ المرئيَّة المنتشرةِ في الكون، ومن ضمنِها: موجاتُ الرَّاديو، الَّتي تُستخدَمُ في الاتِّصالاتِ وأجهزةِ البثِّ الإذاعيِّ والتِّلفزيوني. في البدء، انحصر استخدامُ موجاتِ الرَّاديو في أجهزةِ اتِّصالاتِ الدَّولة، العسكريَّةِ منها والأمنيَّة، بتفعيلِ خاصِّيَّتَيْ الإرسالِ والاستقبالِ معاً. وعلى إثرِ ذلك، قامتِ الدَّولة بتوظيفِ الإرسالِ ذي الاتِّجاهِ الواحد في البثِّ الإذاعي، ولاحقاً في البثِّ التِّلفزيوني. وفي وقتِنا الرَّاهن، نشهدُ انفلاتَ أجهزةِ الاتِّصالاتِ من قبضةِ الدَّولة، باستعمالِ الجوَّالاتِ الحديثة الَّتي تُوظِّفُ نَسَقَيْ الإرسالِ والاستقبالِ على حدٍّ سواء. لكنَّنا في هذا المقال، سنكتفي بتأمُّلِ العصرِ الَّذي كان فيه المِذياعُ هو الحاكمُ الأعلى الَّذي يقبَلُ المواطنُ طواعيةً ما يصِلُ عن طريقِه إليه، فيستأنِسُ بما يُلقيه عليه من إخبارٍ وإمتاعٍ وتثقيف؛ وإن لم يُعجِبْه ذلك، فهناك هامشٌ ضيِّقٌ لاستقبالِ رسائلِ المستمعينَ وشكاواهم، من غيرِ إلزامٍ مشدَّدٍ بالرَّدِّ عليها أو الإقرارِ باستلامِها.
لا يُوجدُ حدثٌ يؤكِّد بالفعلِ ثنائيَّةَ الحكمِ الاستعماريِّ (بريطانيا/مصر) وطبيعتَه المزدوجة (مركز/هامش) مثل إنشاءِ الإذاعةِ السُّودانيَّة في عام ١٩٤٠؛ ففي ذلك العام إبَّانَ الحربِ العالميَّة الثَّانية، تحركَّتِ الدَّولةُ الاستعماريَّة في المركزِ لدعمِ المجهودِ الحربيِّ للحلفاء عن طريقِ تعزيزِ الدِّعايةِ المضادَّة لدولِ المحورِ في المنطقةِ العربيَّة، إذ إنَّ إذاعةَ صوتِ ألمانيا (“دويتشه فيله”) ظلَّت تقومُ بالبثِّ العربيِّ الموجَّهِ منذ بدايةِ الحربِ في عام ١٩٣٨. لم تترك وزارةُ المستعمراتِ الأمرَ لوزارةِ الخارجيَّة أو تتمسَّكْ في ذلك الزَّمنِ العصيبِ بالحُجَّةِ القانونيَّة الَّتي لا تعترفُ بوضعيَّةِ السُّودان كمستعمَرةٍ بريطانيَّة، فقامت بتوفيرِ الدَّعمِ الماليِّ لحكومة السُّودان في الخرطوم، الَّتي قامت بدورِها بتخصيصِ غرفةٍ بمبنى البوستة بأمدرمانَ لأجهزةِ الإرسالِ والبثِّ الإذاعيِّ المباشر للحاضرينَ بالسَّاحةِ أمام المبنى عبر مكبِّراتِ الصَّوت. وعندما وضعتِ الحربُ أوزارها، توقَّفَ على الفورِ ذلك الدَّعمُ الماليُّ المقدَّمُ من المركز؛ فوجدت حكومةُ الخرطومِ نفسَها أمام مشكلتين، إن هي أرادتِ استمرارَ الإرسالِ الإذاعي: توفيرُ الدَّعمِ الماليِّ اللَّازم واختيارُ الكادرِ الملائمِ لتقديمِ البرامجِ الإذاعيَّة. بخصوصِ توفيرِ الدَّعم، لجأت حكومة الخرطوم إلى تقليلِ التَّكلفةِ عن طريقِ إيجارِ مبنًى سَكَنِيٍّ جنوبَ حَوْشِ الخليفةِ بأمدرمان؛ وكان من الممكنِ الاستعانةُ بالشَّريكِ الأضعف لحلِّ المشكلةِ الثَّانية، خصوصاً وأنَّ الموظَّفينَ المصريِّينَ ظلُّوا يقومونَ منذُ بدءِ الاحتلالِ بدورٍ أساسيٍّ في إدارةِ الأجهزةِ الأيديولوجيَّة الَّتي تُساعدُ في تسهيلِ بسطِ الحكمِ الاستعماريِّ على البلاد؛ إلَّا أنَّ الشَّريكَ الأقوى أخذَ ينتبهُ مع مرورِ الوقتِ إلى الدَّورِ الَّذي ما انفكَّ يلعبُه الشَّريكُ الأضعفُ في خدمةِ المرامي الأيديولوجيَّةِ الخاصَّةِ به وحدِه، حتَّى جاء عهدُ السِّكرتيرِ الإداريِّ دوغلاس نيوبولد، فتحوَّلت تلك الشَّراكةُ في عهدِه إلى عَداءٍ سافِر.
لم يكن نيوبولد يثقُ أيضاً في ولاءِ الموظَّفينَ السُّودانيِّينَ أو يطمئنُّ إلى إمكانيَّة إقناعِهم بتكريسِ مواهبهم لخدمة المصالح الاستعماريَّة، لكن لم يكن أمامه بديلٌ آخرُ غيرُ استخدامِهم، على أن يُحْكِمَ فرضَ الرَّقابةِ على أدائهم بواسطة مكتبِ الاتِّصالِ الذَّي يقعُ تحت مسؤوليَّتِه المباشرة باعتبارِه سكرتيراً إداريَّاً. وفي البدء، تمَّ تعيينُ المعلِّم عبيد عبد النُّور في وظيفة مذيع، بينما تمَّ تسييرُ الجانبِ الفنِّيِّ من قبل مختصِّين تابعينَ لمصلحةِ البريد والبرق. ولم يكن هناك من السُّودانيِّين مَن يشكُّ في نزاهةِ عبيد، فقد كان شاعراً وطنيَّاً يحثُّ “الكبارَ” على التَّخلِّي عن سُكاتِهم في مناهضةِ المستعمر، بينما كان يحثُّ النِّساءَ على الاضطِّلاعِ بدورِ القيادةِ للعمل الوطني؛ أمَّا فنِّيُّو مصلحة البريد، فقد شُهِدَ لهم منذُ حركة “٢٤” بدعمِ الحركةِ الوطنيَّة وتوصيلِ أخبارِها بسرعةِ البرقِ إلى أصقاعِ البلاد. وإذا صحَّ بالفعلِ أنَّ مبنى الإذاعة المُستأجَرِ كان هو منزل عبيد عبد النُّور الَّذي أصبح فيما بعدُ مقرَّاً لمدرسة بيت الأمانة الثَّانويَّة قبل أن تنتقلَ مبانيها الجديدة إلى العبَّاسيَّة، فإنَّ بإمكانِنا أن نتخيَّلَ بشكلٍ سرياليٍّ بحتٍ حدوثَ انقلابٍ عسكريٍّ مُبكِّرٍ تتوجَّهُ فيه دبَّابةٌ واحدةٌ لاحتلالِ منزلِه، توطئةً لإذاعةِ البيان رقم “١” وإجبارِه تحت الضَّغطِ والإكراهِ على تشغيلِ المارشاتِ العسكريَّة والإسراع في إلقاءِ البيانِ الأوَّلِ على المستمعين. بالطَّبع، لم يكن للإذاعةِ في ذلك الوقتِ تأثيرٌ يُذكَر يستدعي استخدامُها مِعبراً استهلاليَّاً لأيِّ حكمٍ عسكري، كما لم يكنِ الانقلابُ وارداً حتَّى في خيالِ أكثرِ العسكريِّينَ طموحاً، لوجودِ القبضةِ الفولاذيَّةِ المُحكَمة للدَّولةِ الاستعماريَّة. ولكن عندما توجَّهت بالفعل أوَّلُ دبَّابةٍ نحو احتلالِ الإذاعةِ في موقِعِها الحالي بعد ١٨ عاماً من إنشاءِ الإذاعةِ الأولى بمبنى البوستة ومُضيِّ عامينِ فقط على الحكمِ الوطنيِّ في أعقابِ نَيْلِ الاستقلال، فإنَّ الإذاعةَ الوطنيَّة بأمدرمانَ قد أصبح لها بالفعلِ في ذلك الوقتِ شأنٌ عظيمٌ وتأثيرٌ جماهيريٌّ يُغري الطَّامحينَ من صِغارِ الضُّبَّاطِ بتأمينِها أوَّلاً قبل المُضيِّ قُدُماً في استتبابِ بقيَّةِ دعائمِ الحكمِ الاستبدادي الوليد.
بعد تجاهل الاستعانة بموظَّفيها في تقديم برامج الإذاعة النَّاشئة، لم تقفِ الحكومةُ المصريَّة مكتوفةَ الأيدي لفترةٍ طويلة، بل قامت في عام ١٩٤٩ بتأسيس إذاعة ركن السُّودان من القاهرة الَّتي ظلَّت تواصلُ البثَّ حتَّى عام ١٩٨٤، حين تمَّ تغييرُ اسمِها إلى إذاعة وادي النِّيل. هذا إضافةً إلى إنشاء وكالة أنباء الشَّرق الأوسط في عام ١٩٥٥، فأخذت تُنافسُ الوكالاتِ الأخرى في تغذية الإذاعاتِ العربيَّة، ومن ضمنها السُّودانيَّة، بالأخبارِ الطَّازَجة والتَّحليلاتِ الخبريَّة. في البدء، لم تُفْلِح حكومة السُّودان إبَّان العهد الاستعماريِّ أو في مستهلِّ الحكمِ الوطنيِّ في إنشاءِ وكالةٍ للأنباءِ إلى أن جاء عام ١٩٧٠، حينما أنشأ الحكمُ الدِّيكتاتوريُّ الثَّاني في مستهلِّه وكالة السُّودان للأنباء “سونا”، في الذِّكرى الرَّابعةَ عشرةَ للاستقلال. وفي عام ١٩٧٣، تمَّ تعيينُ مصطفى أمين مديراً عامَّاً لها، فانتقلتِ الوكالةُ على يديه إلى مؤسَّسةٍ إخباريَّة حديثة، ومن ثمَّ أداةٍ أيديولوجيَّة يسيلُ لها لعابُ الدِّكتاتوريَّة الَّتي أخذت توَّاً في توطيدِ حكمِها الاستبدادي. كان مصطفى أمين صحفيَّاً بارعاً وإداريَّاً من الطِّرازِ الأوَّل، رغم مَيلِه إلى التَّعاونِ مع الطُّغمةِ العسكريَّةِ الحاكمة. فهو لم يقم فقط بتطويرِ الوكالةِ وتحديثِ أدواتِ عملها من ماكيناتِ الرُّونيو اليدويَّة إلى أجهزةِ “التِّيكرز” الآليَّة، بل قام في بادئ الأمرِ باختيارِ كادرٍ من الشَّباب المستنير للاضطلاع بأعباءِ العملِ الصَّحفي، حتَّى ولو لم يُكمِلوا بعدُ تعليمَهم الجامعي؛ وكان من بين هؤلاء النُّخبةِ الفريدة الماحي علي الماحي من كلِّيَّة التَّربيَّة (معهد المعلِّمين العالي سابقاً) وبشرى الفاضل وهاشم محمَّد صالح والزَّاكي عبد الحميد من كلِّيَّة الآداب بجامعة الخرطوم وأحمد عبد الله حقَّار من جامعة القاهرة. وفي مقرِّ الوكالةِ القديم بالرُّبُعِ الشَّماليِّ الغربيِّ من تقاطع شارع القصر مع شارع الجمهوريَّة، كان هناك قِسمٌ للاستماعِ الإذاعيِّ يستخدمُ أجهزة الرَّاديو السُّوفيتيَّةِ الشَّهيرة ماركة “سِلينا”؛ فعبرَ تلك الأجهزةِ ذاتِ الكفاءةِ العالية، كان يتمُّ التقاطُ الأخبارِ الطَّازَجة من مظانِّها، ليتمَّ إعادةُ صياغتِها لتتماشى مع سياسةِ الدَّولة ومراعاةِ مصالحِ الوطن.
وفي منزلٍ مُستأجَرٍ بأبي روفَ إلى الشَّمالِ من سوقِ الشَّجرة وبالقربِ من نادي “الزَّهرة” الرِّياضي، كان شاعرُ الوطنِ محمَّد الحسن سالم “حُمِّيد” يقومُ يوميَّاً بالتقاطِ الأخبارِ من جميعِ المحطَّات العربيَّة والدَّوليَّة عبر جهاز راديو سوفيتيٍّ ماركة “سِلينا”؛ وعندما يأتي موعد نشرة “الثَّامنة” المحلِّيَّة يضعُ الشَّاعرُ جهاز الرَّاديو العتيق على صدرِه بحنانِ أُمٍّ رؤومٍ ويبدأُ في طقسِ الإصغاءِ اليوميِّ إلى أخبارِ البلد، فتسقطُ على خدِّه دمعةٌ لرحيلِ قريبٍ بعيد وقد تصدرُ أحياناً من صدرِه زفرةٌ حرَّى لفقدِ صديقٍ قديم أو زميلِ دراسةٍ بكورتي أو مروي أو ضواحي أمبكول؛ ولا يخرجُ من أجواءِ هذا الحزنِ الدَّفين إلَّا بالاستماعِ إلى برنامج “الرُّبوع”، خصوصاً حينما يأتي نغمُ الطَّنبورِ إلى مسمعِه، حاملاً صوتَ صدِّيق أحمد أو محمَّد كرم الله أو محمَّد جبارة؛ ولكن سرعانَ ما يأتي صوتُ النِّعام عميقاً ومريراً بطعمِ الدُّروسِ والأيَّامِ الخوالي. ويختزنُ حُمِّيدُ أحزانَه هذه ولا يُفجِّرُها غُبناً أو ضَجَراً بالحياة، إنَّما يُعيدُ إنتاجَها أملاً وتفاؤلاً غامراً، فيطلبُ بذوقٍ عالٍ وأدبٍ جمٍّ من الحرازِ أن يرجعَ كأوَّلِ عهدِه إلى ملامحِه القديمة، فننتظرُ معه بفارغِ صبرٍ ومن غيرِ يأسٍ أو مَلَلٍ عودةَ العصافيرِ المغرِّدة. وفي منزلٍ غير مُستأجَرٍ بالحارة “٢١”، كنَّا بمعيَّةِ الأستاذَيْنِ عبد الله عبد الوهاب ومحمَّد جلال هاشم، نُتابعُ مع الأستاذ مسعود محمَّد علي أخبارَ حربِ الخليج الثَّانية في عام ١٩٩٠ عبر راديو ماركة “سِلينا”، ساعد في فكِّ الحصارِ الإعلاميِّ عنَّا في ذلك الوقتِ القميئ؛ وكان لمسعودٍ علاقةٌ خاصَّة بذلك المِذياع، بل كان منذُ صباه الباكر في مرابيع ودَّ اللِّبيِّح يعشقُ الاستماعَ إلى الرَّاديو الَّذي فتحَ أمامَه آفاقاً ما كان يحلمُ بتحقُّقِها في بيئتِه الرِّيفيَّةِ المحدودة؛ وكنَّا نحلمُ مع حُمِّيد بمَقدِمِ العصافير الَّتي اقتربَ وقتُ مجيئها، وكان ذلك يتَّخذُ عندنا شكلاً ملموساً يتمثَّلُ في انبثاقِ “طريقِ المعلوماتِ الفائقةِ السُّرعة” (“إنفورميشن سوبرهايواي” أو “إنفوبان”)، الَّذي أصبح يُعرَفُ فيما بعد بالإنترنت.
وعبر الإذاعةِ البريطانيَّة بلندن، كان يأتي إلينا صوتُ الطَّيِّب صالح قويَّاً وممتلئاً بحبٍّ غامرٍ للبلادِ وأهلها الطَّيِّبين، مثلما كانت رواية “الموسم” تمتلئُ بدفقاتٍ من الشَّوقِ والحنينِ الجارفَيْن: “عدتُ وبي شوقٌ عظيمٌ إلى أهلي في تلك القريةِ الصَّغيرةِ عند منحنى النِّيل؛ سبعةُ أعوامٍ وأنا أحِنُّ إليهم وأحلمُ بهم”؛ وهو في ذلك يُذكِّرُنا بحُمِّيد الَّذي جاء إلى البندرِ من تلك الأنحاءِ على ضفافِ النِّيل؛ وهذا الحنينُ الجارفُ إلى الوطنِ هو الَّذي دفعه في الأساسِ إلى العودةِ ببطله مصطفى سعيد إلى تلك القرية الوادعة عند منحنى النَّهرِ؛ لا من أجلِ نفسِه، بل من أجل أن ينشأ ولداه، محمود وسعيد، “مشبَّعَيْنِ بهواءِ هذا البلدِ وروائحِه وألوانِه وتاريخِه ووجوهِ أهلِه”، وذلك “حتَّى تحتلَّ حياتُه مكانَها الصَّحيح كشيءٍ له معنًى”. في المقابل، هيَّأ بطلُ الرِّواية لنفسِه غرفةً واحدة من الطُّوبِ الأحمر، مستطيلةَ الشَّكل، ونوافذَ خضراء؛ سقفُها ليس مسطَّحاً كبقيَّةِ الغرف، ولكنَّه مثلثٌ كظهرِ الثَّور”؛ وفي داخلِ الغرقة، تتراصفُ كُتُبٌ من جميعِ الأصنافِ والتَّخصُّصات؛ وبقربِ المدفأةِ عددٌ من صحيفة “التَّايمز” اللَّندنيَّة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٢٧، يحرصُ الكاتبُ على إطلاعِنا على محتوياتِه بالتَّفصيل: “المواليد، الزِّيجات، الوفيَّات، مراسيمُ الزَّواج، مراسيمُ الجنازة، الرَّسائلُ الشَّخصيَّة، الإعلانات، أخبارُ الرِّياضةِ وأخبارُ الجريمة”؛ ثمَّ لا يأتي إلَّا في النِّهايةِ إلى المقالةِ الافتتاحيَّة وأخبارِ السِّياسةِ والشُّؤونِ الدُّوليَّة، ثم يتساءلُ الرَّاوي قائلاً: “إنَّها الصَّحيفةُ الوحيدة فيما يبدو، فهل وجودُها هنا له أيُّ مدلولٍ أم أنَّها محضُ الصُّدفة”؟ وبما أنَّ الرِّوايةَ في الأساسِ عملٌ فنِّيٌّ متعمَّدٌ لا مجالَ فيه لحدوثِ صُدَفٍ إلَّا بتخطيطٍ مُسبَق، فإنَّنا نُجيبُ هنا بأنَّ وجودَ صحيفةِ “التَّايمز” -وهي الصَّحيفةُ البريطانيَّةُ الوحيدة الَّتي تنشرُ أخبارَ الزِّيجاتِ والوفيَّات- يأتي بمثابةِ معادلٍ موضوعيٍّ لنشرةِ الثَّامنةِ”؛ فمثلما أنَّ الحنينَ إلى البلدِ كان يدفعُ شاعرُ الوطنِ إلى أن يهفو يوميَّاً للاستماعِ إلى النَّشرةِ المحلِّيَّة، فكذلك فإنَّ بطل رواية “الموسم” كان يتوسَّلُ بالصَّحيفة للارتباطِ بماضٍ لا فكاكَ من تبعاتِه أو على حدِّ قوله لتعلُّقٍ: “بأشياءَ مبهمةٍ في روحي وفي دمي، تدفعُني إلى مناطقَ بعيدةٍ تتراءى لي ولا يمكن تجاهُلُها”.