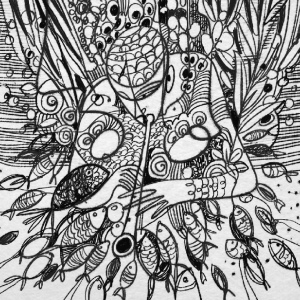تمثال نكروما
١. مقدمة: عن الشكل والمضمون
عملية الدعوة لفكرة هي عملية مُعقَّدة. فالفكرة لا تشمل فقط محتواها كموضوع، بل كذلك تتضمن الإطار الذي يتم تقديمها فيه. وبالنسبة لأيةِ فكرةٍ عامّة، بمعنى أن لكلّ عقلٍ مَدخَلٌ لها، فإن الإطار يحتلُّ موقعاً متقدّماً على المضمون. إذ لا يَشرح الإطار الفكرة بصورة أوضح فقط، بل وكذلك يُحافظ على عموميتها بجعلِ القارئ نَفسه مالكاً لها وليس مُتلقّياً فقط.
لا أضع هذه الفكرة في إطار كتابة الرأي فقط، كرأي يمكن لأي شخص قبوله أو رفضه، وبالتالي فعملية القبول هنا تتحول تلقائيَّاً لالتزام آيديولوجيٍّ صارم. بل كذلك في إطار كتابة رأي يستطيع القارئ أن يُلاحظ أنه قَبِلَ به سلفاً. أي حتى قبل قراءة هذا المقال. وبالتالي، فإنني أرى أن “الشيوعية الإفريقية” هي ليست فكرة حان أوانها فقط، بل إنها عمليَّاً الفكرة الوحيدة المتاحة للإنسان الإفريقي حال صِدقه في طلب الحقيقة. وهنا أودّ أن أقول بأن هذا الإطار يضع هذا المقال في شكل الرسالة بين رفاق لم يلتقوا بعد. لا أكثر ولا أقل.
٢. عن عملية التصنيع التجاري للبشر
يُخيّم على المجتمع الحديث اليوم عددٌ من الأشباح. يُمكن تلخيصها في ثلاثة ظواهر: الجريمة، والمخدرات، والانتحار. هذا إذا تجاهلنا مسألة الحرب مؤقتاً. وبينما يمكن النظر لهذه الظواهر كاستثناءات، حسب السردية الرائجة، فإن أيّ نظرٍ أدَقّ سيجعلنا نرى أنها ظواهر عامّة اعتيادية. من ناحية الجريمة، فإنه يمكن ملاحظة أن واحدة من أعمدة المجتمع الحديث هو جهاز الشرطة والأمن. وبالتالي فإنه لا يمكن الادعاء بأن الجريمة هي ظاهرة ثانوية. بالنسبة للمخدرات فيجب ملاحظة أن الطلب على هذه السلعة هو من العلو بحيث أنه قد فشلت كل محاولات الدولة الحديثة في كبته. ويشير تاريخ منع الكحول في الولايات المتحدة ثم جعلها متاحة إلى حقيقة بسيطة: تحوَّلت الكحول إلى واحدة من أكثر المنتجات استهلاكاً في المجتمع الأمريكي، أي أنه لا يمكن القول بأن الطلب عليها كان من نوعية الطلب على الممنوع. كان الطلب حقيقيَّاً. والطلب على أشكال المخدرات والمسكنات الحالية هو حقيقيٌّ كذلك، إذ أن الأفيون السابق (دين الدولة الرسمي طبعاً) قد انتهى مفعوله. أما بالنسبة للانتحار فهو يمثل في الحقيقة الشكل الكامل لكلّ ما سبق: فَشَل الحياة أمام الموت. وهو ليس ظاهرة ثانوية بأي مقياس، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار ما يسميه علماء الاجتماع بالموت باليأس، وهو مجموع أولئك الذين يقودهم اليأس للإدمان وأذية النفس بأشكالٍ عدة تنتهي بالموت المبكر.
ما أودّ قوله هو أن هذه الظواهر هي ظواهر صحية إذا ما قارناها بما يُسمَّى بالإنسان العادي.
تقوم الرأسمالية الحديثة بعقد مقايضة دقيقة وجذرية مع الفرد الحديث في بداية حياته. فلنقل في عمر الـ٢٠: أنت تعطي المجتمع الصناعي طاقة عملك يوميا لمدة ٤٠ عاماً على الأقل، ويمنحك المجتمع في المقابل فترة استراحة في نهاية عمرك، في شكل ما يُسمَّى بالمعاش، مع تغطية احتياجاتك الأساسية خلال هذه الفترة. ولا تشمل هذه المقايضة القُدرة على اختيار المجال الذي ستُفنِي فيه الـ٤٠ عاماً، الأكثر إنتاجاً في المسيرة التي نسميها قصة حياة. قد ينتهي بك الأمر طبيباً أو بوَّاباً. حسب اجتهادك في عملية المنافسة الاجتماعية، وعدد غير قليل من الصدف في الطريق. لكن حتى الأطباء لا يتم إعفائهم من شروط المقايضة الأساسية: الزمن.
الوحيدون الناجون هم رجال الأعمال. يحصلون على ما يُسمَّى بالحرية النقدية، الحرية من ضرورة الوجود داخل الوظيفة وإمكانية فعل ما يريدون بوقتهم. لكن فئة رجال الأعمال الناجحين تمثل أقل من ١٪ من كل المجتمع، وذلك هيكلياً غير قابل للتغيير، لأنه لو أصبح الكلّ حرَّاً نقديّاً، فمن أين سيأتي رجال الأعمال بالمُعيَّنين؟. غير هذه الاستحالة الهيكلية، فلرجال الأعمال نوع معيَّن من الصفات النفسية والفردية لا تتوفر للكل. هذا إذا تجاهلنا الظروف الهيكلية التي ستقف ضدّ شخص من إفريقيا جنوب الصحراء في مقابل آخر في فلوريدا. حتى إذا تساوى الشخصان في بقية الصفات.
للزمن وضع جدليّ مُعقَّد يجعله السلعة ذات القيمة الأكبر لدى الإنسان. يمكن فهم ذلك عبر تسمية الزمن باسمه الحقيقيّ، وليس التجاري: الحياة. لكلّ إنسان قَدْرٌ محدود من الزمن، ويعتمد كل شيء بالتالي على توفّر هذه المادة العصيَّة على الاستبدال. أية مقايضة لأية لحظة من الوقت يجب أن تتضمن عملية تقييم دقيقة لقيمة الوقت، باعتباره سلعةً غير قابلة للاستبدال.
ما يُسمَّى بـ”الإنسان العادي”، يقبل المقايضة. بل وينهمك فيها بحماس باعتبارها شيئاً قام هو باختياره بحرية. بينما يشير كل شيء للعكس: لم يوجد على الأرض مخدّم واحد جعل الذهاب للعمل شيئاً اختيارياً. حتى أشد المتحمسين لـ”الكارير” سيحتاجون للعصى أو الجزرة، أو كلاهما. ويدرك الجميع فطريّاً الفرق بين “العمل” والأشياء الأخرى التي يقوم بها الشخص مختاراً في ما يُسمَّى بوقت الفراغ. ويُدرك الجميع فطريَّاً أن هيكل العمل الحالي يقضي على أغلب الرغبات الحرّة الأخرى بإزاحتها لمنزلة العمل غير المفيد، والضار بالتالي من الناحية النقدية، أو بعرقلة قدرة الفرد على تنفيذها. أو المخاطرة بالالتزام فيها.
العصاب النفسي هو إذن في صف الإنسان العادي بصورة أشد من الظواهر الثلاث في الأعلى. بل إن مرتكبي الظواهر الثلاث في الأعلى هم التمثّل الأكثر معقولية للعادية في الإنسان. لتوق الإنسان لشيء آخر. إذ يظلّ السؤال التالي مهماً: ما هي قيمة الحياة إذا كان الواحد منا سيقضي أغلبها (وخاصة فترة الشباب والصحة) بين مكان العمل والبيت في دائرة أبدية مملة وقاتلة لكل ذرة إبداع أو شغف لدى الإنسان؟ وعلى هذا السؤال تجاوب البروليتاريا (المجرمون، والمدمنون، وضحايا الموت باليأس) وعلى الإنسان العادي أن يسمعهم.
بالطبع فإن المقايضة الأساسية لم تتم طوعاً. رغم أنها مغطَّاة بشبكة سميكة من الهياكل والآيديولوجيا. تمت هذه المقايضة على خلفية من العنف التاريخي الصارم، أجهزة الدولة وقوانين السوق. إلا أن الدقة في السيطرة والتحكم تكون أكبر فعلاً عندما لا تكون قاسية بصورة واضحة. لكن لتلاحظ فعاليَّة آلية التحكم الحالية، خاصة في الدول المتقدمة اقتصادياً، يمكنك أن تراجع إحصائيات الانتحار: واحدة من أهم المهددات بالانتحار بالنسبة للذكر في المجتمع الأمريكي هي فصله من وظيفته. هنا يمكنك تحسّس العنف الضمني السابق للمقايضة: ترتبط حياة الفرد من حيث احتياجاته المادية، دفع الإيجار وتوفير الطعام لأسرته، ومن حيث استقراره النفسي وشعوره بالقيمة في المجتمع، بصورة صارمة باستمراره في الوظيفة، بحيث يفقد الشخص حرفياً “كل شيء” حال إقالته. لا عجب إذن أن المقايضة تتضمن كذلك عملية تحكم شمولي في كل التفاصيل الأخرى في حياة الفرد: أفكاره، توجهه السياسي، حياته الخاصة.. إلخ. وأصبح من المعتاد في عملية التوظيف الأمريكية تنبيه الموظف لأن لا يكتب أشياء لا تليق في وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا إن تجاهلنا عمليات العنف الأخرى؛ مثل منع التنظيم وتصعيبه، عملية الشراء المالي للسياسة، الحروب والانقلابات وعمليات الاغتيال إلخ.
وفي مقابل المرتب، أصبح الإنسان الحديث ليس فقط معزولاً عن نفسه، بل عبداً حديثاً للوردات الجدد. في ما سماه البعض بـ”الإقطاعية الجديدة”. حيث، بامتلاك لوردات الإقطاع الجدد لحصصٍ واسعة من وسائل الإنتاج، ووجود جيوش من العمال تُطلب وظائفهم، لم يعد التعيين والمرتب المقدم معتمداً على قيمة العمل، أي إعطاء العامل حصةً من قيمة عمله وأخذ الباقي كفائض قيمة، بل بات مُعتمداً على ما يراه لوردات السوق مناسباً من ناحية تكاليف الحياة. ما هو القدر الكافي لهذا العامل ليعيش حياة جيدة؟. وذلك طبعاً كان معيار التقييم في زمن الإقطاعية، قبل دخول الناس في السوق.
يدرك الناس بصورة تلقائية أن الوضع الحالي هو وضع مفروض عليهم. ويكرهونه. يظهر ذلك في أغلب الاستفتاءات وإحصاءات الرأي عن السياسيين وعن فساد الأنظمة السياسية حتى في الدول الديمقراطية. لكنهم مع ذلك يقبلونه عمليَّاً كضرورة. يجب رؤية هذا الهيكل بوضوح:
يقف هذا النظام على أساس آيديولوجي. يجب على الفرد للاستمرار في تأدية دوره بصورة اعتيادية، يجب عليه أن لا يرى ما حوله، مثلما تقبل البقرة في مزارع التصنيع الصناعي للحوم بعملية تربيتها وتغذيتها بسعادة، غير قادرة على رؤية هيكل أسنة التقطيع حولها. علينا كأفراد أن نستمر في العمل وكأننا لا نرى أن النظام يقوم على استهلاكنا كمواد خام، وأنه يقوم، بصورة منهجية، بتدمير كل أساسيات الحياة كهبة خاصة يجب عيشها فعلاً. ابتداء من الأساس الفردي النفسي للحياة، مروراً بالحياة كعمل اجتماعي، نهاية بالحياة كجزء من الطبيعة التي يتم تدميرها منهجيّاً.
لا تقلق: لا يَطلُب منك هذا المقال أن تتحول إلى رحَّالة تهيم خارج النظام. ولا أن تترك وظيفتك. جدليَّاً فإن عملية الاقتناع العقلي والروحي أهم من الأداء العملي اليومي. بل إن مجرد التحرر ذهنياً من الغشاء الآيديولوجي هو بداية للعيش عملياً في إطار روحي مختلف. والحرية هي في الحقيقة عملية السعي لتحققها صدقاً للواحد منّا وللجميع. وليس عيش نسخة مبسترة فردية عاجزة منها. وإذا وَثَقنا في الحقيقة فإنه يمكن القول بثقة بأن الكادر الشيوعي يستطيع في نفس الوقت العيش كإنسان عادي (بالمعنى السلبي للكلمة)، والعمل بفعالية ضد النظام ككل، بل ومن داخله. وهذا “العمل” هو في الحقيقة الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموت الذي هو الخضوع لنظام التوظيف التقني الحالي. هو “عمل” بالمعنى الحقيقي للكلمة، عمل بمعنى أنه شيء يقوم به الواحد منا راغباً بحرية، ويكون مستعداً لأن يفني حياته داخله كشغف لشيء سام وجميل. الرغبة والمسؤولية، كلاهما، شيء واحد في هذا الإطار.
٣. الفرد: جدل الحياة والموت، أو الوجود والعدم
سيلاحظ القاريء أن مدخلي لنقد الوضع الحالي، الذي يمكن أن نسميه رأسمالية أو عولمة، في إطار مقال الدعوة هذا، كان فردانيَّاً. أنا لم أتطرق لأشياء ربما هي أكثر خطورة مادياً، مثل تهديد الحرب أو التدمير البيئي أو النووي. أو حتى للتحليل الاجتماعي لآثار الفقر على المجتمعات، ابتداء من الأسرة ونهاية بتهديد الحرب الأهلية، وكل هذه مداخل لها وزنها في إطار نقد النظام الحالي. لكنني اخترت المدخل الفردي. خاصة للقطاع الحديث (البشر الذين هم مدخلات ومخرجات عملية التدريب التقني والتوظيف)، ذلك أن هذا القطاع بات يتوسَّع بصورة مضطردة بحيث أنه سيشمل كل الفئة العمرية التي تُسمَّى الشباب.
أنا أعتقد أن أفضل طريق لتجنيد الكادر الشيوعي ابتداء هو التعامل مع هذه الظاهرة (النظام الحالي) في مستواها الفلسفي. ذلك أن نقول في مستوى معناها بالنسبة للفرد الواحد. نوع الوجود الروحي الذي تخلقه. وهذا الفردي (ما هو معنى الحياة في ظل النظام الحالي؟)، هو في نفس الوقت العام جذريّ. هنالك شيء روحي أو فلنقل ديني في الفرد، يستطيع الواحد منا أن يراه يتردد عبر الوجود في جوف الجميع. الحياة أو الموت، هما حقائق “فردية” يتم اختبارها بالتعريف كتجربة وجودية خاصة، لكنها مع ذلك “حقائق” عامة.
المدخل هنا هو في الحقيقة تأسيسي: في مستوى التساؤل عن الحياة والموت. ولذلك فقط فهو مدخل يمكن للكل فهمه، بل الارتباط معه بصورة حاسمة. كل قارئ لهذا المقال، قبل أن يرغب في الدفاع عن البيئة أو منع الحرب الأهلية، فهو يرغب في الحياة نفسها. أن يوجد مكتملاً كإنسان له معنى. ثم بعد تحقق هذا الشرط لا يرفض أيٌّ منّا أن يموت. لكن ما يخشاه كل فرد بصورة عميقة هو حرمانه من “الحياة الحقيقية” التي تعني بصورة أخرى “الموت في داخل الحياة نفسها”. في فترة مراهقته، ذكر لي شاب قريب لي مرة، بأنه يخشى من الحياة كالنمل، سألته: ماذا يعني هذا؟ أجاب، تعيش النملة كل حياتها متنقلة من مكان الغذاء إلى المأوى. وبالتالي فـ”العالم” بالنسبة لها هو ذلك الفضاء الضيق. ما تريد الأنظمة الحالية للتحكم والسيطرة فعلاً هو إنزالنا كبشر لمستوى الحياة كالنمل. وأنا أستثمر في هذا التناقض: لمقاومة هذا النوع من الموت، ابتدع البشر الشعر والفن والمحبة والشغف بالعلم والعمل الاجتماعي الرفاقي، والنضال من أجل الشيوعية.
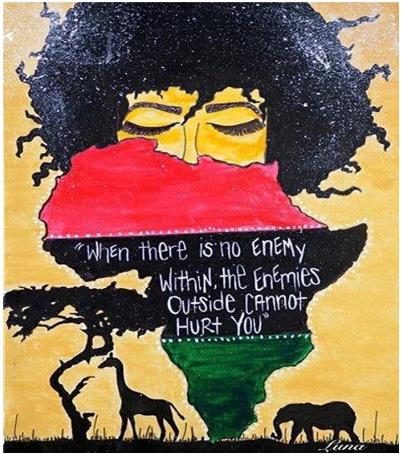
هذه دعوة من نوع خاص إذن. أنا لا أَدعُ أيَّ شخصٍ للعمل من أجل الآخرين. أو للتضحية. هذه المعايير تنتمي لأخلاق المسؤولية. التي هي أخلاق اجتماعية مفروضة من خارج الفرد وبالمحصلة (وإن كانت تؤدي لبعض الخير) فهي أخلاق محدودة بحدود أخلاق الطبقة الحاكمة. ما أدعو له هو استعادة الذات (والحياة بالتالي) داخل الحقيقة. ذلك أن نقول بأن ما أدعو له هو نوع من التحرُّر. ما تَبني الشيوعية الإفريقية نفسها عليه، وتكون ممكنة فقط في إطاره، هو نوع آخر من البشر (لطيف مثل غاندي أحياناً، ومتوحش مثل جون براون إذا دعت الضرورة)، يرى في عملية النضال من أجل المجتمع العادل، رغبته الخاصة ومعنى حياته. وبالتالي فهو يخوض العملية برمتها ليس كشيء ثقيل يحمله كمسؤولية، بل كشغف يجعله يرتقي للحرية خفيفاً. هذه الأخلاق هي جَذر لم يتم استعماله سياسيّاً للحد الأقصى بعد، وليكون من الممكن التفكير في الشيوعية الإفريقية، وتحقيقها، فلابد من البداية بالأيمان بإمكانية وجود ذلك الفرد. وبالتالي إمكانية وجود مجموع الكادر. علينا أن نتذكر دائماً بأن الشيوعية هي مجرد تجذير للديمقراطية، والديمقراطية تعتمد أساساً على مبدأ الإيمان والثقة في “الناس”.
. التحليل المادي الصارم، للوضع المادي الصلب:
قد ينتظر القارئ المعتاد على ما يمكن تسميته بالشيوعية الماركسية، نوعاً آخر من الكتابة. نوع الكتابة الذي يمكن تسميته بالمادية الفجة. حيث يوجد كل شيء خارج الفرد أو البشر. في أسعار المحاصيل وتعداد العمال وعدد الدبابات إلخ. ومن ذلك التحليل الصارم الأكاديمي يتم جرّ التليولوجيا خلف عربة قطار التاريخ لتصل للمجتمع الشيوعي. الذي هو، وللمفارقة، يتم تخيله كمجتمع “صناعي” دائماً. ويتوقع الماركسي الكلاسيكي أن ذلك التحليل سيخلق الكادر والحزب. والمشروع. وما زلنا في انتظار الجنة المفقودة منذ فترة طويلة. ومن يود انتظار سراب حراك المادة من تلقاء نفسها فهو سينتظر للأبد. ما هو موجود خارج العقل هو مجرد عدم، عدم لأنه شيء، مجرَّد شيء، خارج عملية الخَلق، التي هي عملية إنسانية (أو روحية) إبداعية بالتعريف.
في إطار العالم المُستَعمر تحديداً (إفريقيا) تمت هذه العملية بصورة أكثر سذاجة. حيث سادت قناعة طفولية معتادة بأن تاريخ الغرب سيكرّر نفسه حال دراسته. الليبراليون لهم نسختهم من هذه السخافة تسمى “التنمية”.
في الحقيقة هذا النوع من التفكير هو تفكير غير تاريخي. بمعنى أنه اجتزائي واختزالي لا ينظر للكلية الجدلية للعملية التاريخية. مثلاً: سيكون القارئ الجاد للتاريخ مُدركاً لإشكالية تراتبية النظرية والممارسة في فترات الانتصارات التاريخية، التي تَبنِي المادية الفجَّة نَفسَها عليها (الثورة الفرنسية، ثورة أكتوبر البلشفية، الثورة الشيوعية في الصين، كوبا إلخ). هل نتَجَت أكتوبر الروسية مثلاً عن التحليل المادي الصارم اللينيني و(ما العمل)، أم نَتج (ما العمل) من العملية الثورية الأكتوبرية؟ ذلك أن نسأل: هل اقتنع الكادر الشيوعي الروسي بفكرة لينين (كمحلل واستراتيجي ماركسي كلاسيكي) أولاً، أم رغب في الاشتراكية أولاً؟ هل يصبح الشخص اشتراكياً لأنه قرأ لينين، أم أنه يقرأ لينين لأنه أصبح اشتراكياً؟
ما يجب فهمه بصورة واضحة هو الحقيقة البسيطة التالية: لا يمكن الاقتناع بالتحليل المادي الجدلي ورؤيته (أن يفهم الروسي الأكتوبري لينين) إلا عبر عقل طلب الاشتراكية (أو الحرية عموماً) وتاقَ لها مسبقاً. مثلما لم يكن من الممكن للعقل الفرنسي فهم جان جاك روسو وتطبيقه إلا بعد توقه للديمقراطية مسبقاً.
لذلك لا يمكن إقناع أي شخص بظروف الوضع التاريخي الإفريقي الحالي، وجعله يراها، إلا بعد تجنيده كشيوعي. ولذلك فيجب دائماً التركيز على العموميات. الأمر العام الروحي الواضح: المشروع هو ليس نتيجة لشروط المادة الحتمية في الخارج، بل هو نتاج لمساهمات أفراد وإبداعهم، كذوات حرة تَخلِق التاريخ. ما يُسمَّى بالواقع المادي وشروطه هو نتاج العقل الذي تحرَّر سلفاً. يمكنه أن يراه وأن يتعامل معه. وذلك يجعل المشروع صلباً وهشَّاً في نفس الوقت: صلباً لأن العقل الحر بقدرته على فهم واقعه ورؤيته على حقيقته هو أحد أقوى المؤثرات في الوجود، وهشَّاً لأن ذلك العقل يمكن أن لا يأتي، وبالتالي مهما كان الظرف موضوعياً في مصلحة التقدم فإنه لن يكون موجوداً.
ولذلك فإن لكلٍّ منَّا قيمة. لكلٍّ منَّا كأفراد شيوعيين قيمة مطلقة. ليس بمقياس القيمة النرجسية للفرد الحديث، حيث القيمة مربوطة بتقدير المجتمع. بل بمقياس القيمة الذاتية للروح الحرة. تعيش حياتها كمالكة لقرارها الحر. حكى أستاذنا عبد الله علي إبراهيم مرة عن يافع في عطبرة، نَكِرَة بلا اسم لنتذكره، خرج بعد أن تجند شيوعياً يوزع منشورات الحزب على دراجته، وأتخيله مبتهجاً بحريته عكس الكادر الكئيب الممتعض من (الظروف الموضوعية) ينتظرها تهبّ في اتجاهه كجسدٍ حزينٍ خامل، حكى عبد الله إبراهيم عن ذلك اليافع لسبب: لذلك الشخص قيمة مطلقة، بدونه وبدون جهده الصغير كان للتاريخ أن يتحرك بشكل مختلف، على سبيل المثال ما كان بإمكاني أن أكتب هذه الجمل. هذا التركيز على الذات، على أنها هي، وليس المادة، لها أسبقية في رؤيتنا للمشروع هو انتقالٌ جذريٌّ أراه ضرورياً. وهو الانتقال الذي يمكن أن نسميه (بتعبير آلان باديو): الانتقال من المادية الجدلية، إلى جدل المادة. حيث التركيز هو على العابر، العملية التي تعتمد على المصادفة، غير المُتَأَكَّد منه، الحرية. وليس المادة. ما هو حي، وليس ما هو ميت.
قبل الدعوة للشيوعية عبر المادة وتحليلها، لابد من ترتيب المسرح لهذه العملية. والمسرح هو الشكل العام للشيوعية كفكرة روحية (بمعنى عقلية، نفسية، وجودية.. منهج حياة، تصوّر معين للكون)، وليس كآليات ميكانيكية أو كقوانين فيزيائية جوفاء.
دعنا مثلاً نختبر التعريف التالي للشيوعية الإفريقية: الشيوعية هي نوع من الوجود الاجتماعي والقانوني يكون فيه لكلّ فرد نفس مقدار القوة السياسية لكلّ فردٍ آخر. بمعنى آخر هي الديمقراطية الجذرية. التي تتطلب لتحققها واقعياً توفر الشروط المادية والقانونية التي تمنع الفوارق الطبقية التي تتحول حتمياً لفوارق سياسية. والشيوعية، في إطار إفريقيا، هي السبيل لتكوين مجتمع ما بعد الدولة القومية، يتّحد فيه الأفارقة بصورة كونفيدرالية وديمقراطية تمكّنهم من تحقيق مصالحم الكلية، والدفاع عن أنفسهم كأمم وشعوب القارة.
يمكن للواحد أن يسرد كل التفاصيل المادية للاستغلال المعولم للقارة السوداء. ١٠٪ من البشر يمتلكون ما يساوي ما يمتلكه ٩٠٪، نسبة الأموال الخارجة من القارة السوداء نهباً هي كذا، وضع العمال الزراعيين في بوركينا فاسو هو كذا. لكن ما لا يمكن تحقيقه عبر المادية الفجة هو الخيال الجماعي العام الذي يجعل كل هذه التفاصيل تعمل معاً. وبالتالي، فكل ما انتهى له الماركسيون الكلاسيكيون هو التحول لأنصار لدولة الرعاية الاجتماعية. بل وفي أحيانٍ كثيرة تحولوا لأنصار للشمولية، وناقدين طفوليين للديموقراطية. لأنصار لنوع من التنمية الموجهة أشد قسوةً حتى من تنمية السوق، مثل النظام الصيني الفاشي. لقد تم فقد الغابة عبر التركيز على الأشجار.
أقترح في المقابل نوعاً آخر من العمل الشيوعي: نبدأ بوضع الهدف الجذري، المبدأ الصادق، الحقيقي، كما عرَّفته في الأعلى. ونؤمن بإمكانية العمل الدؤوب على تحقيقه. ونبشّر به ونورّط بعضناً الآخر فيه، بحيث يتحرَّر عدد كبير من العقول لتقوم بدراسة الوضع المادي والعمل فيه بإبداع وتفرد يجعل الواقع الشيوعي ليس كتالوجاً أو كتاباً مقدّساً يجب تطابقه بين كل المجموعات، بل أنواعاً شتَّى من الوجود العادل الذي يتحقق فيه المبدأ وتختلف فيه التفاصيل حسب اختلاف الوضع المادي والثقافي والاجتماعي.