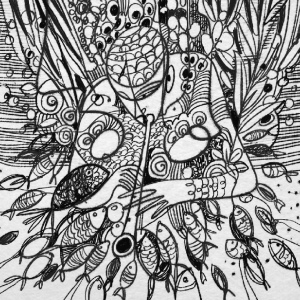يُمكِنُ تلخيصُ الحقبةِ الاستعماريَّة بأنَّها كانت في الغالبِ الأعمِّ صراعٌ لاجبٌ بين فرنسا وإنجلترا للاستيلاء على المواقع الإستراتيجيَّة في العالم بغرض تسهيل نقل موارد المستعمرات؛ وفي فترةٍ محدَّدة، كان ذلك الصِّراع يتمثَّل -آنيَّاً- في التَّنافسِ البحريِّ القائم بين نابليون بونابرت وهوريشيو نيلسون، وهو الصِّراعُ الَّذي توَّجَهُ الأخيرُ بانتصارِه وموتِه في معركة الطَّرف الأغر في عام ١٨٠٥، وقد خلَّد الإنجليزُ ذكراه بإقامةِ تمثالٍ له على رأسِ مِسَلَّةٍ شاهقة في وسطِ ميدانٍ شهيرٍ في قلبِ لندن تَسمَّى باسمِ تلك المعركة (“ترافالغار”)؛ وفي فترةٍ أخرى، تمثَّل ذلك الصِّراع -تعاقبيَّاً- في شكلِ أطماعِ رجلٍ أقبلَ إلى الإسكندريَّة من كورسيكا عبر باريسَ وطولونَ ومالطا، وهو بونابرت نفسُه، وتواطؤ غازٍ آخرَ أقامَ لاحقاً في حاضرةِ مصرَ، وهو الدُّبلوماسيُّ البريطانيُّ اللُّورد كرومر؛ وقد كان حلمُ الأوَّل تشييدَ قناةٍ على البحر الأحمر لقطع طريق إنجلترا إلى الهند وجنوب شرق آسيا بعد أن نجحت في الاستيلاء على رأس الرَّجاء الصَّالح، بينما انحصر دور الثَّاني في حماية الاستثمار البريطانيِّ في شركة قناة السِّويس بعد أن باع إسماعيل باشا أسهمَه في الشَّركة إلى إنجلترا في عام ١٨٧٥، لتُصبِحَ مُشارِكَةً لفرنسا في إدارة الشَّركة الَّتي تملُكُ فيها حقَّ الامتياز منذُ تأسيسها في عام ١٨٥٨، ومن ثَمَّ إكمالها لبناء القناة في عام ١٨٦٩.
إلَّا أنَّ ما دفعنا في المقام الأوَّل إلى كتابة هذا المقال هو تصحيحُ معلومةٍ خاطئة وَرَدَت عن غيرِ قصدٍ في ثنايا المقال السَّابق، حيثُ قلنا إنَّ نابليون عندما غزا مصرَ “صحِبَ معه ألفَ عالِمٍ متخصِّصٍ في شتَّى ضرورب المعرفة”؛ وفي واقع الأمر، قد صحِبَ الغازي الفرنسيُّ الكورسيكيُّ الأصلِ معه مائةً وخمسينَ عالِماً (كانوا يُلَقَّبونَ بدائرة المعارف الحيَّة)؛ ولكنَّنا وجدنا أنَّ لذلك الخطأ فوائدَ لا تُحصى، من بينها التَّنبيهُ لأنفسِنا وكافَّةِ القرَّاء بأهمِّيَّة إصلاح الخطأ باصطيادِه جماعيَّاً والتَّعلُّم من الآفاق الَّتي يفتحُها وُرُودُه. وفي رسالةٍ عقب صدورِ المقال وقبل الانتباهِ إلى هذا الخطأ، قلتُ للصَّديق وجدي كامل “لقد ظللتُ لفترةٍ طويلة أدعو وأُحرِّضُ أصدقائي وجمهرة القرَّاء على وجه العموم، خصوصاً مَن لهم معرفةٌ متخصِّصة لا أدَّعيها ووقتٌ أكبرُ لا أملكُه، أن يتناولوا رؤوسَ المواضيعِ الَّتي أتطرَّقُ إليها بالنَّقد، بهدفِ توسيعِها وتعميقها والتَّخلُّص ممَّا هو قابلٌ منها للدَّحض أو ما كان منها مؤشِّرٌ لوجودِ فسادٍ بَيِّن”. ومن بين تلك الفوائد، ما هو متعلِّقٌ باستكمالِ ما بدأناه في المقال السَّابق، والَّذي سنستأنفه هنا بتحليل كلمة “ألف” نفسِها في علاقتِها بتسرُّبِ اللُّغةِ الفرنسيَّة إلى إحدى لغاتِ العامِّيَّةِ العربيَّة الواسعةِ الانتشار في المدنِ العاصميَّةِ الثَّلاث (وشُكراً لوجدي على التَّنبيه إلى تعدُّد العامِّيَّاتِ العربيَّة في البنادرِ السُّودانيَّة).
في البدء، نذكُرُ أنَّ حرفَ “ألِف” هو أوَّلُ حروفِ العربيَّة، غير أنَّ ما نقصُدُه في هذا المقال هو الرَّقمُ العددي “١٠٠٠” (واحدٌ وأمامُه ثلاثةُ أصفار)؛ وربَّما كان الجمعُ بين الدَّالَّيْن شِبهِ المتطابقَيْنِ صوتيَّاً هو ما قاد صرفيَّاً إلى مفهوم “التَّأليف”، حيثُ يقوم “المؤلِّف” بجمعِ “آلافٍ” من الحروفِ والكلمات لتوصيلِ مقاصِده بدَلالاتٍ محدَّدة؛ وهذا ما يقودُنا إلى معنًى ثانٍ بشأنِ الرَّقم: فلغيابِ مُفرَدَةِ “مِليون” (و”بِليون” و”ترِليون” إلى آخرِها) في العربيَّةِ الكلاسيكيَّة، ظلَّت كلمة “ألْف” تنوبُ عنِ الأرقامِ الغائبة للتَّعبيرِ عن الكثرةِ المُطلقة؛ فإذا قلنا في التَّعبيرِ الدَّارج إنَّ أمراً حدَثَ قبلَ أو سيحدُثُ بعدَ ألفِ عام، فليس المقصودُ هو دَلالةُ العدد على وجهِ التَّحديد، وإنَّما التَّعبيرُ عن الكثرةِ على وجهِ التَّعميم؛ وربَّما كان ذلك هو مقصدُ الآيةِ الكريمة: “وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ” (سورة “الحج”؛ الآية رقم “٤٧”)؛ فلو كان المقصودُ هو الرَّقمُ على وجهِ التَّحديد، لأمكَنَ حصرُ مكانِ تحقُّقِ تلك المدَّة داخلِ مجرَّةِ دربِ التَّبَّانة، ولفَسَدَ إذاً مقصدُ الإطلاقِ الإلهي، وهذا باطلٌ ومستحيل. وعندما وضعنا عبارة “ألف عالِم”، كنَّا نأمل في تدقيقِ الرَّقمِ بالرُّجوعِ إلى مصدرٍ وَرَدَ فيه، وهو كتابُ “النِّيل الأزرق” لمؤلِّفه ألان مورهيد؛ وبالفعل، رجعنا حينها إلى المصدر، فأَخَذَنَا الكاتبُ، وربَّما المترجمُ أيضاً (إبراهيم عبَّاس أبو الرِّيش)، بِلُغتِه السَّاحِرة، صفحةً على إثرِ أخرى، فلم نبلُغ هدفَنا بعد أن قطعنا شوطاً في التَّلذُّذِ بقراءته، فتركنا الأمرَ إلى أن نُكمِلَ المقال، إلَّا أنَّ أسلوبَه السَّاحِرَ أنسَانَا ما كنَّا نرمي إليه؛ وبعد نشرِ المقال، حانت لنا سانحةٌ لمراجعةِ الأمرِ في مَظَانِّه، فوجدنا الرَّقمَ الصَّحيح، بحسبِ المصدرِ المذكور، في الصَّفحة رقم “١١١”، وهو “نحو المائة وخمسين رجلاً” من العلماء الفطاحِل.
يُجدر بالذِّكر، أنَّ كلمة “ألْف” تقابلها في اللَّاتينيَّة بمعناها الحرفيِّ كلمة “ألْفا”؛ وبمعناها الرَّقمي، مُفرَدَة “مِل” (“١٠٠٠”، واحدٌ وأمامه ثلاثةُ أصفار)؛ وهي ما تعتمدُ عليهِ اللُّغاتُ الأوروبيَّة باستخدامِها كبادئةٍ في عددٍ من المفردات، ومنها: “مِلِّيمِتر” (وهي واحدٌ من ألف من المِتر)، و”مِلِّيلِتر” (وهي واحدٌ من ألف من اللِّتر)، و”مِلِّيسَكَند” أي مِلِّيثانية (وهي واحدٌ من ألف من الثَّانية)؛ كما تستخدِمُ كلمة “مِليون” (وتعني ألفَ ألف، واحدٌ وأمامه ستَّةُ أصفار)، ومنه تنتقلُ إلى “باي” (اِثنين) و”تراي” (ثلاثة) و”كوادري” (أربعة)، فتقولُ في نظامٍ عدديٍّ شِبهِ مفتوح: “بِليون” (واحدٌ وأمامه تسعةُ أصفار)؛ وبزيادةِ ثلاثةِ أصفارٍ في كلِّ مرَّة، تقول: “ترِليلون”، “كوادرِليون”، “كونتِليون”، إلى آخرِها. وقد قبِل الإنجليزُ هذه المفرداتِ لتسلسُلِها المنطقيِّ ولصرامتِها في إجراءِ الحسابات، رغم تمرُّدِ الموغلينَ في عَصَبِيَّتِهِمُ الثَّقافيِّة على النِّظام المتريِّ العَشري؛ فهؤلاء القِلَّةُ يُفضِّلون، على سبيل المثال، استخدام المَيْل على الكيلومتر، والياردة على المِتر، والبوصة على السِّنتمِتر؛ وقد سعى غُلاتُهم بعد خروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبِّيِّ إلى إعادةِ فرضِ رؤيتهم الضَّيِّقة، ولكن هيهات؛ فالنِّظامُ المتريُّ سهلُ الاستخدامِ إلى درجةٍ لا تُضاهَى. ولكن بسببٍ من تأثُّر العامِّيَّةِ العربيَّة الواسعةِ الانتشار في المدنِ الثَّلاثِ بمَسحةٍ من الفرنسيَّة، فقد قبِلنا منها ما يحرِمُنا من الاستفادةِ القصوى من هذا النِّظامِ العدديِّ شِبهِ المفتوح.
ومع انهيارِ قيمةِ العملةِ السُّودانيَّة بشكلٍ متلاحق منذُ الاستقلال، تخلَّينا منذُ رَدَحٍ عنِ استخدامِ كلمة “مِلِّيم” الَّتي تعني: واحدٌ من ألفٍ من الجنيه، ولكنَّها لازالت هي الدَّليلُ الإتيمولوجيُّ (أصلُ الكلماتِ) الأوحدُ على أنَّ عُملَتَنا الوطنيَّة هي الجنيه (“ألفُ” مِلِّيم)، وليس الرِّيال (“مِئةُ” مِلِّيم) أو القِرش (“عشرةُ” مِلِّيمات)، وذلك على الرَّغم من لُهاثِ الفاسدينَ وراءِ الرِّيالاتِ وتكديسِهِمُ الآثمِ للقُروشِ المنهوبةِ من الشَّعب. وبدلاً من تصنيفِهم للعُملةِ وفقاً للنِّظامِ العدديِّ شبهِ المفتوح الَّذي يتماشى مع انهيارِها المتلاحق ومطامعِهم غير المحدودة، ليُكدِّسوا منها المِليونَ، فالبِليونَ، فالتِّرليونَ إلى آخرِها، وليصبحوا مِليونيراتٍ، وترِليونيراتٍ، وكوادرِليونيراتٍ إلى آخرِها، نجدهم يتَّبعون النِّظامَ العدديَّ الفرنسي، فيقولون مِلياراً بدلاً من بِليون؛ ويُصبِحون بين ليلةٍ وضُحاها مِليارديرات، لِيتضوَّرَ شعبُهم لألفِ عام، ولكن هيهات، فحتماً سيتمُّ اقتلاعُهم من جذورِهم (وسوف تتمُّ محاسبتُهم “على دائرِ المِلِّيم”). غير أنَّ ما يُثيرُ الغيظَ حقَّاً أنَّ أطماعَهم تتركَّزُ فقط على ذواتِهِمُ الضَّيِّقة من غيرِ هدفٍ إستراتيجي، بعد انكشافِ أمرِ دعواهُمُ الكاذبةِ بشأنِ نصرةِ الإسلام، بأنَّها “هي للهِ” ليسَ إلَّا. بالمقارنةِ مع هذا الأمرِ المؤسف، عمِلَ نابليونُ رغم مطامِحِه الشَّخصيَّة على نشرِ الثَّقافةِ الفرنسيَّة، فصحِبَ معه “دائرةَ معارفَ حيَّة”، إضافةً إلى المكتباتِ والمطابعِ المحمولةِ على متنِ سفينة القيادة “الشَّرق” (“أوغيا’ن‘”). كما عمِلَ اللُّورد كرومر على حماية المصالح الاقتصاديَّة والإستراتيجيَّة للمستعمِرِ الأوروبِّي، رغم تواطُؤه مع الظَّهيرِ المصريِّ على إرسالِ حملةٍ بقيادة الإيرل كِتشِنَر لانتزاعِ السُّلطةِ من أيدي الخليفة عبد الله التَّعايشي.

وكان الهدفُ من الحملة هو استرضاءَ الحركةِ الوطنيَّةِ المصريَّةِ الصَّاعدة في أعقابِ الثَّورة العُرابيَّة بتأمينِ العُمقِ الجنوبيِّ لحُكمِهِمُ المأمول، في مقابلِ السُّكوتِ عن المطالبةِ بحقِّهِمُ المشروع في قناةِ السِّويس، الَّتي تمتلكُ حقَّ الامتيازِ فيها الشَّركةُ الَّتي أسَّسها الفرنسيُّ فيردينان دو لِسِبْس في عام ١٨٥٨، كما سبقتِ الإشارةُ إلى ذلك؛ وهو حقٌّ لم يُنتزَع إلَّا بعدَ مُضِيِ ما يقرُبُ من القرنِ على أيدي الرَّئيسِ المصريِّ الأسبق جمال عبد النَّاصر، بعد تدخُّلِ الاتِّحادِ السُّوفيتيِّ السَّابق بإنذارِه الشَّهير الَّذي ساعدَ على صدِّ العدوانِ الثُّلاثيِّ على مصر، والَّذي اشتركت فيه كلٌّ من فرنسا وإنجلترا وإسرائيل. فإذاً، بمجيءِ عبد النَّاصر إلى الحكم في مِصرَ عام ١٩٥٢ وعودةِ القناةِ إلى أصحابِها الحقيقيِّين في عام ١٩٥٦، لم يعُد هناك مُسَوِّغٌ لبقاءِ الإنجليزِ في السُّودان. وهذا بالطَّبع لا ينتقِصُ من نضالاتِ الوطنيِّين الَّذين نالوا الاستقلالَ عن جدارة، ولكنَّه يُشيرُ إلى حدوثِه في سياقِ مرحلة تفكيك الاستعمارِ القديم وانحسارِ مصالِحِه الاقتصاديَّةِ في المنطقة، بضياعِ القناةِ وانفلاتِها نهائيَّاً من قبضته. ولولا ذلك، لَمَا تمَّ التَّسليمُ والتَّسلُّم بنفحةٍ من الودِّ و”التَّحضُّر” برفعِ العَلَمِ على باحةِ القصر، ولاستلزمَ الأمرَ قتالٌ شرِس، شبيهاً بما تمَّ في الجزائرِ ضدَّ الفرنسيِّين أو في موزمبيقَ ضدَّ البرتغاليِّين أو في زمبابوي ضدَّ الإنجليزِ أنفسِهم. صحيحٌ أنَّه كان لدى البريطانيِّين مشاريعُ ضخمة، منها مشروع الجزيرة، ولكنَّها مشاريعُ قامت في المقامِ الأوَّل لتسديدِ الدُّيونِ النَّاجمةِ عن تمويلِ الحملةِ إلى الخزينةِ المصريَّة، ولتحقيقِ “نوعٍ ما من الاستقلالِ” لحكومةِ الخرطوم الَّتي سدَّدت آخرَ قِسطٍ من ديونِ الحملةِ في أوائلِ الأربعينيَّاتِ من القرنِ الماضي.
قد رحل الإنجليزُ عنِ السُّودان ولم يُخلِّفوا وراءهم لُغَةً يُعتَزُّ بِها في حاضرةِ البلاد، إلَّا في أوساطِ قِلَّةٍ اهتمُّوا بها، وأولوها عنايةً خاصَّة؛ وقد فطِنَ الكاتبُ الكبير الطَّيِّب صالح إلى هذا الموضوع، فصوَّرَهُ بشكلٍ أدبيٍّ مكثَّف في شخصيَّة “مصطفى سعيد” البطلِ الأشهر لرواية “موسم الهجرة إلى الشَّمال” (الَّذي يُوصِفُه “المأمور المتقاعد” بالقول: “كان المدرِّسونَ يُكلِّموننا بلهجة ويُكلِّمونه هو بلهجةٍ أخرى، خصوصاً مدرِّسو اللُّغةِ الإنجليزيَّة”)، هذا إلى جانب شخصيَّة “الرَّاوي” الَّذي حضَّر رسالةَ “دكتوراه” (ولم يقُلِ الكاتب “دكتور فلسفة” أو “بي إتش دي”) في إنجلترا تدورُ حول شاعرٍ مغمور. ولكن على المستوى الفعلي، كان هناك رواجٌ لشخصيَّةٍ نمطيَّة يُطلَقُ عليها لقب: “الرَّجلُ الإنجليزيُّ الأسود” (“ذا بلاك إنقليشمَن”)، فكانت تُرضِي غرورَ البعض، ولكنَّ الغالبيَّةَ العُظمى قد تُرِكت نَهبَاً للتَّنقُّلِ المتقطِّعِ بين شِفرتَيْن (“كود إسويتشينغ”)، هما العربيَّةُ والإنجليزيِّة، من غيرِ أن تُحسِنَ إجادةَ أيٍّ منهما، إلَّا فيما ندرَ ويُحسَبُ مثل أيِّ نُبوغٍ مُبكِّرٍ على أصابعِ اليد. كما رحل الفرنسيُّون عن مِصرَ، ولكنَّ أَثَرَ نابليونَ قد امتدَّ بعدَهُ جنوباً، لِتترُكَ أجيالٌ لاحِقةٌ من المصريِّينَ نفحةً مميَّزة من لغةٍ فرنسيَّةٍ على إحدى عامِّيَّات المركز، وهي مفرداتٌ لا يقتصِرُ تداولُها على السُّوقِ الأفرنجيِّ فقط، بل يصِلُ مداها إلى السُّوقِ العربيِّ ومطارِ الخرطوم (“بيا’ن‘فينو”، التي استهجنَ الطِّيِّب صالح وجودَها، من غير أن يفطنَ الكاتبُ الكبيرُ هذه المرَّة إلى تسرُّب “صويحباتِها” إلى لغتِه العامِّيَّة) وأحياء أمدرمانَ وبحري، ودورِ عرضِ سينماتِها المتعدِّدة (الَّتي تُظهِرُ عبارة “لا فا’ن‘”، وتعني النِّهاية، في بعضِ أفلامِها)؛ أمَّا في دور عرضِ دار السَّلام السِّرِّيَّة، فتنهضُ بالمكشوفِ لغةٌ فرنسيَّةٌ مكتملةُ اللِّسان، نأمَلُ أن تُصبِحَ بعد تخلُّصِها من جريرةِ “الجنجويدِ” جزءاً لا يتجزَّأ من مزايا التَّعدُّدِ اللُّغويِّ المرغوبةِ في السُّودان.