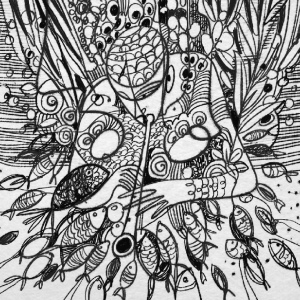عرضٌ لكتاب "إفريقيا تحت أضواء جديدة"
A Review of Basil Davidson’s Old AfricaRediscovered
الجزء الثالث
الفصل الثالث من الكتاب عنوانُه “ممالك السودان القديم”، وهو أكبر فصول الكتاب حجما. وخلال صفحاته الكثيرة يتوقف دافدسُن عند الممالك القديمة في السودان (=غرب إفريقيا)، بادئا الحديث بالقول: “يشرَع التاريخُ المكتوب في غرب إفريقيا بعد أربعة قرون من أفول مروي الذي أسرعت به إكسوم في القرن الرابع، وأخفَتـها كقوة حضارية ضارية“، ذاكرا أن سجلات تلك الممالك في غرب إفريقيا مقروءة ومفهومة، لأنها كُتبت باللغة العربية. وعرَض الهجرات التي وصلت غرب إفريقيا من شرقها وشمالها، واختلاطها بالسكان المحليين، وكذلك تتبعَ عادات هؤلاء السكان القدامى وحياتهم. ووضّح أن عثور المنقبين على آثار بشرية في منطقة نـُك Nok، غيّر كثيرا في الآراء التي كان يؤمن بها الناس عن ماضي غرب إفريقيا. إنّ ما عرف بثقافة الأشكال النكية (Nok figurine culture) – ]إشارةً إلى “النماذج التي وجدت في ذاك الإقليم الممتد ثلاثمئة ميل على الوادي الأخضر الذي يحتضنه مقرن النيجر والبينو“[ – أثبت أن تلك المنطقة شهدت صناعاتٍ وفنونا ” أقرب ما تكون إلى بعض مدارس الفن في عصرنا الحديث“، وتوحي بأن مجتمع نــُك “كان فترة انتقال بين استعمال الحجر والمعدن“. وقبل أن يغادر دافدسُن هذه الزاوية من الحديث، علق قائلا: ” أما الأصل الذي نما هذه الشعوب التي صنعت الرؤوس الممتازة التي عُثـر عليها في نيجيريا، فلم يهتد إليه باحث بعد، وإن كانت بعض هذه الصور المتناثرة منذ ألفي سنة أو تزيد تدل على أن قبائل نك Nok كانت السلف الأول لكثير من القبائل التي تعيش اليوم في نيجيريا“.
في هذا الفصل أيضا يتساءل دافدسُن ” أكانت هناك وحدة ثقافية ولغوية بين هذه الشعوب التي سكنت الغابات في الزمان البعيد“؟، وتبدو الإجابة في علمه أنْ نعم، مشيرا إلى الهجرات الواسعة بين سكان المنطقة التي تنحصر بين كوش وقرطاجنة. إذ كان الناس “يهاجرون من النيل إلى شاد ومن شاد إلى النيل، يحملون في قلوبهم وأيديهم خلال رحلاتهم الشاقة هذه عقائدَهم التي يعتقدون وفنونَـهم التي يمارسون“، كما أن الأساطير المتوارثة لكثير من قبائل غرب إفريقيا تصل نسبَ هذه القبائل بأصول في الشرق أو الشمال، حتى وإن كانت هذه الأساطير موضع تساؤل، كما يلمح دافدسُن، فإنها ليست كذلك عند هذه القبائل نفسها. ويضيف دافدسُن أيضا أن آلهة مصر سافرت غربا، استعار بعضَها البربرُ الليبيون، وأن آلهةً في قبائل الغرب الإفريقي ومصر وكوش تأخذ الشكل ذاته، حتى وإن تغيرت بعضُ تفاصيل الدين. يذكر دافدسُن أن كثيرا من الشواهد تدل على أن إفريقيا امتازت في الزمان السحيق ذاك بالترابط الثقافي. وأن تلك المجتمعات في غرب إفريقيا عرفت صناعة الحديد والحصول على المعادن، والتجارة فيها، والتسلح بها.

من أهم ما قام بفعله دافدسُن في هذا الفصل، هو عرضُه لحياة أربع دول إفريقية، هي غانا ومالي وكانم وسنغي Songhay، وهي ممالك ” كان لها شأن بعيد، وكانت قوية الصلة ببعضها البعض، وإن كان لكل منها ما يميزها عن غيرها“. نشأت جميع هذه الممالك في السافنا، وقامت على “تجارة المدن، وعلى اقتصاد زراعي دقيق النظام“. ولا يسرف المرء إن قال – كما يذهب دافدسُن– “إن بعض هذه الدول فاقت في حضارتها الدولَ التي عاصرتها في أوربا“. وكانت دولا ذات جيوش قوية مهابة، “لم تقلّ شأنا عن جيوش عهد الإقطاع” في أوربا. دولة غانا دولةٌ ذات صيت وثراء، كما يتجلى من بحث دافدسُن، وأيام مجدها امتدت لتشمل النيجر شماله الأعلى والغربي، وأن عاصمتها كانت “ذات أسواق عديدة، تزينها أشجار النخل الغزيرة، وأشجار الحناء تكاد أن تبلغ الزيتون في الطول، مليئة بالمنازل الجميلة والأبنية القوية الراسخة“. ولقد كانت محط القوافل الثرية، حاملة الملحَ وأخرازَ البندقية. ولقد خاضت حروبا كثيرة مع جيرانها، وربما ذلك ما أنهكها في آخر أيامها. وعن مالي، يذكر المؤلف أنه في عام 1703م، اعتلى العرشَ كانكان موسى، وهو “أشهر ملوك السودان القديم، وأكثر من زاد رقعة مالي“. ومشهور في التاريخ الإسلامي مرورُه بالقاهرة، في طريقه للحج، والأبهةُ التي عرضها هناك. وأن تمبكتو وبقية حواضر مالي كانت “آمنة رخية تضفي على العلماء ما يريدونه من سكينة وسلام وانقطاع للدرس“، ونمتِ المعرفة، وازدهرت فيها الثقافة المكتوبة في الوقت الذي “اجتاحت فيه أوربا حرب المائة عام“. ويصف دافدسُن حضارة تمبكتو بأن” لها خصائصها ومقوماتها التي جعلت منها ذاتية منفردة لقاء الشمال الإفريقي الذي استمدت منه الجذوة الأولى“. ومستعيرا قول ابن بطوطة، يذكر دافدسُن أن المرأة في تمبكتو كانت ” أعظم شأنا من الرجل“، إذ إن العرش هناك يُعتلى من قبل الأم لا من قبل الأب.أما دولة سنغي Songhay فقد حملت مشعل الحضارة والتجارة على حد وصف دافدسُن لها، وكانت ذات ثقافة مكتوبة، وأهم مدنها جاو Gao، فالآثار هناك من أروع ما وجد المنقبون. هذه الدولة خرجت مبكرا من الاعتماد على القبيلة الأم، إلى بناء إمبراطورية تضم عددا من الشعوب، ظلت تتوسع وتتقوّى. وازدهرت هذه الدولة أكثر على أيام اسكي محمد الذي ولي العرش عام 1493م، ومعه بلغت قمةَ توسعها شمالا وغربا، وقد بدأ “عهدا جديدا من التقدم نحو الدولة المركزية الموحدة في السودان الغربي”، مستعينا بالتجارة والإسلام في ذلك، وأشاع بهذا السلامَ والثقافة في مدن غرب إفريقيا القديمة. يقول دافدسن: ” لا تنتهي قصة النمو الذي عاشه السودان الغربي في قرون ازدهاره” عند سنغي، بل مشى الوضع إلى تكوين جماعة مدنية أكبر تضم عددا من القبائل. كانت كانم أطولَ الدول التي نشأت في غرب إفريقيا عمرا، أخذت من كوش، وبنت مدنها على بحيرة شاد، وأخذت النساء مناصب ذات بال في الدولة. كانت مدنها “حلقة أخرى من حلقات الاتصال الثقافي بين النيل والنيجر“. وكان ذاك المجتمع ماهرا في أشغال البرونز والنحاس وصهر الحديد. وينقل دافدسُن عن أرفوي (Urvoy Yeves) قوله عن كانم أنها “كانت أستاذة الحضارة السودانية (=إفريقيا الغربية)، …، أخذت عن العرب وليست عربية، وأخذت من زنج الجنوب ولم تكن زنجية، تختلف عنهما، وتتميز بطابعها الفريد“. مرت أيامها بهدوء ورخاء وتوسع وأيضا بقلاقل وصراعات. وكانت دائمة الصلة بمنطقة النيل الأوسط. وتوقف دافدسُن عند دارفور، وعلاقتها بكوش، وأهمية دارفور ضمن سلسلة الدول الإفريقية، وربطها بين مناطق النيل والنيجر.
خلال هذا الجزء من الكتاب، أبدى دافدسُن ملاحظات على تاريخ هذه الدول، موضحا أنها تشترك في مظاهر عدة، مثلًا تطورها الحضاري وفترات الاستقرار والتوحّد، وكذلك المصير الذي آلت إليه. ويثير أسئلة عن قعود هذه الحضارات التي أصبحت مجرد آثار. يُجرِي دافدسُن في تضاعيف هذا الفصل، مقارنةً متكررة بين حال إفريقيا آنذاك وحال أوربا، قبل ثلاثمائة وخمسين سنة، ويرى أن الفرق لم يكن كبيرا، غير أن إفريقيا ذات الزراعة وقفت، بينما تقدمت أوربا. ولا يعزو دافدسُن ذلك لاختلاف الجنسين، بل لظروف بيئية وأخرى اجتماعية. كانت المادة التاريخية التي أخذ عنها دافدسُن معلوماته عن تاريخ المنطقة، هي مراجع عربية في الأغلب، فقد اعتمد كثيرا في وصفه لمجتمعات تلك الدول وملوكها، على أعمال محمد بن بطوطة، والحسن بن محمد الوزان (المعروف أيضا بــ Leo Africanus)، وعبد الله البكري، وأبي الفداء إسماعيل، ومحمود التمبكتي صاحب تاريخ الفتّاش، وكانت مصادرَ موثوقةً عند دافدسُن، وكان معجبا أحيانا باستغراقها في التفاصيل. وقد شغلت ممالك غرب إفريقيا كثيرا من المؤرخين العرب آنذاك، وهذا ما يدعم أن إفريقيا ذلك الزمان، وبالتحديد غربيّـها، لم تكن معزولة ونائية عن بقية العالم، خاصة المدن العربية، إذ كانت الثقافة العربية “مصدرا جوهريا في خلق حضارتها، وثقافتها في القرون الوسطى“. ولقد كانت اللغة العربية في تلك المجتمعات الإفريقية لغة مرموقة، فهي لغة التجارة مع الشمال والشرق، وهي لغة الدين الإسلامي الأولى. والإسلامُ كما جاء في هذا الكتاب، كان “وازعا قويا لتوحيد الشعوب، وقيام الممالك“. هذه الممالك الزاهرة انتهت بالغزو والصراعات الداخلية أواخر أيامها، ونتيجة لتغيرات كثيرة حدثت في سُبل التجارة العالمية الخارجية، وبداية التطور التكنلوجي الأوربي.
في الفصل التالي، ذي العنوان.. “بين النيجر والكنقو”، يبحث دافدسُن في تاريخ شعوب هذه المنطقة، متوقفا أولا عند تجارة الرقيق، التي اتخذت “معنى جديدا حين شرعت السفنُ الأوروبيةُ تنقل آلاف الشباب من الداخل والساحل، تدمي الحياة في القارة“. هذه التجارة خربت المجتمع هناك، وأوقفت نموه الحضاري، وفيه يفنّد دافدسُن زعـــمَ الأوربيين الذين يروجون أن وزر هذه التجارة يحمله الإفريقيون وحدهم، ويقيم دافدسُن الأدلة على آرائه ويستنطق الوثائق، وهذه النقطة من الكتاب تمثل تجليا من تجليات راديكالية دافدسُن في دراسته لتاريخ إفريقيا قبل الاستعمار. ينتقل دافدسُن في موضع آخر إلى الحديث عمّا عادت به بعثة بنين عام 1897م، وبعثات أخرى، “تلك التحف النادرة المدهشة“، البرونزية والعاجية، التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والثامن عشر الميلاديين، تقول أشياء جديدة غير مألوفة، وتظهر مجتمعا فنّانا، لا يليق وصفه بالفوضى المتوحشة. كان مجتمعا منفتحا، متأثرا بالأعماق الحضارية المجاورة، إذ تتشابه كثير من عقائده وفنونه مع شعوب أخرى في الغرب الإفريقي، مما يعكس صورة لوحدة متنوعة كانت تذخر بها القارة آنذاك.
في الفصل الخامس، تتجه أنظار دافدسُن صوبَ الجنوب، نحو الشعوب الزنجية، مستفيدا كثيرا مما كتبه مؤرخ “ذو أهمية غير عادية“، كتاباتُه “هي النور الأول الأصيل الملقى على تطور عصر الحديد في إفريقيا الجنوبية، ونمو المجتمع الذي طوره وحضره“، هذا المؤرخ هو أبو الحسن علي المسعودي (ت 956م)، الذي وثّق رحلاته على شاطئ إفريقيا الشرقي الجنوبي، وقدم وصفا لعادات الزنوج هناك، وطرق عيشهم. درس دافدسُن هنا سلالاتِ تلك الشعوب القديمة، وصِلتها بالشعوب القاطنة اليوم هناك، وتتبع معتقداتها ونشاطاتها الاقتصادية. توقفَ عند أُسس الحضارة الجنوبية، وتجارتها العالمية مع الجزر الهندية، وقيام تلك المجتمعات القديمة التي يرى أنها لم تأتِ من فراغ، بل تداخلت ثقافيا مع سكان الشمال والغرب الإفريقيّين، إذ ليس بعيدا – اعتمادا على الشواهد هناك كما يرى دافدسُن – أن يكون “أثرُ كوش القوي النشط قد وصل جنوبَ إفريقيا“، إضافة إلى التيارات الحضارية التي تأتي مع تجارة المحيط الهندي، وعلى أثر هذه التجارة توقف دافدسُن في الفصل التالي.
في ذهابه إلى التاريخ القديم، بحث دافدسُن هناك عن مدن سبأ، والحضارات القديمة التي نشأت في جنوب الجزيرة العربية، يريد بذلك تتبع أثرها في تاريخ إفريقيا، خاصة شرقها. جعله هذا يتوقف مليا عند الإبحار على ساحل إفريقيا الشرقي، ومدنه الإفريقية التي ذكرها المؤرخون القدامى. كانت تجارة ثرية وممتدة حتى الصين، إذ كانت السفن الصينية المتطورة آنذاك (عصور هان 25م-220م) مدربة على الوصول حتى سواحل إفريقيا، حيث المدن الثرية في الانتظار.
الفصل السابع من هذا الكتاب، يبحث بمزيج من الجدة البحثية واللغة الشعرية، في تاريخ “مدن الحجر المنسية”. يوسع دافدسُن الحديث عن مدن شرق إفريقيا، واصفا مجيء فاسكوا ديقاما إليها، وما لقيه هناك، وبداية البطش البرتغالي بالسكان الإفريقيين. نسبة للوجود العربي اللافت في مدن إفريقيا الشرقية الساحلية، يعرض دافدسُن التساؤلَ التالي: “أكان لإفريقيا تاريخٌ حقا وصدقا!، ألم يكن كله امتدادا لتاريخ العرب!”، وهل يجوز “أن نسوق شواهد من التاريخ العربي الخالص لندلل بها على تاريخ إفريقي!“، ومدفوعا بهذه الأسئلة، أفردَ عنوانا جانبيا لمناقشة هذه النقطة، هو (عربية أم إفريقـية؟). تحت هذا العنوان، يشير دافدسُن إلى أن “الحياة الخصبة التي وجدها البرتغاليون على ساحل القارة، كانت حياة عالمية (cosmopolitan)، يشترك فيها الهنود والفرس، والإفريقيون من شتى أنحاء القارة نفسها“، والنشاط التجاري كان ذاخرا، ومضى متتبعا العلائق القديمة بين العرب وشرق إفريقيا، والتداخل الثقافي التجاري بينهما. قائلا إنه وبمُضـيِّ السنين، لم تعد هناك “وسيلة لتمييز عناصر هذه الحضارة الجديدة“. وختم ملخصا هذه النقطة عن هوية تلك المدن التجارية على الساحل وبالقرب منه، أنها لم تكن عربية أو فارسية أو هندية، كانت إفريقية زنجية، وكان “النغم الحضاري الغالب عليها زنجيا“، مثلها مثل مدن الغرب الإفريقي، ذات الصبغة الإسلامية العربية، غير أنها بقيت إفريقية القواعد والأسس.
يجيء الفصل الثامن بعد هذا، حافلا بمعلومات نفيسة، إذ يقف البحثُ عند تاريخ مملكة إكسوم، وعظمة إثيوبيا ذات “القصة المتماسكة المذهلة“، ذاكرا مكانة إكسوم في التاريخ الإفريقي، خاصة في المرافئ الشرقية، ومشيرا أيضا إلى اتصال وثيق بين نقطة تاريخ إثيوبيا والجزيرة العربية. ازدهرت إكسوم كما يورد دافدسُن، على تجارة البحر الأحمر، أيامها الأولى، وخاضت حروبا ضارية مع جارتها كوش. ويذكر الكاتب أن اعتناق إكسوم للمسيحية جعلها تحس بكينونة مستقلة عن جاراتها، ما دفعها لخوض حروب دينية عديدة، وهو ما تسبب في عزلتهاعن القارة. تابَع الفصلُ تطورَ الزراعة السفحية المدرجة في إثيوبيا، وقيام القلاع المنيعة على رؤوس الجبال، وأشار إلى تلك الرمزية في وجود شكلِ عضو الذكَر في كثير مما خلف الإثيوبيون القدامى من آثار، ويذكر دافدسُن وجود هذا الشكل ذاته في نواحي أخرى من إفريقيا. يتضمن البحث بعد ذلك، إشارات إلى الاكتشافات في انقاروكا، وما تركته من أثر على صورة تاريخ المنطقة، إذا ظهر أن “الأقاليم الداخلية في كينيا وتنجانيقا وراء الساحل التجاري في شرق إفريقيا، كانت تعيش نموذجا من حضارة العصر الحجري، ازدهر هناك ونما في القرون الوسطى“.
يشهد هذا الفصلُ استرسالا في الحديث عن تاريخ أزانيا Azania. فالأزانيون قد تركوا “آثارا ضخمة من مدن عريقة… ذات مساكن متقنة من الحجر الصرف، وخلقوا قنوات للري، وحذقوا التصوير على الصخر“. وفي بحثه عن هوية هؤلاء الأزانيين، يذكر دافدسُن أن الفترة بين 500م و 1500م كانت ” أزهى عصور التجارة وأنعشها بين شرق إفريقيا، والأقطار البحرية على المحيط الهندي، وكانت قمة تطور عصر الحديد في شرق إفريقيا وجنوبها“، ولكن لقلة المعلومات المتوفرة، والغزوات الشمالية على شرق إفريقيا، وعوامل أخرى، جعلت معرفة أصل الأزانيبن بالضبط مستعصية، غير أن المتفق عليه هو أنهم جماعة إفريقية مستقرة، لم تأتِ مهاجرة، أسست حضارة دامت حينا، وهاجرت إلى الجنوب أكثر، فاتخذت خصائص أخرى، وتركت تفاصيل أوضح، هناك في ذلك الركن البعيد، على السفوح العالية. فهناك على عدة ألاف أميال من النيل والنيجر، كما يختم دافدسُن هذا الفصل، “أنتجت إفريقيا قصة أخرى من قصص النمو الإنساني وتطوره، وأضافت فصلا فريدا لا ينسى في كتاب النشوء البشري“.
يبتدأ دافدسُن الفصل التاسع وهو فصل يأخذ حيزا معتبرا بين ضفتـي الكتاب، سماه بُناة الجنوب، واضعا في الاستهلال عبارة لدافيد راندال (David Randall-MacIver) تقول: “بذل بناة هذه الآثار هنا جهدا مكافئا للجهد الذي بذله بناة الأهرام“، قال راندال هذا حين كان ينقب في خرائب نايكيرك Niekerkعام 1905م. ومضمون هذا الفصل يكشف عن آثار عظيمة في الجنوب الإفريقي، في موزمبيق وزمبابوي، على أيام حضارة عصر الحديد، التي تشتمل على سجل لتجربة اجتماعية وسياسية طويلة في تلك الأنحاء. معتمدا على أحدث الاكتشافات في زمبابوي، ينطلق دافدسُن متتبعا مناحي الحياة القديمة هناك. يتوقف عند النمط المعماري، الذي يرجعه دافدسُن إلى وحي العبقرية الإفريقية الأصيلة. ففي عهد الرخاء والمال، فرضت زمبابوي “مجدها على زائري الساحل فرضا، فحجوا إليها، ونقلوا عنها“، حتى أن الأوربيين تملكتهم الدهشةُ حين رأوا مبانيها الضخمة القوية أول مرة. ويتوقف الحديثُ عند بداية النفوذ الأوربي هناك، والصدام، والخراب الذي تركه الطامعون في الثراء على الآثار القديمة التي تحكي حكاية زيمبابوي. أثارت زمبابوي اختلافات في الرأي بشأن عمق تاريخها، ولكن الذي لا خلاف عليه هو أن هذا الإقليم “كان يتمتع بقدرات فنية عظيمة ومكانة اجتماعية ذات مهابة وسلطان، ووحدة في القيادة والاتجاه“، وكان أيضا ذا تجارة واسعة، ومعرفة بالمعادن، والعملات المعدنية ذلك قبل القرن الثالث عشر. وبعد تتبعه لكثير من الأبحاث الأركيولوجية في مناطق عدة، ونتائجها، حول تاريخ المنطقة في العصور القديمة، ونمط الحياة آنذاك، يخلص دافدسُن في خاتمة الفصل، إلى أن قواعد زمبابوي وأسسها وُضعت في الوقت ذاته الذي وُضعت فيه الأسس البعيدة الأولى لحضارة غانا، ففي ذلك الوقت، كان أهل زمبابوي (نايكيرك وأنيانقا) “يبنون الأميال الطويلة من المصاطب على التلال للزراعة السفحية، ويبنون الحصون على رؤوس الجبال“.
في الفصول الثلاثة الأخيرة، يحشد دافدسُن كثيرا من الخلاصات، ويبيّن الحقائق وراء الآثار. يسترسل في الحديث عن النحت الإفريقي، ومفاهيم أساسية في حديثه، كالبدائية والتقدم، والبربرية، ويفند كثيرا من الادعاءات التي لا ترى بعد كل هذا في إفريقيا إلا كتلة من ظلام، واقفا عند التطور الفنـي/التقنـي الذي شهدته إفريقيا بمقاييس ذلك الزمان. والأمر كذلك على نماذج الحكم، إذ يرى دافدسُن كثيرا من التجنـّي على الوضع السياسـي الإفريقي القديم، عارضا سلطات الملوك، والنظم الاجتماعية المتينة في الحياة حولهم. وخلص إلى أن المجتمع الإفريقي كان “يسير قدما نحو عين الاتجاه الذي كانت تسيره أوربا“، مشيرا إلى أنه ليس من العدل أن نطلق صفة التحضر على ما كان في أوربا آنذاك من فنون مادية وعادات اجتماعية، ثم نتهم ما كان في إفريقيا بالتخلف، إذ لن يخطئ الدارسون للمجتمعيْـن كثيرا من نقاط الالتقاء بينهما. من ناحية أخرى، يواصل دافدسُن البحث عن الأسباب التي دعت الحضارات الإفريقية الجنوبية، التي كانت متماسكة مرنة، تأخذ وتعطي، إلى التهاوي والتمزق، بعد أن كانت تسير سريعة مثلها مثل حضارات عصر الحديد الأخرى، وسرعان ما يبادر بالقول إن الذبول والأفول هنا لا يعنيان اختفاء الثقافة التي قامت عليها تلك الدول. يرى دافدسُن أن هناك أسبابا مقنعة لهذا، منها التدهور الاجتماعي، ونزول البرتغاليين المسلحين على شواطئ إفريقيا، وانتشار الرغبة في الرقيق بعد الحاجة العالمية للأيدي العاملة. هذا وغيره، هو مما جعل إفريقيا قفرا موحشا مظلما، حين دخلها أوربيو القرن التاسع عشر، وحسبت أوربا هذا الحال سرمديا، لم يسبقه عمران ولا ثراء.
خاتمة
خلال صفحات هذا الكتاب، أثبت دافدسُن بالفعل، أن موقفه المنهجـي المبدئي من ماضي إفريقيا كان معتدلا، لم يكن يكيل لها المدح الذي لا تستحق، ولكنه أيضا لم يكن يغض النظر عما شهدته من نمو وازدهار رفيع بمقاييس ذلك الزمان. ولقد كان مؤمنا بأن وراء ذلك الغموض، الذي ما زال مسيطرا حتى وقت كتابته هذا السِفر، قلبًا إفريقيا ينبض بالحياة. يؤكد دافدسُن أن هذا التاريخ هو تاريخ قوم عاندوا الطبيعة وقهروها، وأن في جنباته عاشت شعوبٌ كانت “تحمل معها آراء جديدة، وقدرات مبتكرة، تيسّر العيش على وجه قارةٍ صعبة القياد“، ومهما تعثرت، وواجهت من مشاكل، إلا أنها أقامت حلولا تميـزت بأنها ذات خصائص إفريقية محضة، وفي الوقت ذاته، شاركت العالم حولها إنسانيته العامة. إن حضارات إفريقيا كما يلاحظ دافدسُن، جهلت بعضها القراءة والكتابة، غير أن الوضع لم يكن أحسن حالا أيضا عند شعوب شمال أوربا.
يقرُّ دافدسُن بحاجة التاريخ الإفريقي إلى مزيد من اجتهادات الآثاريين، وينادي بضرورة دعم الحكومات والمجتمعات لأعمال البعثات الآثارية ونشر تقاريرها، وأيضا – وهو ما يراه أكثر أهميةً – إلى “ترجمات حديثة وطبعات جديدة للآثار العربية القديمة” التي تعرض كثيرا من تاريخ إفريقيا، فما زال المجال كما يقول: “في حاجة لمزيد من هذه الروائع العربية، لنفهم القارة كما فهموها في أيامهم الخالية“.
تتبعَ هذا الكتابُ الحياةَ الإفريقية القديمة، قبل وصول الأوربيين الغازين إلى شطآنها وأدغالها، وأثبت بالفعل، استنادا على حقائق موثقة، وخلاصات تاريخية وآثار كثيرة، أن إفريقيا لم تكن منذ بداية أمرها غارقة في فوضـى عارمة، كانت تعرف نظما اجتماعية صارمة توجه الأفراد، ومعتقدات دينية راسخة، ولها أعراف عسكرية، وتجارة مع مجاوريها، وكانت شعوبها مثل جميع شعوب الأرض آنذاك، تقيم الدول، وتحاول التوسع والسيطرة، ولأسباب عرض بعضها دافدسُن، آلت حالُها إلى ما وجده عليها الأوربيون في القرن التاسع عشر الميلادي. ربما أحدث تطور تكنولوجيا الآثار إنجازاتٍ مذهلةً في تاريخ إفريقيا بعد صدور هذا الكتاب، ولكن ما زال هذا العمل يحتل مكانته الرائدة في التأريخ لـمُدن إفريقيا المغمورة، تاريخها الجديد المغاير الذي بدأ يتقدم ويزيحعن الطريق التاريخَ العنصري القديم، ومن هنا تأتي أهميته.
وبالنسبة للقارئ بالعربية، فقد أضافت ترجمةُ هذا الكتاب على يديْ جمال محمد أحمد أبعادا أخرى له، منها المقدمة التي وضعها، والهوامش التي أثبتها، والأسلوب الذي أصبح أكثر رشاقة، هذا كله إضافة إلى نهج جمال في الترجمة، وطريقته المثيرة في الكتابة والتعريب، إذ يوفر هذا الكتاب مادة غزيرة لطرق اشتغال قدرات جمال في التعريب واجتهاداته الذكية. ولا شك في كونِ هذا العرض العاجل، الذي حاول رسم خطوط عريضة عن محتوى الكتاب، غير كافٍ لإظهار كل آراء دافدسُن القديرة، فهي هناك تامة غير مختزلة بين صفحات الكتاب، ولكنه كما نأمل ربما يعين الذين لم يصل الكتاب إلى مكتباتهم الخاصة بعد، ويعطيهم لمحات عن عوالم هذا الكتاب، دفَعنا للقيام بهذا العرض عودةُ النقاش عن تاريخ إفريقيا القديم إلى السطح، والحديث الذي لا ينقطع عن الهوية، والحاجة الظاهرة إلى إعادة تسليط هذه الأضواء الجديدة مجددا، خاصة مع خلوّ المكتبات العربية وحتى الرقميات من كتب كهذا، ولإيماننا بأن المستقبل لا يُبنى على فراغ.