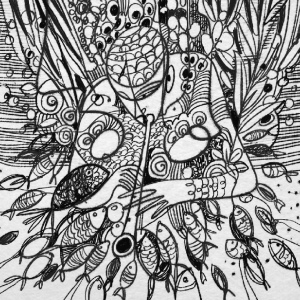لرولان بارت[i] مقال ألمعي عن لحظات الخروج من دور العرض السينمائية، يصف فيه حال جسده وذهنه بعد مشاهدته لفيلم، ويحلل عناصر المكان -أي دار العرض- وعناصر الفيلم صورةً كانت أم موسيقى. هذا المقال نبهني لضرورة وجود دور عرض سينمائية عندنا هنا -في الغالب نحن لا نذهب لمكان عرض، ولكن الصورة قريبة للغاية منا وحاضرة في الهاتف أو اللابتوب، ترتحل لتصلنا، ومن الأنسب أن تقابل رحلتها إلينا رحلة نقطعها نحن لنصل إليها كذلك، لأن سكون جسد الرائي لفيلم يتحتم أن تتبعه حركة لتكتمل الدورة. هذه الحركة قد تسبق المشاهدة في حال وجود دور عرض وقد تتلوها بعد ذلك، وهو ما أفعله، فأنا أحب التمشي بعد مشاهدة فيلم. وفي المرتين اللتين شاهدت فيها أفلاما رفقة جماعة -وهما فيلمان وثائقيان قريبان في موضوعهما من حال البلاد فيما يلي: غياب التمثيل البصري للمكان سينمائيا في عهد النظام (نظام عمر البشير) الآفِل واستحالة وجود دور عرض للأفلام أيضا[ii]، أي ما قبل الصورة أو الأفلام السينمائية، والآخر كان فيلما تسجيليا مثله مثل الأول به عناصِر فنية، وهو عن المراحل الأولى للثورة السورية – في هاتين المشاهَدَتين كانت عيناي تنتقلان من شاشة العرض للأفراد المشاهدين، أراقب ردود أفعالهم وأثر الصورة عليهم -وهو هنا أثر معنوي أكثر من كونه جماليا- ففي هذه البلاد مجهولة المستقبل كانت مشاهدة فيلم عن الثورة السورية تلقي هاجسا ثقيلا على النفس لاحتمال أن نصير إلى ما صاروا إليه (وهنا لن أفرط في التحليل التاريخي أو المقارنة بين الحالتين، لجهلي ولأنه حديث يطول، ولا يطول حديثٌ إلا في جهل).
السينما مثلما نعرف – على العكس من الرواية مثلا – وكما المسرح فنٌ للجماعة، تختبر فيه صورتها وتسائلها وأشياء أخرى.
بالعودة للتمشي بعد الصورة وأثر الصورة وحضورها المكثف بعد انتهاء فيلم ما، أحمل في ذاكرتي – وأن يكتب أحدهم: أتذكر ثم لا يصف ما تذكره، عجز مؤسٍ – لحظات عديدةً عن تسلط الصورة على ذهني بعد مشاهدة فيلم -ولفترة ماضية كنت مصابا بوسواس استعادة صور الفيلم كاملا بعد مشاهدته- أتذكر مثلا اللحظات التي تلت مشاهدتي لفيلم وودي آلن العبقري -Interiors- أو فيلم عباس كيارستمي – Close up- أو فيلم تشارلي كوفمان وسبايك جونز – Being John malkovic. وبطبيعة الحال أميلُ أكثر إلى الأفلام الموسوسة بوعيها بذاتها لا الأفلام المستندة على القصة، أعني الأفلام التي تتساءل عما هي الصورة: أثرها على اللاوعي، تغلغلها في الحلم، تمثيلها للواقع، صورة الذكرى وصورة الوهم وصورة الحلم، ولذا أفضّل أفلام كريستوفر نولان وسكورسيزي وتشارلي كوفمان.
لحظاتٌ كلحظات الدخول إلى النص نعرفها، هنالك من دخل إلى نصٍ ولم يخرج منه؛ أعني دونكيخوته، وقد حاولت مرارا وسأستمر في محاولة الوصول للطريقة التي كان يقرأ بها ألونسو كايخانو قبل أن يصير دونكيخوته وعن تعيين اللحظة الفارقة في هذا التحول، أي نصٍ يا ترى؟ أي غرفة دخلها فلم يعد قادرا على مغادرتها كما حدث لخوسيه أركاديو بوينديا لحظة موته، ففي الرواية هنالك مشهد واحد فقط روته ابنة أخته تقول فيه أنها دخلت عليه فوجدته يتحرك في أرجاء الغرفة حاملا كتابه والعرق يتصبب منه ليخبرها أن هذا العرقَ دماءُ مارد، كان يقرأ واقفاً إذا، وهذا مضحكٌ وجميل وعبقري عديل. كذلك نعرف لحظات الخروج من نص؛ وصفها الطيب صالح بدقة ورواها محيميد عن حاله بعد سماعه لقصة مصطفى سعيد وخروجه من بيته، تلك الليلة التي انقلب فيها كل شيء، وسيظل يحاول أن يخرج من النص فلا يطيق، ومثل دونكيخوته فقد ظن أن الموت سيشفيه، تمنيتها لما تمنيت يا محيميد. لكن ماذا نعرف عن لحظتي الدخول إلى فيلم والخروج منه؛ مقال رولان بارت بلغ الغاية في وصف الخروج، وكذلك مقطع قصير لألبير كامو في (الغريب)، فبعد أسبوع من وفاة أمه يقف ميرسو على الشرفة مساء سبتٍ. ويرى جماعتان ذهبتا للسينما، الأولى مضت إلى المدينة فكانوا قد تخلصوا من أثر الصورة في رحلة عودتهم ونفضوها عن أجسادهم، أما الأخرى فذهبت لسينما قريبة ولذلك كانوا يحاكون ما رأوه ولم يفارقهم الطرب والتقمص، لكن ماذا عن قبل الدخول؟
أستأنس أيضا بموضوع شعري قديم، بدأهُ شعراء الجاهلية ثم تبعهم الغاوون، أقصد زيارة طيف المحبوبة، أيهم رأى ذلك الخيال متمثلا حقا أمامه ويحادثه لا في النوم ولكن في اليقظة، ثم نقل العدوى لمن بعده، هل كانوا يرونه حقا ماثلا، أبياتٌ لهم لا تقول أنهم كانوا يحلمون، قال المُرقِش الأكبر:
سرى ليلاً خيالٌ من سليمى فأرقني وأصحابي هُجودُ
هل رآها فاستيقظ وتأرق، فجعل يرقب أهلها وهم بعيد، ويتخيل اجتماع المحبوبة رفقة صويحباتها حول نار، هذه صورة ولدت صورة، وهذا غاية في الجمال، وكلنا نعرف أبيات تأبط شرا في وصف رحلة الطيف إليه، وتعجبه من تحمله للتعب والأهوال، وهذا مبحث لطيف ومقابل لما بدأتُ به كتابتي: أن تسري الصورة لا كذكرى ولكن كخيال ماثلٍ خارج جسد العاشق، قادمٍ من مجاهيل بعيدة، لم يكونوا يعرفون انفصال الصورة عن الجسد، كان لا بد لها أن تحمل شيئا من خصائصه لتمضي وتصل وتمثُل، قال آخر في حبسه حين رأى الطيف:
عجِبتُ لمسراها وأنى تخلصت إلي، وبابُ السجنِ دوني مغلقُ
ألمَّتْ فحيَّت ثم قامت فودعتْ، فلمّا تولت كادتِ النفسُ تَزْهَقُ
بعدها ككل لحظة شعرية بديعة جعل الشعراء اللاحقون كالبحتري وأبي تمام يجردون ويسائلون ويفترعون معاني حديثة للحظة -وهذا شاهد على بعد الشقة ولِمَ لا انتفاء التجربة-، قال المتنبي:
أَزائِرٌ يا خَيالُ أَم عائِد أَم عِندَ مَولاكَ أَنَّني راقِد
لَيسَ كَما ظَنَّ غَشيَةٌ عَرَضَت فَجِئتَني في خِلالِها قاصِد
عُد وَأَعِدها فَحَبَّذا تَلَفٌ أَلصَقَ ثَديِي بِثَديِكِ الناهِد
وهذا أطال وتمتع، وليالي الخير جادن عليه، أم هو كما قال:
وَيَعصي الهَوى في طَيفِها وَهوَ راقِدُ
ولكن أنّى للطيفِ والذِكرى أن تحل محل التجربة، ألم تقل:
أَوهِ بَديلٌ مِن قَولَتي واهاً لِمَن نَأَت وَالبَديلُ ذِكراها
أَوهِ لِمَن لا أَرى مَحاسِنَها وَأَصلُ واهاً وَأَوهِ مَرآها
شامِيَّةٌ طالَما خَلَوتُ بِها تُبصِرُ في ناظِري مُحَيّاها
فَقَبَّلَت ناظِري تُغالِطُني وَإِنَّما قَبَّلَت بِهِ فاها
فَلَيتَها لا تَزالُ آوِيَةً وَلَيتَهُ لا يَزالُ مَأواها
أي قبّلت نفسها، وهذا بديع. إذن لو اختبر شعراء الجاهلية تقنية الصورة الفوتوغرافية، لضاعت لحظتان شعريتان عظيمتان: زيارة الطيف، وتنوُّر نار المعشوقة: أي التطلع إليها من مكان بعيد.
وكان أحدهم يعرف نار حبيبته، توقدها في ليلٍ دونه المفاوز، وهذا أعجب من وقوفهم بالطلول، ومن تخيلهم لارتحال المحبوبة من موضع لآخر. يقول الحارث بن حلزة في معلقته:
وَبِعَينَيكَ أَوقَدَت هِندٌ النارَ أَخيراً تُلوي بِها العَلياءُ
أَوقَدَتها بَينَ العَقيقِ فَشَخصَينِ بِعودٍ كَما يَلوحُ الضِياءُ
فَتَنَوَّرتُ نارَها مِن بَعيدٍ بِخَزارى هَيهاتَ مِنكَ الصلاءُ
“يقول وإنما أوقدت هند هذه النار بمرآك ومنظر منك فكأن البقعة العالية التي أوقدتها عليها كانت تشير إليك بها. أوقدت هند تلك النار بين هذين الموضعين بعود فلاحت كما يلوح الضياء”[i]
ويقول امرؤ القيس:
تَنَوَّرتُها مِن أَذرِعاتٍ وَأَهلُها بِيَثرِبَ أَدنى دارَها نَظَرٌ عالِ
وأذرِعات ويثرب موضعان متباعدان، لا سبيل إلى أن يُرى أحدهما من مكان الآخر مهما كان مدى الحِس.
وبيت امرئ القيس يروى أيضا بخفض راء (دارِها) على أن أدنى اسم تفضيل، بينما أقرأه أنا على أن (أدنى) فعل، أي قرب دارها إلى ناظري نظرٌ عالٍ، وهو النظر بعين الخيال، كما يقول الطيب صالح في قراءته لهذه الأبيات وتذكره لها.
تستأثر الصورة الفوتوغرافية بحواس الرائي[i] وتأسره في إطارها، وتصرفه كلية عما سواها، وهي تضلله بتقديم الواقع كمرجعية لها، فيما مرجعيتها هي الذهن، فأول انفصال للصورة عن الأشياء في الواقع يكمن في التذكر، ومن ثم في الحلم والمخيلة، أي في اللاوعي الإنساني، لا الوعي الحاضر. إن الصورة حسب فالتر بنيامين[ii] أو الآلة الصانعة لها أي الكاميرا؛ تصل إلى دقائق وتفاصيل لا تبلغها العين المجردة، أو إن بلغتها فهي تبلغها وفقا لوضع جسدي بعينه، وهذا الجسد المهمل والمسترخي الذي ترتحل إليه الصور، منفصلة كلية عن سياقها/واقعها، أي بتعبير بنيامين مسلوبة من هالتها/حضورها وامتدادها التاريخي، هذا الجسد تصرعه الصورة وعبادتها، وربما في لحظات احتضاره الأخيرة لن تعبر بذهنه ذكرى تجاربه الحية، وإنما صور قادمة من أقاليم منسية[iii].
ميزة الكلمة لا تكمن في رسمها، فهو في النهاية صورة، ولكن في الصوت اللافظ لها، في حركة اللسان الجارحة للصمت، فعلى العكس من الكلمة، تحرمنا الصورة من الشعور بامتداد العالم واتساعه، ومن ثم من طرائق معينة في التفكير، كما أنها تشوش شعورنا بالزمن، فالتاريخ كله حاضر في ذات اللحظة، موجود بالقرب منا، لا كشيء قد انقضى وسار إلى غايات بعينها، ولكن كوجود زائف. فالصورة تلغي التاريخ وتمحوه في اللحظة التي تظهره فيها وتعلن عن وجوده. إن تاريخ الكون كله بالضرورة ماثل الآن، ولكن وجود الصورةِ؛ صورتِه، يحجبه.
لنتذكر البحتري في وقفته بإيوان كسرى، وكيف أن تصاوير ومنحوتاتٍ، جعلته يتذكر ويستعيد حضارة فانية، إن الصورة الفوتوغرافية لم تكن لتعبر به نحو أي ماضِ، ولكن اللوحة الفنية سمحت له بأن يبلغ بحسه مداه الأقصى[i].
هوامش وإحالات
[1](الخروج من السينما)، رولان بارت، هسهسة اللغة، تر: منذر عياشي.
[1]فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، فلسنوات قليلة مضت، ما كان لهذا الفيلم أن يبصر في جماعة -وهو الذي تنبني حبكته على صعوبات واجهتها صناعة السينما في السودان في فترة حكم الحركة الإسلامية للبلاد؛ وعدائها للصورة معلوم-، أما قبل سنتين، أي في العام 2020، فإن حشدا من السودانيين أمضوا أمسية الخميس التاسع والعشرين من أكتوبر يطالعون عرض (الحديث عن الأشجار) بحديقة المتحف القومي. انطفأت ظلال أشجار الحديقة لتضيء شجرة عملاقة وسحرية المكان، آخذة أبصار الجمع لسنوات قليلة مضت، حين كان صانعو الفيلم يكابدون مشاقاً عديدة، من بينها وللمفارقة مشقة إيجاد مكان صالح لعرض أحد الأفلام.هنالك جملة سحرية تقابلني يوميا، وتذكرني برأي مشهور لميلان كونديرا عن سنوات احتلال روسيا للتشيك وعن الاستعادة المزعجة لتلك السنوات من قبل الشعب ملفوظة في جملة، وبحديث لجاك دريدا عن الحادي عشر من سبتمبر، جملة تصلح كمفتتح لقصة أو رواية: “في الثلاثين عاما الماضية”، كأن قائليها تتملكهم السعادة إذ استطاعوا الانفصال/مفارقة زمن ما والتخلص منه، كأنهم ولدوا من جديد، كأن الزمن خطي، وهذه الثلاثون عاما الماضية كمضاء السيف قد أعملت فيهم نصالها، وقذفتهم في تواريخ غير معينة- هذا الاسترجاع يجد مبرره في صراع التأريخ، في كون آخرين ينتمون لتلك الأيديولوجيا يحاولون تزييفه، لتصير تلك الجملة شاهدا على بشاعة تلك الأزمنة وخواءها للحد الذي يسمح بجمعها ووضعها في جملة واحدة، كأن حيواتنا جُعِلت مقياسا لأنظمة الاستبداد، نحن الذين عشنا تلك السنين، الثلاثين عاما، كنا هناك.
في الفيلم؛ يبحث عدة أشخاص، مخرجون ومهتمون بالسينما، عن مكان ملائم لعرض فيلم، فيما يبحث أحدهم عن فيلم ضائع، كان قد أخرجه في ستينيات القرن الماضي، ويبحث آخر عن موضع لتصوير فيلم قصير، رحلات البحث تلك تتداخل في مجرى الفيلم، فيما يبقى الفيلم الموعود، مرجأً، ليجيء عند النهاية بعرض أحد الأفلام أمام جمهور، وليجد المخرج فيلمه الضائع، ويخرج الآخر فيلمه القصير.
حيلة الفيلم داخل الفيلم، انبنت هاهنا في مجملها على عوائق موضوعة من قبل الدولة، وفي حال كتلك فبانتفاء الظروف الموضوعية ينتفي جزء من الفيلم، ويستحيل وثيقة بصرية- في هذه الحالة الفيلم تسجيلي، ويجد في جوهره تبرير تمسكه بالتأريخ- لكن هذا لم يقلل من قيمته الفنية، فليس بإمكاننا مطالبة فيلم وثائقي بالصعود نحو الخيال، وإن كان موضوع التوثيق مفتقرا للخيال أو كانت ظروفه تصرعه، فهذا مما لا يد لصانعيه فيه. كما أن بالفيلم القصير المضمن في الداخل تأخذ الصعوبات طابعا يتعلق بمسائل إبداعية وتخييلية، والفيلم في مجمله يرمز لحال السينما السودانية سابقا، أي في كونها محجوبة ومطمورة.
كطفل يرى وجهه في المرآة للمرة الأولى، كانت انفعالاتُالحضور، وضحكات مشوبة بالأسى انطلقت من أفواههم، ضحكات جيل قادم عندما يدرك أن الجيل الذي سبقه قد صارع في سبيل انتزاع حقوق بسيطة، هي الآن ملكه، انتزعها بيده. ماذا؟ هل كانوا يحاولون تحرير العبيد؟ إنهم الآن أحرار.
السينما بطبعها فن جماعي، في صناعتها وفي استهلاكها، ودور العرض تمثل فضاءً سحريا/ تحويليا، لجماعة تتشارك بالضرورة واقعا، ثم تجيء لتتشارك صورته، لتنبني على إثر ذلك فضاءات بصرية حديثة. فلحظة الخروج من السينما والعودة للإدراك المباشر للواقع يصفها رولان بارت بالقول بأنه يشعر بنفسه: “طرياً كقطة نائمة، مفككا إلى حد ما، غير مسؤول، كمن خرج من حالة تنويم مغنطيسي”. وهذا ما ينبغي للفيلم أن يصنعه بنا.
[1]”شرح المعلقات السبع”، للزوزني.
[1]لا استقرار للصورة؛ فالصورة هي في مكان آخر؛ راغبة أبدا في التحول – بدءا من انفصالها عن الشيء ووجودها الآني في الذهن وحتى بحثها عن معادل لها في الواقع مرة أخرى- وفي السينما الموسوسة بوعيها لذاتها ترغب الصورة المتخيلة -في ذهن رائيها بلا شك- في الوجود؛ في أن تعاود الصلة بزمن واقعي عبر بحثها عن أبعادها المفقودة في ارتحالها وتبدلها -من هنا التهامها لمدرَكات الرائي؛ استئثارها بحواسه وصرفها له عما سواها في لحظة الرؤية. أما الكلمة فهي تصف زمنا شعوريا منقضيا.
[1](العمل الفني في عصر الاستنساخ الميكانيكي)، فالتر بنيامين، مقالات مختارة، تر: أحمد حسان.
[1]انظر أيضا القصة القصيرة (سجان اللحظات-الجانب الآخر للفوتوغراف) للقاص يس المك، من مجموعته القصصية (مامدوت، ما يمكن حدوثه)، وفيها تصرع الصورة شخصا مهووسا بتثبيت كل لحظات حياته في الصور.
[1]يقول البحتري في وصف الصور التي رآها بعين خياله داخل إيوان كسرى:
فَكَأَنّي أَرى المَراتِبَ وَالقَومَ إِذا ما بَلَغتُ آخِرَ حِسّي
وَكَأَنَّ الوُفودَ ضاحينَ حَسرى مِن وُقوفٍ خَلفَ الزِحامِ وَخِنسِ
وَكَأَنَّ القِيانَ وَسطَ المَقاصيرِ يُرَجِّعنَ بَينَ حُوٍ وَلُعسِ