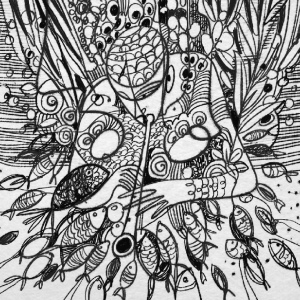يمرُّ السُّودانُ حاليَّاً بفترةٍ مشحونةٍ بكلِّ الاحتمالات المستقبليَّة الَّتي تبدأُ من استشرافِ تحوُّلٍ سلِس لوطنٍ ديمقراطيٍّ معافًى من كلِّ الجراحاتِ لتنتهي إلى إقامةِ دويلاتٍ مفكَّكةٍ من غير رابطٍ بينها سوى المصالح الاقتصاديَّة المتضاربة وما ينشأُ عنها بالضَّرورةِ من نزاعاتٍ بشأنِ الموارد؛ فهل نتوقَّفُ عنِ الكتابة ونترك السِّياسيِّين وشأنهم لِيجِدوا لنا المخارج؛ أم نتملَّى لحظةَ أحمد خير الَّتي أقدَمَ خلالها على محاولةٍ نَدِمَ عليها لاحقاً لإيجادِ صيغةٍ تجمعُ الأطرافَ المتناقضة؛ أم نمضي، بدلاً عن كليهما، في استئنافِ ما بدأناه في مقالٍ سابق حول المرتكزاتِ الثَّقافيَّة في السُّودان؟ لقد وقع اختيارُنا في هذا المقال على انتخابِ الخيارِ الأخير، على أن ننظُرَ لاحقاً إلى لحظةِ أحمد خير لِنشمَلَها بالتَّحليل الَّذي تستحِقُّه، قبل أن نتوقَّفَ تماماً عنِ الكتابةِ في هذا الشَّأن، في حالةِ فشلِ السِّياسيِّينَ المتنازعين في إيجادِ حلٍّ مُرضٍ للمُعضِلةِ السُّودانيَّة.
قلنا في المقالِ السَّابق إنَّ هناك ثلاثَ ركائزَ لإنتاجِ الثَّقافةِ في السُّودان، أُولاها اهتمَّت بالعِلمَيْنِ التَّوأمَيْن: الآركيولوجيا (علم الآثار) والأنثروبولوجيا (علم الإنسان)، وهُما يختصَّانِ بالثَّقافةِ البشريَّة، سواءً كانت فوق سطح الأرض أو تحت الثَّرى، وقد ساهم المستعمِرون الإنجليز في تأسيس لَبِناتِهما الأولى في البلاد، ثمَّ تبعهم أوَّلاً متخصِّصون من خارجِها (على سبيلِ المثال، طلال أسد، تلميذ إيفانز بريتشارد الَّذي تخصَّص في قبيلة الكبابيش بكردفان؛ والبعثات الأمريكيَّة والأوروبِّيَّة الَّتي ساهمت في إنقاذ الآثار بعد تعلية خزَّان أسوان والتَّنقيب عنها جنوب الشَّلال الثَّالث في عدَّةِ مناطقَ في السُّودان)، ثمَّ آلَ الأمرُ أخيراً إلى المتخصِّصين السُّودانيِّين الَّذين يعملون الآنَ في تناسقٍ تامٍّ مع الجامعاتِ الأوروبِّيَّة الَّتي تلقَّوا فيها العِلمَ وتعلَّموا الحرفة؛ إلَّا أنَّ الجهدَ الوطنيَّ لم يتنزَّل من الجامعاتِ إلى المدارسِ الثَّانويَّة، ناهيك عن أن يتغلغلَ في جسدِ الثَّقافةِ الشَّعبيَّة، وإنِ اتَّخذَ لدى القلَّةِ منهم شكلَ انحيازاتٍ لقضايا الإثنيَّاتِ، منظوراً إليها على وفق هدفٍ وطنيٍّ وحدوي.
في بدايةِ السَّبعينيَّات، أي في أعقاب فشل انقلاب الرَّائد هاشم العطا “التَّصحيحي”، بدأنا تعليمَنا فوق الثَّانويِّ في سبتمبر، بعد شهرينِ من الوقتِ المعتاد لفتحِ جامعة الخرطوم، وذلك بعد أن “تفضَّلَ” العقيد جعفر نميري بفتحِها؛ وكان الدُّكتور محمَّد إبراهيم الشُّوش على رأس كلِّيَّة الآداب، وقد أدخلَ وقتئذٍ نظامَ الكورسات، فطُلِبَ منَّا اختيارُ خمسٍ من المواد، من ضمنها الآركيولوجيا والأنثروبولوجيا (إضافةً إلى الفلسفة والمنطق والعلوم والرِّياضيَّات والتَّربية وعلم النَّفس والقانون والعلوم السِّياسيَّة، هذا غير اللُّغات والموادِّ المعهودة، مثل التَّاريخ والجغرافيا)؛ وكان الدُّكتور تاج السِّر حرَّان بشعبة التَّاريخِ مُشرِفاً على طلَّاب السَّنةِ الأولى (البرالمة)، فأصدر منشوراً في لوحةِ إعلاناتٍ بالقربِ من مكتبِه، طالِباً مِنَّا إكمالَ تحديدِ خياراتِ الكورسات في خلال ثلاثةِ أيَّامٍ من تاريخِ المنشور؛ فما كان منَّا إلَّا أن أعلنَّا احتجاجاً داخلَ مكتبِه، قائلينَ له كيف يتسنَّى لنا الخيارُ ونحنُ لا نعرف معنى بعضِ أسماءِ الكورسات (قاصدينَ الآركيولوجيا والأنثروبولوجيا)، ناهيكَ عنِ الإلمامِ ببعضِ جوانبِها. فكان أن تفضَّلَ حرَّانُ بأن جَمَعَ لنا أساتذةً ممثِّلينَ عن كافَّة الشُّعَب، ليعطوا الحاضرينَ بالقاعةِ رقم “102” (“وَن أو تو”) نبذةً مختصرة عنِ الموادِّ الَّتي يتمُّ تدريسُها بشُعَبِهم، فكانَ العرضُ فصلاً مسرحيَّاً باهتاً أشبه بمناداةِ الباعةِ لمشترينَ محتملينَ أمام أكشاكِهم أو متاجرِهمِ الشَّعبيَّة.
بشأنِ الرَّكيزةِ الثَّانية، ننتقلُ في هذه الفقرة من القاعةِ “وَن أو تو” إلى ممثِّلينَ آخَرِينَ، لاعِبِينَ حامِلِينَ لعددٍ من كروتِ “الأتو”، فهُم يُدرِكونَ جيِّداً أنَّ “الدُّو” في أيديهم لا محالةَ رابحٌ أمام “الدَّاما” في لُعبةِ “الويست”، كما أنَّه قادرٌ على تعقُّبِها في لُعبةِ “الهارت”، لكنَّهم من المرجَّحِ غيرُ مُدرِكِينَ للصِّراعِ اللُّغويِّ الَّذي قاد في نهايةِ المطافِ إلى اختيارِ استخدامِ هذه الدَّوالِ (داخلِ الأقواس) الَّتي يعودُ أصلُها إلى صراعٍ فعليٍّ بين إمبراطوريَّتَيْنِ استعماريَّتَيْن. عِلماً بأنَّه مع وجودِ ذلك الصِّراع على المستوى اللُّغوي، تتَّفقُ اللُّغتانِ الإنكليزيَّة والفرنسيَّة في لجوئهما إلى الاستلاف من لُغَتَي إمبراطوريَّتَيْن أوروبِّيَّتَيْن أسبقَ منهما، هما الإغريقيَّة واللَّاتينيَّة، خصوصاً عندما يتعلَّق الأمرُ بالمصطلحاتِ العلميَّة الَّتي تفترِضُ المركزيَّةُ الأوروبِّيَّةُ المهيمنة منذُ رَدَحٍ أنَّهما تصلُحانِ أساساً لاتِّفاقٍ دولي. اتَّفقنا أمِ اختلفنا مع هذه الرُّؤية المركزيَّة، فإنَّ اللُّغة العربيَّة المعاصرة تلجأُ هي الأخرى عن طريق التَّعريب إلى الاستلافِ من ذاتِ المصدرَيْن؛ ومن ثمَّ تمَّ نقلُ المفرداتِ المعرَّبة عن الفرنسيَّة، على أقلِّ تقدير، بواسطة الشَّريك الأضعف في الحكمِ الثُّنائيِّ إلى ساحةِ التَّداولِ اللُّغويِّ اليوميِّ في شمالِ السُّودان. على سبيل المثال، البادئة “تيلي” في اللُّغةِ الإغريقيَّة تعني “عن بُعد”، ويتمُّ استخدامُها في عدَّةِ مصطلحاتٍ في اللُّغتَينِ الإنكليزيَّة والفرنسيَّة؛ فسواءً تمَّ النُّطقُ بالكلمة على الطَّريقةِ الإنجليزيَّة أو الفرنسيَّة، فإنَّ كلمة “تلغراف” تحمِلُ في طيَّاتِها دَلالة الانتقال “عن بُعد”، إضافةً إلى دَلالةِ “تتابعِ الرُّموزِ واندراجِها في نظامٍ كتابي”، وهي الخاصِّيَّة الَّتي سمحت بالانتقال السِّرِّي السَّريع لأخبارِ الحركةِ الوطنيَّة إبَّان حركة “٢٤” وأثناء مجملِ الحَراكِ الوطنيِّ قُبَيلَ تحقيقِ “الاستقلال”، إذ إنَّ عدداً من النَّاشطين الوطنيِّين كانوا وقتئذٍ موظَّفين في مصلحة البريد والبرق، الَّتي تستخدم “شفرة مورس”، وسيلةَ الاتِّصالاتِ (“تيليكوم”) المبكِّرة الَّتي تُسيطرُ عليها الدَّولة قبل أن يتطوَّر جهازُها الآيديولوجيُّ لِيتَّخِذَ صورتَه الَّتي نعرفُها اليومَ؛ ومن سماته البارزة، جهازٌ إعلاميٌّ ضارب وصحفٌ مملوكةٌ للدَّولة وهيمنةٌ أمنيَّةٌ محتملة على خطوطِ الهاتف والفضاءِ الإسفيري.
وعندما أُدخِل “التِّلفزيون” إلى بلادِ السُّودان في بدايةِ السِّتينيَّات، أي بعد بضعِ سنواتٍ من خروج المستعمِر، لم يكن هناك استعدادٌ كافٍ لعمليَّة الانتقال من بثِّ الصَّوت بمفردِه عبر إذاعة “هنا أمدرمان” إلى بثِّه مع الصُّورةِ عبر “تلفزيون جمهوريَّة السُّودان”، لذلك تمَّ الاستعانة بالموادِّ الجاهزة لملءِ الفراغ؛ ولم يكن مستغرَباً أن تأتي تلك الموادُّ ناطقةً بلغةِ الشَّريك الأقوى في الحكم الثُّنائي (في شكلِ برامجَ وأفلامٍ ومسلسلاتٍ مع ترجمةٍ عربيَّة على الشَّريط) أو بلهجةِ الشَّريك الأضعف (في شكلِ برامجَ وأفلامٍ ومسلسلاتٍ من غيرِ ترجمةٍ بالطَّبعِ على الشَّريط). من الملاحظ أنَّه تمَّ تعريبُ الكلمة عن طريق اللُّغة الفرنسيَّة أوَّلاً دون تصرُّفٍ يُذكَر، وليس عن طريق الإنكليزيَّة “تيليفيشن”، ثمَّ صارتِ المفردةُ لاحقاً “تلفازاً” بتصرُّفٍ تقبله العربيَّة، لأنَّه قد تمَّ في هذه المرَّةِ اختيارُ جذرٍ رباعيٍّ للمصطلح [تاء لام فاء زاي]، فأمكَنَ تصريفَه إلى “تلفز يُتلفزُ تلفزةً”، فأصبح من حقِّنا رغم ندرة الاستخدام أن نُشيرَ إلى “التِّلفاز” وأجهزة “التَّلفزة” الخارجيَّة وكاميراتها. وليت نفس المنهج قد تمَّ اتِّباعه مع كلمة “ديمقراطيَّة” ([دال قاف راء طاء] أو [ميم قاف راء طاء]) التَّي نسعى إلى التَّحوُّل إلى مشارفها، إذاً لتحدَّثنا منذُ الآنَ عن “دقرطةِ” المعرفة أو “مقرطتِها”. هذا ولم تشهد أجهزة “التِّلكس” انتشاراً كبيراً، إذِ انحصرت في الاستخداماتِ الاستخباريَّة إبَّان فترةِ الحرب العالميَّة والأنشطة التِّجاريَّة في الفترةِ الَّتي تلتها، قبل أن يتمَّ استبدالُها في الثَّمانينيَّاتِ بأجهزةِ الفاكس الأكثر قدرةً على نقلِ النُّصوصِ المكتوبة والمصوَّرةِ معاً، بالانتقالِ من البنيةِ التَّحتيَّة للتِّلغراف إلى خطوطِ “التِّلفون”. أمَّا الهاتفُ نفسُه، فإنَّه قد شَهِدَ في البدء استخداماً محدوداً، انحصر في الدَّوائرِ الحكوميَّة والبيوتاتِ الكبيرة؛ فيما يشهَدُ الآنَ اختباءً خجولاً للدَّال (“تيلفون”) خلف مفردة “موبايل”، بينما أخذت دَلالتُه تتمظهرُ في شكلِ جوَّالاتٍ بيدِ أفرادٍ عُزَّل، قادرينَ على الوقوف أمام أجهزة الدَّولة القمعيَّة، إضافةً إلى تأهُّلهم وتأهُّبهم لزعزعةِ أجهزتِها الآيديولوجيَّة.
بالنِّسبةِ إلى الرَّكيزة الثَّالثة، وهي أشدُّ الرَّكائزِ الثَّقافيَّة خطراً وأبلغُها أثراً، فإنَّ المواجهة بين المؤسَّساتِ التَّعليميَّة الحديثة والثَّقافاتِ التَّقليديَّة الرَّاسخة قد بدأت بخَشيةٍ وعجرفةٍ مفهومتَيْن، لارتباط التَّعليم الحديث بجحافلِ الغزاةِ من جهة، ولصَلفِ قادتِهم وتعالِيهم على المؤسَّساتِ المنتِجة للثَّقافاتِ المحلِّيَّة من جهةٍ أخرى. ورويداً رويداً، بدأ السُّودانيُّون يُدرِكون أهميَّة التَّعليم الحديث، فأخذوا يَنشَطون في إرساءِ التَّعليمِ الأهليِّ بعيداً عن سيطرةِ المستعمِر، إضافةً إلى بدء رحلاتٍ سرِّيَّة لإيفادِ طلَّابٍ لتلقِّي العلم في مصر. في المقابل، أخذت وزارة الخارجيَّة البريطانيَّة -وليست وزارة المستعمرات- تشرعُ في إرسالِ خرِّيجي أفضل الجامعات لإدارة شؤون المستعمِر في الخرطوم، ممَّا نتج عنه لاحقاً إيفادُ عددٍ قليلٍ من السُّودانيين لتلقِّي العلم في الجامعاتِ البريطانيَّة، بينما أُغلِقتِ المناطقُ الجنوبيَّة وتمَّ إدارتُها من قبل عسكريِّين متعاقدين، كما قامتِ الإدارةُ البريطانيَّة بفتحِ الإقليم الجنوبيِّ للتَّبشير المسيحيِّ والتَّعليم الكنسيِّ وإرسال الطُّلَّابِ إلى جامعة ماكيريري في يوغندا. وعندما نشأ مؤتمرُ الخريجينَ في بدايةِ الأربعينيَّات، بدأ في توسيعِ التَّعليمِ الأهلي ونشرِ الخلاوي وزيادةِ عددها ومناهضةِ التَّبشيرِ المسيحي. وقد كانت بدايةُ المؤتمر قويَّةً، رغم دهاءِ المستعمِرِ وحِنكَتِه، ورغم قِلَّةِ عددِ الخرِّيجينَ وحداثةِ سنِّهم؛ إلَّا أنَّهم سرعانَ ما صاروا بعد تقسيمِهم بمَكرِ المستعمِر وشدَّةِ دهائه لقمةً سائغة بين يدي الطَّائفتَيْنِ الكبيرتَيْن؛ وقد لعبت طبيعةُ الحكمِ “الثُّنائيِّ” دوراً سَلبيَّاً في زعزعةِ أفكارِهم “الوطنيَّة”، ففي لحظةٍ سنُطلِقُ عليها “لحظة أحمد خير”، قَبِلَ ممثِّلونَ عن أحزابِ الحركةِ الوطنيَّة، بشِقَّيْها الاتِّحاديِّ والاستقلالي، في منتصفِ الأربعينيَّاتِ ميثاقاً تمَّ التَّوقيعُ عليه يحتوي أوَّلُ بنودِه على صيغةٍ تصالُحيَّة تسعى إلى: “قيامِ حكومةٍ سودانيَّة ديمقراطيَّة حرَّة في اتِّحادٍ مع مصرَ وتحالفٍ مع بريطانيا العظمى”، سارع رئيسُ المؤتمر في ذلكَ الوقت، إسماعيل الأزهري، بذكائه الموازي لدهاءِ الإنجليز إلى استخدامِ الميثاقِ في جوهرِه العام لتأكيدِ وَحدَةِ الصَّفِّ مع تغييرِ صيغةِ البندِ الأوَّل لتعزيزِ مبدأهِ الاتِّحادي، فأرسل مذكِّرةً إلى رئيسَيْ الحكومتَيْن البريطانيَّة والمصريَّة عن طريق الحاكم العام، تضمَّنتِ القول: (“إنَّ الكلَّ يطلبون قيامَ حكومةٍ سودانيَّة ديمقراطيَّة حرَّة”، كما أنَّهم يطلبون أن تكونَ “في اتِّحادٍ مع مصر” و”في تحالفٍ مع بريطانيا”، غير أنَّ الأحزابَ سكتت عن تعيينِ نوعِ الاتِّحاد؛ أمَّا المؤتمر، فإنَّه رأى أن يكونَ الاتِّحادُ مع مصرَ “تحت التَّاجِ المصري”).
قد يبدو هذا البندُ غريباً في كِلتا صِيغتَيْه (الأصليَّة والمعدَّلة)، إلَّا أنَّ صيغة “الحكمِ الثُّنائيِّ” نفسَها كانت أشدَّ غرابةً، وقد ساهمت وظلَّت تُساهِمُ إلى يومِ النَّاسِ هذا في بلبلةِ أفكارِ المشتغِلينَ بالسِّياسةِ في السُّودان والعازِفينَ عنها على حدٍّ سواء، فلم يكُنِ الاستعمارُ آنذاك (بشقَّيْه الأقوى والأضعف) استعماراً بالمعنى المتعارَفِ عليه، وإن تمَّت بوادرُه في حقبةِ الاستعمارِ الكلاسيكيَّة، الَّتي راح ضحيَّتَها في ساعاتِها الأولى فقط آلافُ الأفراد؛ بل كان استعماراً بالوكالة (“باي بروكسي”)، من غير أن يتَّضحَ جليَّاً مَن كانَ يعمَلُ وكيلاً لِمَن؛ فالحكومةُ البريطانيَّة، ممثَّلةً في وزارةِ المستعمرات، رفعت يدَها عنِ السُّودان، كما أنَّ البرلمانَ البريطانيَّ لم يُقِرَّه مستعمَرةً لحكومةِ صاحبِ الجلالة؛ غير أنَّها تركتِ الأمرَ لوزارةِ الخارجيَّة لتُدِيرَ شأنَه عن طريقِ الضَّغطِ الدُّبلوماسيِّ على القاهرة لِتقبَلَ الامتيازاتِ الأوروبِّيَّة على قناةِ السُّويس؛ من جانبِها، كانت حكومةُ صاحبِ الجلالة ملكِ مصرَ الَّتي كان يُعبِّر عن سياساتِها الأمنيَّة آنذاك الأمير عمر طوسون، رجلُ الإحسانِ ذو الصِّلاتِ الطَّيِّبة بمعشرِ السُّودانيِّين، ترى في جنوبِ الوادي تأميناً دائماً لمصالِحِها الحيويَّة، ولا تُقِرُّ إلَّا بوجودٍ مؤقَّتٍ للبريطانيِّين فيه، وفقط بما يؤمِّنُ لها تدفُّقاً دائماً لمياه النِّيل، وفقاً لِما تمَّ إقرارُه في اتِّفاقيَّة الحكم الثُّنائي. في المقابل، وجدت حكومة الخرطوم نفسَها بما تدفَّق إليها من كادرٍ أكاديميٍّ رفيعٍ محاصرةً بشُحِّ الإمكانيَّات والعوائقِ القانونيَّة الَّتي تمنع الاستفادةَ من صندوقِ تنمية المستعمرات ونقصِ الكادرِ البشريِّ المؤهَّلِ محلِّيَّاً والدُّيونِ المستحَقَّة لسَدادِ تكلفةِ الحملة إلى الخزانةِ المصريَّة، فشرعت في بناءِ المدارس، على قلَّتِها، حتَّى المرحلةِ الثَّانويَّة ونظَّمت تجارةَ الصَّمغ وبدأت في بناءِ السُّدود وإنتاجِ القطن بالزِّراعةِ المرويَّة والمطريَّة على حدِّ السَّواء، إلى أن حقَّقت في بدايةِ الأربعينيَّاتِ نوعاً من “الاستقلال” عن هيمنةِ المندوبِ السَّاميِّ البريطانيِّ في القاهرة. وصادف أن جاءت حكومةُ حزبِ العمَّال في بريطانيا في منتصفِ الأربعينيَّات، فأرست سياسةَ التَّعليمِ المجَّانيِّ والخدماتِ الصِّحِّيَّةِ الوطنيَّة في المركز الكولونيالي، وبدأت تنظُرُ في برنامجٍ تدريجيٍّ لتفكيكِ المستعمَرات؛ فانعكسَ كلُّ ذلك إيجابيَّاً على السُّودان في شكلِ إنشاءِ خدمةٍ مدنيَّةٍ ممتازة وجهازٍ حكوميٍّ خالٍ من الفسادِ المالي ومستشفياتٍ ومراكزَ صحيَّةٍ نظيفة وتعليمٍ مجَّانيٍّ في كافَّةِ المراحلِ الدِّراسيَّة.
ثمَّ جاء الاستقلالُ الَّذي تحقَّقَ سريعاً تحت شعار “تحرير لا تعمير”، وتوالتِ الحكوماتُ الوطنيَّة الَّتي تراوحت بين فتراتٍ ديمقراطيَّة قصيرة وحِقَبٍ دكتاتوريَّةٍ مطوَّلةٍ باطِّراد، لكنَّ “الكلَّ” (بتعبيرِ الأزهريِّ الإجمالي) فشلَ في تحقيقِ الشِّقِّ الأوَّل المضمَّن في البندِ الأوَّل الَّذي اتَّفق “الجميعُ” على تحقيقِه منذُ الأربعينيَّات، وهو “قيامُ حكومةٍ سودانيَّةٍ ديمقراطيَّةٍ حرَّة”، مع تقاعسٍ واضحٍ إبَّان العهود الدِّيمقراطيَّة القصيرة وتصاعدٍ بارزٍ لحجم الدَّمار الَّذي تمَّ إبَّانَ فتراتِ الحكمِ الاستبداديِّ المظلمة، إلى أن “جاء هؤلاء” بهذا النِّظامِ المتعسِّف في نهايةِ الثَّمانينيَّاتِ والَّذي تسعى الثَّورةُ إلى “اقتلاعِه اقتلاعاً” منذُ أربعِ سنواتٍ على أقلِّ تقدير؛ فقد تجسَّدت فيه كلُّ الشُّرور: تسييس أجهزة الخدمة المدنيَّة وتمكين المساندين؛ انفراط وحدة القوَّات المسلَّحة وتغوُّل الجيش على الأنشطة الاقتصاديَّة؛ استشراء الفساد المالي وإصابة القيم الأخلاقيَّة في مَقتَل؛ اندلاع الحروب الأهليَّة وانتشار البؤس في أوساط النَّازحين؛ انهيار نظام العلاج المجَّاني بالمستشفياتِ والمراكزِ الصِّحِّيَّة؛ وبخصوص سياسِاته المتعلِّقة بالرَّكيزة الثَّالثة، شجَّع النِّظام، على المستوى الدَّاخلي، فرضَ ثقافةٍ واحدة، متعاليةً على كافَّةِ الثَّقافاتِ المحلِّيَّة ووظَّفَ مناهجَه التَّعليميَّة للتَّرويج لها لتغطيةِ عيوبِه، من غير أن يكونَ قادراً على تبديدِ رائحتها الَّتي تزكم الأنوف؛ وعلى المستوى الخارجي، استخدمَ النِّظامُ الشِّعاراتِ الدِّيماغوجيَّة بديلاً للدِّبلوماسيَّة الهادئه، ووضع القيم المتَّبعة في مواجهةٍ حادَّة مع القوانين المنظِّمة لحقوق الإنسان، وهلَّل للهجماتِ الانتحاريَّة وأقام علاقاتٍ مع الدُّول الَّتي أقرَّتها، وارتبط بمحور التَّطرُّف والإرهاب واستضافَ قادتَه؛ ممَّا أدَّى كلُّ ذلك إلى إحكامِ عزلةِ النِّظام ووضعِ السُّودان على حافَّةِ التَّصنيفِ كدولةٍ فاشلة. وعندما يتراوح الآنَ دخولُ الأممِ المتَّحدة في شؤونِ البلاد بين الفصلَيْنِ الخامسِ والسَّادس أو يتأرجَّحُ الاتِّحادُ الأوروبِّيُّ بين وقفِ المساعداتِ وإعفاءِ الدِّيون أو تتدخَّل منظَّمةُ الإيقاد لخدمةِ هذا الطَّرف أو ذاك أو تبدأُ دولٌ عربيَّة بعينِها بالشُّروع في لَيِّ الذِّراع، فإنَّ كلَّ ذلك بسبب إخفاقِ الحُكمِ الاستبداديِّ وسَعيِه اليائسِ إلى تمديدِ عُمُرِه بانقلابٍ داخل انقلاب، لِينتهيَ بتوريطِ “الكلِّ” في “نفيرٍ” لتجميعِ أطرافِ ما تبقَّى من قُطرِ السُّودانِ “القديم” أو ضَياعه التَّام في حربٍ أهليَّة شاملة لا تُبقِي ولا تذَر؛ وهو “نفيرٌ” ظاهرُه الرَّحمة وحفظُ البلادِ من التَّفكُّك، وباطنُه الإفلاتُ من العقاب (فهل من سبيلٍ آخرَ للخروجِ من هذه الورطة؟).
قد يُجيبُ الَّذين أدخلونا في هذه الورطة بالنَّفي القاطع؛ وقد يتراوحُ المشاركونَ طواعيةً أو قسراً في الاتِّفاق الإطاري بين النَّفي والإثبات؛ بينما سيمضي الرَّافضونَ له في تقديمِ إجاباتٍ عمليَّةٍ بالتَّظاهرِ اليوميِّ لردِّ الحقوق؛ هذا من النَّاحية السِّياسيَّة الَّتي “تفرِزُ الكيمان”، ولكن على مستوى الرَّكائزِ الثَّقافيَّةِ الثَّلاث، فإنَّ “الكلَّ” مُطالَبٌ ببذلِ جهدٍ جماعي (فِرَق عمل، لجان، سمنارات، مؤتمرات، جمعيَّات متخصِّصة، أكاديميَّات، ومعاهدُ بحوثٍ ودراسات) لوضعِ إستراتيجيَّةٍ ثقافيَّة، أو مراجعتها لديهم إن وُجِدت، لِتُغطِّيَ كلَّ ركيزةٍ على حِدَة، على المدى القصير (بالاتِّفاق مع الآخرين على الحدودِ الدُّنيا في مراحلِ الانتقال، وتضمينِ المتبقِّي في برامجِ الانتخابات) والمتوسِّط والطَّويل؛ بحيثُ تصِلُ علومُ الإنسان إلى مراحل التَّعليم الثَّانوي ويُصبِحُ دراسةُ المجتمعاتِ البشريَّة وحفظُ تراثِها وآثارِها همَّاً يوميَّاً يحمله الأفرادُ العاديُّون في صدورِهم وحدقاتِ أعينهم؛ وبحيثُ يتمُّ الاهتمامُ بكافَّةِ اللُّغاتِ المتداولة، محلِّيَّةً كانت أم أجنبيَّة، وتحرير أجهزة الإعلام من تغوُّل الدَّولة، والعضُّ على حرِّيَّة الصَّحافة والتَّعبير بالنَّواجز، وتنشيط الحركة المسرحيَّة وإعادة فتح دور السِّينما وتخفيف الرَّقابة وتشجيع الإنتاج المحلِّي، وتدريس موادِّ المسرح والموسيقى والفنون التَّشكيليَّة في المدارس الثَّانويَّة بتأهيلِ وتعدُّدِ معاهدِها العليا وتخريجِ أفضلِ كادرٍ للقيام بهذه المهمَّة؛ وأخيراً، بحيث يتمُّ تطوير المناهج الدِّراسية الَّتي تساعد على نفي التَّعارضِ القائمِ بين العلمِ والدِّين وإزالةِ الجفوةِ المفتعلة بين القيمِ المجتمعيَّة وحقوقِ الإنسان، بما يؤدِّي إلى تقليلِ التَّشدُّد واجتثاثِ التَّطرُّف واستئصالِ شأفةِ الإرهاب. على ألَّا يُترك كلُّ ذلك إلى أهواءِ “الخبراءِ الإستراتيجيِّين” الَّذين يعملون بمفردِهم، وبما تقتضيه نزواتُهم الذَّاتيَّة أو وفقاً للجهةِ الَّتي تدفع لهم أكثر.