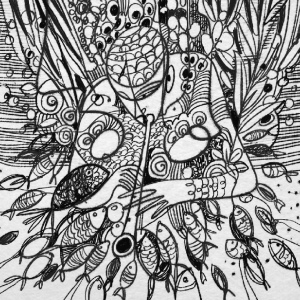طالَبَنا أكثرُ من صديقٍ بتوخِّي التَّبسيط فيما نطرحُ من موضوعاتٍ مهمَّة، حتَّى يصِلَ فحواها لأكبرِ قدرٍ من القرَّاء والمتابعين الَّذين يُعانون الأمرَّين في سعيهم ليفقهوا عنَّا ما نقول. ومع تفريقِنا الضَّروريِّ بين التَّبسيطِ المرفوض والبساطةِ المأمولة، واقتناعنا في ذاتِ الوقتِ بأن لا شيءَ بسيطاً على ظهرِ هذه البسيطة إلَّا في خيالِ الشُّعراء، سنحاولُ الاقترابَ حثيثاً من الماء؛ فهو، كما يُظَنُّ، بسيطٌ ولا يُمكِنُ تفسيرُه إلَّا بنفسِه، مثلما جاء في المثلِ السَّائر: “بعد جُهدٍ جهيدٍ، فسَّر الماءَ بالماءِ”، أي توصَّلَ بعد عناءٍ فكريٍّ إلى تحصيلِ حاصلٍ (“توتولوجي”)، من غير أن يُضيفَ محتوًى جديداً إلى المفهوم المُراد تفسيرُه؛ أو كما جاء في وصفِ محمود درويش لصديقِه راشد حسين في قصيدة “كانَ ما سوفَ يكون”، حيثُ قال الشَّاعرُ الرَّاحلُ عن صديقِه الرَّاحل: “سهلاً كان كالماءِ بسيطاً .. كعشاءِ الفقراء”. فهلِ الماءُ بالفعلِ سهلٌ أو بسيطٌ كما يُظَنُّ في الفهمِ الشَّعبيِّ الشَّائع؟
من أبرزِ العلاماتِ على أنَّ الماء ليس بسيطاً كما يُعتقَدُ هو أنَّه جزيئٌ (“مولَكِيول”) مكوَّنٌ من ذرَّتَيْ هيدروجين وذرَّة أُكسجين، وهو لا يبدو للعيانِ إلَّا بوجودِ عددٍ لا يُمكِنُ إحصاؤه من تلك الجزيئاتِ المركَّبة؛ هذا إضافةً إلى أنَّ كلَّ ذرَّةٍ منهما مكوَّنةٌ من نواةٍ وإليكترونات (إلكترون واحد للهيدروجين وثمانية إلكتروناتٍ للأُكسجين)، وأنَّ كلَّ نواةٍ مكوَّنةٌ من بروتوناتٍ ونيوتروناتٍ مساوية لعددِ الإلكترونات، ومخالِفةً لها في حالةِ الآيسوتوبات؛ وهي بدورِها مكوَّنة من عددٍ من الكوارتز. وفي القرءان، تبرُزُ نفسُ الصُّعوبةِ في عددٍ من الآياتِ الَّتي يتمُّ فيها ذِكرُ الماء. على سبيل المثال، “وكان عرشُهُ على الماء”؛ سورة “هود”، الآية رقم “٧”؛ وفي سورةِ “الأنبياء”، الآية رقم “٣٠”: “وجعلنا من الماءِ كلَّ شيءٍ حيٍّ”؛ فالأولى، يحتاجُ احتمالُ فهمِها إلى استدعاءِ علمِ الفيزياء من أوَّلِه إلى آخرِه، بينما لا تُدرَكُ الثَّانية إلَّا بفهمٍ ثاقبٍ من علمِ الأحياء.
إلَّا أنَّ للماءِ المُدرَكِ بالحواسِّ أربعَ وظائفَ رئيسيَّة، تشمل حَملَ السُّفُنِ الَّتي تمخرُ البحرَ وتشقُّ عُبابَه: “ولهُ الجَوَارِ المنشآتُ في البحرِ كالأعلامِ” (سورة “الرَّحمن”، الآية رقم “٢٤”)؛ كما تشمل مياه الشُّرب والتَّنظيف، وريَّ المشاريع الزِّراعيَّة، ومحطَّات توليد الكهرباء. وسنحاول في هذا المقال أن نتتبَّعَ الماءَ عبر وظائفِه الأربع، مثلما تمَّ تتبُّع المالِ في فيلم: “كلُّ رجالِ الرَّئيسِ” (“أوول ذا بريزيدانتس مِيْنْ”)، بنصيحةٍ من “دِيْبْ ثرُوْتْ” (“ذي الحُلقُومِ العميق”) لبطلَيْ الفيلم الَّذي وثَّقَ لفضيحة “ووترغيت” الَّتي أطاحت بالرَّئيس الأمريكي السَّابع والثَّلاثين ريتشارد نيكسون في عام ١٩٧٤، وهُما الصّحفيَّان بوب وودوورد (روبرت ريدفورد) وكارل بيرنشتاين (دَستِن هوفمَن). وقد أصبحتِ النَّصيحةُ المقدَّمة للبطلَيْن من المُخبِرِ السِّرِّيِّ “دِيْبْ ثرُوْتْ” مثلاً سائراً يفتحُ مغاليقَ الاقتصاد ببساطتِه الآسِرة: “فُوْلُوْ ذا مَنِي”، حتَّى أنَّ كتاباً من تأليفِ الخبيرِ الاقتصاديِّ بول جونسون صدر في ٢٣ فبراير الماضي حامِلاً نفسَ العنوان لتحليلِ الأوضاعِ الماليَّة في بريطانيا وتتبُّعِ التِّرليون جنيه إسترليني الَّتي يتمُّ صرفُها لإدارة اقتصاد البلاد.
من جانِبِنا، لن نستبدِلَ عبارة “تتبَّعِ المالَ” بعبارة “تتبَّعِ الماءَ” فحسب، وإنَّما سنرفِدُها كذلكَ بقولِ “مريمَ” لمحبوبِها في آخرِ رواية “مريود” للرِّوائيِّ السُّودانيِّ الكبير الطَّيِّب صالح: “آيتُكَ ماء، آيتُكَ ماء؛ آيتُكَ أن تظلَّ يقظانَ إلى آخرِ العهد”، فالماءُ بوظائفه الأربع هو دليلُنا لفكِّ طلاسم “الحُكمِ الثُّنائيِّ” الَّتي استعصت طيلةَ الوقتِ على السِّياسيِّين والمؤرِّخين على حدٍّ سَواء، كما أنَّ بساطة العبارة وسهولة تذكُّرِها ستُعينُنا في نهايةِ المطافِ على محورةِ التَّحليلِ حول الماء، إضافةً إلى أنَّ عبارة “مريمَ” المائيَّة ستُعزِّز الفكرة وتقودُ إلى توطينِ العبارة، لِتَحِلَّ محلَّ عبارة “تتبَّعِ المال”. وعندما نقول “تتبَّعِ الماءَ”، فإنَّنا نُشيرُ من جانبٍ إلى قناةِ السُّويس بوصفِها ممرَّاً مائيَّاً يُسَهِّلُ حركة السُّفُنِ بين البحرَيْن الأحمرِ والأبيضِ المتوسِّط ومنهما إلى المحيطاتِ الواسعة، ومن جانبٍ آخرَ إلى نهرِ النِّيلِ بوصفه مجرًى مائيَّاً يُوفِّرُ مياهَ الشُّربِ ويدعمُ وسائلَ الرَّيِّ ومشاريعَ توليدِ الكهرباء. وحول هذين المسطَّحَيْنِ المائيَّيْن، سنسعى إلى تقديمِ تحليلٍ موجزٍ يُساعدُ على إماطةِ اللِّثامِ عن تلك الشَّراكةِ الدِّبلوماسيَّةِ الغريبة الَّتي جمعت بين مستعمِرٍ ومستعمَرٍ في نهايةِ القرنِ التَّاسعِ عشر، فقادتهما إلى غزوِ أرضٍ لم يُعرَف عن ظاهرِها أو باطنِها وقتئذٍ غِنًى لأهلِها أو ثرواتٌ يسيلُ لها لُعابُ طامعٍ أجنبي، ناهيكَ عن طامِعَيْن اثنين.
انحصر الصِّراعُ بين الفرنسيِّين والإنجليز إبَّان القرن التَّاسع عشر حول السَّيطرة على أمواج البحارِ والمحيطاتِ المؤدِّية إلى مستعمراتِهما في جزر الهند الشَّرقيَّة. وعندما سيطرت إنجلترا على رأس الرَّجاء الصَّالح في عام ١٧٩٥ وضَمِنَت تنظيم حركة سُفُنِها من وإلى الشَّرق، غزا نابليونُ مصرَ لِيضمَنَ طريقاً أقصرَ إلى الشَّرق، كما أنَّه فكَّرَ في شقِّ قناةٍ تصِلُ البحرَ الأبيضَ بالأحمر، إلَّا أنَّ نقصَ معلوماتٍ حول مستوياتِ الارتفاع قد أجَّل تنفيذ المشروع. ومع أنَّ مئةَ عامٍ تفصِلُ بين حملة نابليون على مصر (١٧٩٨) وحملة كتشنر على السُّودان (١٨٩٨)، إلَّا أنَّ كلتاهما تمحورتا حول الماء: مياه البحر ومياه النِّيل. كان نابليون مدرِكاً لأهمِّيَّة مصر كطريقٍ مائيٍّ إستراتيجيٍّ يربط بين الغرب والشَّرق، خصوصاً عند اكتمالِ شقِّ القناة؛ ولكنَّه كان يُدرِكُ أيضاً أهمِّيَّة النِّيل في حُكمِ مصر، وقال في ذلك قولته المشهورة: “ليس في العالم قطرٌ واحد كمصرَ تستطيعُ أن تُسيطرَ على رعاياه سيطرةً تامَّة عن طريقِ النِّيل. ومع الإدارةِ الرَّشيدة، يمكن للنِّيلِ أن يُسيطرَ على الصَّحراء؛ أمَّا تحت الإدارة الفاشلة، فإنَّ الصَّحراء هي الَّتي تطغى على النِّيل”. أمَّا كتشنر، فإنَّه لم يأتِ إلى السُّودان في الأساس إلَّا وفقاً لترتيبٍ دبلوماسيٍّ يتمُّ بمقتضاه استمرار الامتيازات الأوروبيَّة على قناة السِّويس الَّتي تمَّ لاحقاً شقُّها وافتتاحُها رسميَّاً في عام ١٨٦٩؛ كما أدرك أيضاً أهمِّيَّة النِّيلِ في الوصولِ إلى البلاد أوَّلاً، وفي السَّيطرة بعدئذٍ على أصقاعِها النَّائية ببسطِ الهيمنةِ التَّامَّة على مقرنِ النِّيلين.
لم يمكث نابليونُ في مصرَ سوى ثلاثِ سنوات، قبل أن يتمَّ طردُه منها بواسطة قوَّات الإنجليز بالتَّعاون مع الأتراك العثمانيِّين، إلَّا أنَّ الأثرَ الثَّقافيَّ لفترةِ حُكمِه ظلَّ مستمرَّاً حتَّى الآن، حيثُ وصَلَ إلى السُّودان عن طريق الإشعاع الَّذي أحدثه الشَّريكُ الأضعفُ في الحكمِ الثُّنائي. وما ذلك إلَّا لأنَّ نابليونَ قد حرص منذ البدءِ على مصاحبةِ عددٍ من العلماء للحملة على مصر، كما حمل معه مطبعةً على ظهر السَّفينة “الشَّرق” ( “لوغيا’ن‘”)؛ وفي عهدِه القصير، تمَّ تأسيسُ المجمعِ العلميِّ وصياغةُ عدَّةِ مشاريعَ لإحصاءِ السُّكَّان ووضعُ خريطةٍ دقيقةٍ للبلاد، وبدأت خطواتٌ جادَّة في دراسة آثارِ مصرَ وعاداتِ شعبِها وفكِّ رموز اللُّغة الهيروغليفيَّة، بعد العثورِ على “حجر رشيد”. في المقابل، لم يبدأ الاهتمامُ بالعملِ الثَّقافيِّ الشَّامل من جانب المستعمِر الإنجليزيِّ في السُّودان إلَّا في عهد دوغلاس نيوبولد في نهاية الثَّلاثينيَّات، بينما تمَّ ملءُ الفراغِ الثَّقافيِّ طيلةَ تلك الفترةِ بواسطة الشَّريكِ الأضعف (مصر)، الَّتي لم يكن لها تأثيرٌ يُذكَر في الجوانب الحيويَّة الأخرى للدَّولة، سوى الإشرافِ على إدارة الرَّي، وفقاً لاتِّفاقيَّة مياه النِّيل لعام ١٩٢٩ (والَّتي تمَّ إكمالُها لاحقاً في عام ١٩٥٩)؛ وهو السَّببُ الَّذي جاء بها في الأساس للمشاركة في الحكم، وقد ظلَّ هذا الإشرافُ قائماً حتَّى بعد خروجِ الإنجليز من السُّودان، ممَّا سهَّلَ عليها الأمرُ حينَما جاء إبَّانَ العهدِ الوطنيِّ مشروعُ تهجيرِ النُّوبيِّين، توطئةً لتعلية سدِّ أسوان، لضمانِ الاستفادة القصوى من مياهِ النِّيلِ في مصرَ في ريِّ المشاريعِ الزِّراعيَّة وتوليدِ الطَّاقةِ الكهربائيَّة.
لم يكنِ النِّيلُ إذاً مسطَّحاً مائيَّاً لتسهيلِ النَّقلِ للغزاةِ من الشَّمالِ فقط، وإنَّما كان وسيظلُّ كذلك عمقاً إستراتيجيَّاً لمصرَ، خصوصاً إذا نظرنا للوظائفِ الأخرى للماء، والتَّي تشمل، كما ذكرنا آنِفاً، مياه الشُّرب والتَّنظيف، وريَّ المشاريع الزِّراعيَّة، ومحطَّات توليد الكهرباء. وهذا هو مربطُ الفرس؛ فبدونِ التَّمعُّنِ في هذا الأمر، لا يُمكِنُ فهمُ تاريخِ السُّودانِ الحديث، بدءاً من حملة نابليون، الَّتي أورثتنا بطريقةِ الإشعاعِ الثَّقافيِّ عن بُعدٍ أثراً من لسانٍ فرنسي؛ مروراً بالحكم الثُّنائيِّ، الَّذي خلَّف لدينا طائفةً من المثقَّفينَ مُبدِّلي الشَّفرةِ (“كود إسويتشرز”)، أي الَّذين يتنقَّلون كيفما اتَّفقَ بين شَفرةٍ لغويَّةٍ إلى أخرى (وهي في الغالب، بين العربيَّةِ والإنكليزيَّة)؛ وانتهاءً بالوضعِ الرَّاهن، الَّذي يتعقَّدُ أكثرَ بقبولِ الدَّعوةِ إلى تبسيط الأمور، في حالةِ وجاهتِها الظَّاهريَّة. فمع تشييدِ سدِّ النَّهضة والتَّلويحِ ببناءِ قاعدةٍ روسيَّة على البحرِ الأحمر والتَّدخُّلِ السَّافر لأجهزةِ الاستخباراتِ المصريَّة في الشُّؤون الدَّاخليَّة للبلاد، تسقطُ كلُّ دعاوى التَّبسيط أو التَّهريج أو “التَّحليل الإستراتيجيِّ” المتعجِّل. ويُصبِحُ العملُ السِّياسيُّ الحكيم والاستخدام الصَّبور للمَلَكاتِ الفكريَّة والتَّعميق الدَّائم للقدرات الثَّقافيَّة هو مطلوبُ الحركة الجماهيريَّة الَّتي تسعى إلى تأسيس حكمٍ ديمقراطيٍّ مُستدام، حتَّى في ظلِّ حدَّة المعاناةِ اليوميَّة الطَّاحنة وتسلُّطِ الحكَّامِ المستبدِّينَ بالحُكم وتستُّرِهم على اتِّخاذِ القراراتِ المصيريَّة؛ فالعهدُ الدِّيمقراطيُّ، كما أثبتتِ التَّجاربُ، لا يدومُ إلَّا إذا تمَّ منذُ الآن اتِّخاذُ الحَيطةِ اللَّازمة بالحفاظِ على حُسنِ الجوار، وتطويرِ العملِ الدُّبلوماسيِّ الدَّاخليِّ والخارجي، وإنشاءِ المراكزِ الثَّقافيَّةِ والإستراتيجيَّة المتعدِّدةِ المشاربِ والهويَّات، وعدمِ الاستهوانِ بالتَّحصيلِ الأكاديمي، مهما علتِ الأصواتُ المشحونةُ بالتَّذمُّرِ والإحباط، والمناديةُ دونما تشعرُ بالاكتفاءِ بسَقَطِ المتاعِ الفكري.
في الختام، يجدرُ التَّنبيهُ بأنَّ الشَّاعرَ الإنجليزيَّ صمويل كولريدج عندما قال على لسانٍ بحَّارٍ عجوزٍ يرتادُ الأمواجَ في رحلةٍ استكشافيَّة، بحثاً عن أرضٍ بِكر: “ماءٌ وماءٌ في كلِّ مكان، وليس في الأفقِ ثمَّةَ قطرةٌ للشُّرب”، فإنَّه كان يُشيرُ بشكلٍ واضح إلى انعدامِ وظيفةٍ أساسيَّة للماء (وهي ماء الشُّرب) مع توفُّرِ وظيفةٍ أخرى له (وهي حَملُ المركباتِ الضَّخمة على موجِ البحار)؛ بينما يؤكُّدُ الشَّاعرُ العربيُّ طرفة بن العبد على وظيفةِ الشُّربِ في حالتَي انعدامِ الماءِ وتوفُّرِه معاً بقولِه على لسانِ عاشقٍ يشكو قربَ محبوبٍ وبُعدَه في ذاتِ الآن: “كالعيسِ في البيداءِ يقتلُها الظَّمأ؛ والماءُ فوق ظهورِها محمولُ”. وعندما نرفع شعار: “تتبَّعِ الماءَ”، فإنَّنا نهدفُ إلى إيجادِ وسيلةٍ سهلةٍ وبسيطة تُعينُ على فهمِ تاريخِنا الحديث وواقعِنا المعاصر؛ أمَّا حينما نرفِدُها بعبارةِ “مريمَ” لمحبوبِها مريود: “آيتُكَ ماءٌ وأن تظلَّ يقظانَ إلى آخرِ العهد”، فإنَّنا نرمي بذلكَ إلى تنبيهِ الواقفينَ على حراسةِ التُّرعِ الرَّئيسيَّة وخزَّاناتِ المياه وساقيةِ جَدِّي بابكر عبد القادر بالجزيرة إسلانج (وإلى حُرَّاسِ التُّروسِ وقادةِ صفوفِ المظاهراتِ السِّلميَّة) باتِّخاذِ الحَيطةِ والحذر، فالدَّربُ طويلٌ والماءُ عزيزٌ مع طولِ المَسيرِ ووُعُورةِ سِكَّةِ السَّفر.