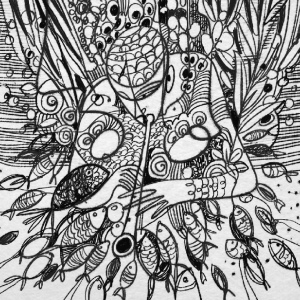نقاش سابق حول مستقبل حكومة الشراكة بين العسكريين والمدنيين.. جرى مع: ميسون النجومي، ولاء صلاح، د. قصي همرور، عمار جمال. نشر في مجلة (الحداثة السودانية 2021).
أعده: حسام هلالي
بعيداً عن الخطط التنفيذية والإجرائية لتأسيس سلطة انتقالية يسود انقسام وسط الرفاق الداعين والراغبين في التغيير. هناك من هو رافض للمساومة السياسية مع رموز المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبار ذلك تنازلاً مُجحفاً عن شعارات الثورة. وبالمقابل، هناك قبول متفاءل للاتفاق باعتباره أفضل ما يمكن الوصول إليه لحل سلمي لعملية التحول الديمقراطي.. إذن، بين هذا وذاك، كيف تمضي الفترة الانتقالية؟
منذ توقيع الاتفاق النهائي على الوثيقة الدستورية في ١٧ أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبتشكيل مجلس للسيادة انصهرت فيه عضوية المجلس العسكري بخمسة أعضاء إضافة إلى ستة من المدنيين. جاء تكليف الاقتصادي والمسؤول الأممي السابق د.عبد الله حمدوك بتشكيل أول حكومة مدنية منذ اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨م.
ووسط حالة غليان عامة في الشارع السوداني جاءت نتيجة للانهيار الاقتصادي وانغلاق الأفق السياسي الذي كان من أهم شرارات الثورة ضد نظام ثورة الإنقاذ الوطني ورئيسه عمر البشير، بجانب اشتعال العديد من الأزمات الجديدة والمتجددة: السيول والفيضانات، الاقتتال الأهلي في بورتسودان، أزمات الوقود والخبز، اختفاء السيولة النقدية في المصارف… إلخ؛ مع بقاء كثيرٍ من التحديات الخطيرة التي تواجه عملية الانتقال السياسي السلمي في السودان، مثل قضايا الحرب الأهلية والسلام، إعادة هيكلة جهاز الدولة الموالي لنظام الإنقاذ، وبالطبع التهديد الأخلاقي الأكبر الذي يواجه مطالبات القصاص العادل من كل مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والمتظاهرين السلميين طوال فترة التظاهرات في مختلف ولايات السودان والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذين تحول المتهمون به ومتحملو المسؤولية من متخذي القرار طوال الفترة الانتقالية الأولى إلى شركاء في السلطة الجديدة مع قادة الحراك الثوري.
بناءً على هذا، وبعيداً عن الخطط التنفيذية والإجرائية لتأسيس سلطة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، ساد انقسام مرير واستقطاب وسط رفاق الأمس القريب من الداعين والعاملين أو الراغبين في التغيير. بين رافض متشائم من المساومة السياسية مع رموز المؤسسة العسكرية والأمنية (الجيش وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن والشرطة)، باعتبارها تنازلاً مجحفاً عن شعارات الثورة، وبين قبول متفائل للصورة التي يمثلها الاتفاق كأفضل ما يمكن الوصول إليه لحل سلمي لعملية التحول الديمقراطي السلمي، رغم شبهات المحاصصة السياسية بين مكونات الحراك الثوري ورفض قطاعات مؤثرة فيه من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المتشككة وغير الواثقة في النخبة الجديدة / القديمة.
في هذا النقاش القصير سنطرح مجموعة من الأسئلة المتصلة بهذا السياق، محاولين الوصول إلى أكثر من إجابة لهذا المأزق الأخلاقي والفكري.
سألتُ الكاتبة والمدونة ميسون النجومي: بداية هل ترين هذه المقاربة سليمة؟
ميسون: المقاربة سليمة، لا مفر من ذلك، ولن تجد منطقة وسطى بين الموقفين يضع المرء فيها نفسه ليخرج من مأزق الانتماء الحاد لأحد الطرفين، موقف الرافضين المتشائمين والمتفائلين البراغماتيين، ويتأرجح الواحد بينهما. فلكلا الكتلتين أرض صلبة يقفون عليها. من جانب: أي أمان للدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والآلة القمعية التي ما زالت بعافيتها؟ ومن جانب الكتلة الثانية: لا يمكن استبعاد الحركة الفوارة والنابهة لتجمعات الشباب في لجان الأحياء، التي لا أدري إلى أي مدى يمكن الرهان عليها.

الناشطة السياسية ولاء صلاح، الرئيسة الأسبق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم:
لا أعتقد أن المقاربة / التقسيم سليم. الملحوظ أن هناك اتفاقاً على عدم الثقة في المنظومة الأمنية، وأنها امتداد للنظام القديم. الاختلاف الأساسي ليس بين الأمل والتشاؤم، بل بين الجذرية والبراغماتية في التعامل مع هذا الواقع. لو سألت عبد الله حمدوك نفسه لقال لك إنه لا أمان للعسكر، لكن “لم يكن بالإمكان أفضل مما كان”، ولو سألتني لقلت إن الثورة كانت ثورة لتطويع غير الممكن والوصول إلى شجرة منتهى أبعد ما تكون مما كان. هناك تفاؤل حذر، وأيضا هناك رفض. لكن الواقع يقول إن ثمة اصطفافاً حاداً بين الرفاق.
الكاتب والباحث في مجالات البيئة والتكنولوجيا الدكتور قصي همرور:
باختصار، يبدو لي أن هذا الاتفاق مصيره الفشل، أو قل إنه سيفشل بنسبة 95%، وسنترك النسبة الباقية (5%) لاحتمالات أخرى مفاجئة. حالياً أبدى الناس فرحهم فيما يشبه (فترة عسل) مبنية على ذاكرة سمكية وافتراض ثقة لا يستند على أي أسس واقعية، بل الواقع يصرح بعكس هذا الافتراض. وفي حالة النشوة والانشراح الـ (يوفوريا) بمناصب الحكم، التي تبدو كأنها أعطت المدنيين وأطياف المعارضة جزءاً من السلطة، لا يرغب الناس في الانتباه إلى أي صوت يحمل التشاؤم. وبشكل عام، دخلنا الآن، وبشكل رسمي، في أحد المسارات التي كانت مفتوحة أمامنا، وبالطبع لا يمكن الدخول في المسارات كلها. إن الانشغال بتفاصيل بنود الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري مفهوم؛ فالبعض تهمهم هذه التفاصيل. وكذلك الانشغال بمآلات وحدة أو فرقة قوى الحرية والتغيير، وكذلك الانشغال بتكوين المجلس العسكري وتناقضاته الداخلية التي تمثّل قنبلة موقوتة. هذه التفاصيل لها أهميتها على أي حال.
بالنسبة لبعضنا، ما نشهده في السودان هذه الأيام يدخل ضمن ما يمكن، وينبغي، رؤيته بعين الطائر المحلّق الذي يشاهد جميع الأفواج والأنماط بصورة عامة، وخطوط سيرها بصورة عامة كذلك، مع قلة الانهماك في التفاصيل داخل كل فوج ونمط. الصورة الكبيرة، هنا، صورة تراكم تاريخي عام، يكاد يفصح عن نفسه بنفسه، في معظم جوانبه.
هل يمكن أن يستمر الاتفاق لمدة السنوات الثلاث المذكورة، وكما هو مرسوم؟ الإجابة المعقولة هي “إمكانية ضعيفة جداً، لكن ربما”، باحتمال 2 إلى 4 من مائة. وهذه النسبة الصغيرة هي فقط لاعتبار أن دراسة التاريخ عموماً لا تخلو من مفاجآت تتجاوز نتائج القراءة والتقدير الموضوعي. وهل يمكن أن تبقى قوى الحرية والتغيير متحدة في المستقبل المنظور؟ الإجابة تشبه سابقتها. وهل مكوّنات المجلس العسكري قادرة على إدارة دولة، إدارة تستوفي الحد الأدنى لمعنى الإدارة، وإن كانت إدارة ظالمة ومتسلطة وفاسدة؟ نفس الإجابة كذلك. (مثلا أرى أن ما يسمى بالدعم السريع، ورغم جبروته وخطورته المشهودة، تكوين هش جداً، ولا يعيش كثيراً بطبيعته، كما ليست لديه قدرة امتصاص الصدمات التي يحتاج إليها أي تنظيم طويل الأجل). لذلك، من الحكمة استثمار الوقت والطاقة، لدى بعضنا، في التهيّؤ للسيناريوهات الأخرى، ومطالب الاستعداد لها، نظريّاً واستراتيجيّاً، ومنذ الآن. التفكير والتخطيط في ذلك الاتجاه له عدة أبواب، وقائمة أولويات، لا أولوية واحدة.
باختصار، نحن إزاء تحالف بين جهات متعددة ومتناقضة ومتضاربة المصالح، وليست لديه مقوّمات الاستدامة. قوى الحرية والتغيير مليئة بالتناقضات، وكذلك المجلس العسكري. وكلاهما لديه منظور للسلطة مختلف. ولو نظرنا بعين نقدية حصيفة، فإن ما حدث عبث أكثر من كونه اتفاقاً سياسياً تاريخياً.

الكاتب والمترجم عمار جمال:
لتكن البداية هي القناعة بأنه لا توجد إجابة أبداً، ففي نهاية الأمر سنقع في فخوخ الآراء. لكن علينا طرح السؤال السليم، والذي تتمثل مهمته في جعل الأمر مثيراً.
بالنسبة لي سيكون السؤال حول ماهية المشاعر السياسية التي تثيرها الأطروحات المتوفرة. لذلك ليس التناقض بين نزعة عمليانية وأخرى راديكالية، بل بين هاتين النزعتين في كفة، ورؤية أخرى ترى أن هذا التناقض زائف، ونرغب، بالتالي، في البحث عن التناقض الأصيل، التناقض الهيجلي. سيبقى السؤال الأساسي من شقين: كيف نبدع أدوات جديدة لتحليل المشكل السوداني؟ ثم كيف نخلق، أكرر نخلق، فاعل التغيير؟ نحتاج إلى رؤية ترى في السياسة ليس مجرد الانخراط في الشأن العام، بل إيروتيكية تهدف لخلق مشاعر سياسية جديدة. وفي هذا سيكون الواقع على الدوام أخضر. نعم أرى في الماثل قدرة كبرى لإنتاج دولة تتيح وتوفر الخدمات لجميع مواطنيها؛ نعم أرى في الكثرة المتضاعفة للثوار وكيلاً لا مثيل له لإنتاج الفردوس السياسي.
ميسون: أنا لا أستطيع قياس الأمر إلا بالمعطيات. منذ البداية، وبالنسبة لي، شكل غياب خارطة طريق تدعم الخيار الثوري المعضلة الأساسية للثورة. بل وجود خارطة طريق كان من شأنها أن تحدد معالم الخطاب الثوري الذي كان عظيماً، ولكنه فضفاض. وجود خارطة طريق واضحة وقوية وصريحة كان من شأنه أن يوضح التنازلات والتضحيات اللازمة من أجل المضي قدماً لتحقيق مطالب الثورة. ذلك الخطاب الذي يتجاهل المصالح الدولية والمستعد لمواجهة خيار العزلة الذي قد يتطلب مزيداً من الفداء. حتى قرار العصيان العام، والذي كان عظيماً، لكن كان لا بد أن يحدد معالم العصيان. نعم قد يستمر العصيان لأشهر أو أسابيع، بتبعات مكلفة، لكن من شأنه تقوية جبهة النضال. لم أتوقع من أي جهة أن تتصدر لمثل هذا الخطاب، ولا حتى تجمع المهنيين السودانيين (ولا أرى أن خطابه قد تم اختطافه بواسطة قوى الحرية والتغيير)، لكنه قدم خطاباً على مقاسه. ومن أجل النصر الكاسح الغالب الذي يفرض شروطه، كان لا بد من الإعداد للهزائم المؤلمة السحيقة في درب ذلك الانتظار. لكن بدا أن الجماهير رهنت حراكها بانحياز القوة المسلحة إليها، وسرعان ما تبين فشل ذلك الخيار (وكان أيضاً كرَمْيَةِ نردٍ على طاولة قمار – بعكس أكتوبر وأبريل اللتين كانتا قد أعدتا العدة لانحياز الجيش؛ فمؤسسة الجيش في عهد الإنقاذ مؤسسة معزولة عن القوى السياسية ومعرفتها بها قليلة). الوضع بعد اتضاح فشل خيار انحياز الجيش هو أن الثورة لم تجد خطاباً جاهزاً ومُعَدَّاً سوى خيار التفاوض. التفاوض وحسب، وليس التفاوض أو التصعيد كما ادعت القوى السياسية. إذ ما الذي كنّا نعنيه بالتصعيد، التصعيد تجاه ماذا؟ لم يكن هناك مشروع تجاه “التفاوض الأفضل الأحسن المرضي عنه”. الدرب مفتوح الآن لبناء الجبهة التي تستطيع مواصلة خيار الثورة، من لجان أحياء ونقابات. وأعتقد أن هناك سعياً إلى هذا التوافق والاتجاه إذا لم يتم قطع الطريق أمامه بالخطاب المطمئن والراكن للإنجازات المؤملة من الحكومة المدنية. في رأيي، كل ما بوسع هذه الحكومة هو منح الثورة هدنة ظاهرية ومحدودة من الدم، تمكنها (إن استثمرته استثماراً صحيحاً) في بناء تلك الجبهة.

ولاء صلاح: السؤال بالنسبة لي: هل سيستمر هذا الزخم الثوري في ظل العملية السياسية الحالية؟ أغلب الظن، لا. أرى العملية السياسية كمخرج للمجلس العسكري الذي يمتلك فقط، وحتى الآن، السلاح والمال وبعض التحالفات الإقليمية الهشة. منذ اليوم الأول لبداية التفاوض كان المجلس العسكري محدداً وواضحاً، فيما يريد: وزارات الدفاع والأمن، وتمثيل محدود للمدنيين في مجلس السيادة. ما الذي حدث بعد ثلاثة شهور؟ حصل المجلس العسكري على الدفاع والأمن ومساحة واسعة في مجلس السيادة تمكنه من السيطرة على مسار العملية السياسية، بينما تنشأ حكومة “مدنية” تعمل سكرتارية تنفيذية (حسب وصف عضو فريق التفاوض لقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني سابقاً). ما حدث هو بالضبط ما طالب به المجلس العسكري منذ اليوم الأول. السؤال هو: ما الذي يريده المجلس العسكري (الواضح أنه الجهة الوحيدة التي تمتلك خطة واضحة)؟ يفتقر المجلس العسكري، كما نظام البشير، لرأس مال اجتماعي وسياسي يحمي الاقتصاد الريعي المعتمد عليه. فرصة المجلس العسكري الوحيدة تكمن في تراكم رأس المال من خلال فشل الحكومة المعينة (وهو النتيجة الحتمية أو الغالبة كما قال قصي همرور). وأي خصم من رصيد قوى الحرية والتغيير (دون وجود بديل ثوري)، هو إضافة للمجلس العسكري، ولديهم قرابة العامين من الفترة الانتقالية لتراكمه، ومن بعده القذف بالحكومة وهياكلها (إن صمدت حتى ذلك الوقت) وفرض سيطرته.
هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ نعم، يحتاج الأمر لخيال وثقة في الحراك الثوري للتوصل لانتقال يقلل من قدرة المجلس العسكري على مواصلة سيطرته على الاقتصاد الموازي الضخم، بدلاً عن المحافظة عليه.
حسام هلالي: حديث عمار عن المشاعر السياسية أحالني إلى ظاهرة أخرى، ليست المشاعر ذاتها، بل تقلباتها، وخلال فترة وجيزة (إذا اتفقنا أن ثمانية أشهر هي كذلك) فديسمبر البداية كان مشحوناً بعودة التفاؤل الذي يصحب بداية أي حراك ثوري منذ ٢٠١٠م، سرعان ما تحول ذلك التفاؤل إلى شحنة من الغضب ضد قتل المتظاهرين، ومع ازدياد المواكب طوال الأسابيع الأولى، بدأت حالة من الثقة الشعبية في الجماهير نفسها على أننا نعيش أيام الإنقاذ الأخيرة، لكن امتلاك أبسط أدوات للتحليل السياسي وضعتنا أمام هشاشة النخبة السياسية في تكوين تحالف عريض يحقق شيئاً أكبر من اتفاق الحدود الدنيا، إضافة إلى تعقيدات جهاز دولة الإنقاذ العسكري، أي تعدد الأقطاب المتصارعة والمتناقضة المصالح في المعسكر المضاد للثورة نفسه، ما جعلنا نشعر بالخوف أيضاً، ثم جاءت نشوة النصر والثقة العمياء بعد الإطاحة بالبشير وتأسيس كميونة القيادة التي امتلأت بمشاعر جديدة تماماً تليق بالبدايات التي يشوبها التفاؤل والقوة والتحدي.. سرعان ما تحول ذلك إلى انكسار وبؤس ورعب في وقائع فض الاعتصام واحتلال الخرطوم بقوات الدعم السريع ومظاهر الحرب الأهلية التي لم يعتدْ عليها سكان الوسط النيلي طوال حروب سودان ما بعد الاستقلال، وأخيراً هذا الشقاق في الموقف والشعور أيضاً الذي أشرنا إليه سابقاً في المفتتح بين مشارك في “فرح السودان”، ومتفاءل بالاتفاق وربما تَعِب من كل ما مضى، وبين غاضب يرى أن كل هذا سينتهي إلى فشل وعودة مع ديسمبر ٢٠١٩ إلى ديسمبر ٢٠١٨ أي المربع الأول.
ثمة وقفة يجب أن نأخذها أمام كل هذه التحولات الجذرية في هذا الوقت الوجيز.. لم يكن ما أنجز متوقعاً – على الأقل بالنسبة إلى متشائم مثلي – لذا أسأل: هل الفرح مشروع في هذا الموضع، أم أن علينا مواصلة القلق والخوف؛ لأن كل هذا سيصطدم في نهاية المطاف بمصاعب اليومي وحقيقة أننا في دولة واقتصاد منهار؟ هل هذه هدنة؟

عمار: علينا البدء بتمييز نيتشوي للمشاعر بين نبيلة وخسيسة، لكن أيضاً عدم جعل الأولى نقيضة للتقدمية والثانية رجعية، أو ثورية مقابل إصلاحية… إلخ. وإن كان من ضرورة هنا لثنائية مقابلة للمشاعر النبيلة والأخرى الرديئة؛ فلن تكون سوى قوى الفعل ورد الفعل. لأجل بناء قوى الفعل، نحتاج في البدء إلى نحت تصورات جديدة للذات خارج حدود التمثيل، ذات وإن كانت حرة من غيرها لكنها جماعية، أو على الأقل لا ترغب سوى في التعبير الجماعي عن فرادتها. وهو الشيء الذي وجد شكله المادي في ميدان القيادة. أزعم هنا أن الاحتمالات لإرادة اقتدار جماعية وفرتها ميادين الاعتصام منذ أبريل لم تُستَكْنَهْ بعد. من هناك يجب أن يبدأ كل تفكير سياسي جديد لسودان جديد.