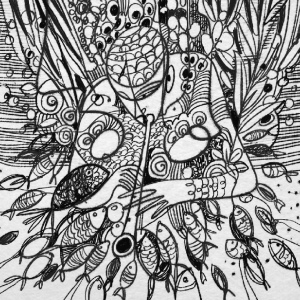بورتريه الفنان الرشيد أحمد عيسى بريشة الفنان التشكيلي عماد عبد الله
في أول حوار مع نقيب الدراميين المنتخب الفنان والمخرج الرشيد أحمد عيسى أدلى برؤيته حول الأوضاع السياسية والثقافية في السودان، وطبيعة المهام النقابية الملقاة على عاتق النقابة، وكيف سيؤثر قيام النقابات – في وضع مرتبك سياسياً وحالة من انغلاق الأفق – على المشاهد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالبلاد، والكيفية التي تكونت بها نقابة الدراميين.
* لماذا – برأيك – تعذر على السودانيين كتابة دستور مُرتضى عليه؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الفنان والمثقف من رؤية في هذا الجانب؟
أعتقد أن الرعيل الأول الذي جاء بالاستقلال لم يكن يملك رؤية واضحة. هناك مجموعة من المثقفين المهمومين – لكي لا نظلمهم – لكن كان هناك ضعف شديد في رؤيتهم لهذا السودان العظيم، ولم يستصحبوا معهم هذا التنوع المذهل والكبير لوطن مترامي الأطراف وشديد التعقيد. فعدد القبائل فقط 573 قبيلة إضافة إلى أكثر من ثلاثين قومية. هذا التنوع الثر إضافة إلى التنوع الجغرافي والمناخي الكبير – هذا غير أن السودان مترامي الأطراف ومفتوح على 9 دول – لم يكن مُستوعَباً لدى الرعيل الأول. وللأسف الشديد ساهمت في تكوين الأحزاب الكبيرة في السودان أيادٍ أجنبية، مثل المخابرات الإنجليزية والمصرية. إن أصحاب الامتيازات التاريخية لم يكن في تصوراتهم أن يكون السودان بهذا الاتساع والتنوع. لم يكن في تصوراتهم أن يضعوا دستوراً مستنداً إلى مشروع وطني يشمل كل هذا التنوع الفسيفسائي، ويستطيع أن ينقل هذا البلد إلى مصاف التقدم والنهضة. كما أن الأطماع الخارجية التي حاصرت هذا البلد منذ الاستعمار وحتى الآن، كان لها تأثير عظيم جداً على اتخاذ القرار. والآن دخلت في هذا الاستقطاب دول جديدة كدولة الإمارات، إضافة إلى مصر أمريكا والدول الأوروبية، ودول الجوار التي دخلت من خلال استخباراتها لتتكسّب من هذا البلد وفق مصالحها، والسودان بغناه الفاحش والثر بثرواته في باطن الأرض وفوقها مغرٍ للتدخل الخارجي. أعتقد أن كل هذه الأسباب حدَّت من وصول السودانيين إلى دستور مرتضى عليه. وغرق السودان في الدائرة الشريرة: (ديمقراطية – انقلاب – حزب طائفي -انقلاب وهكذا)، ومن الملاحظ أن العسكر والأحزاب الطائفية ظلوا يتناوبون على الحكم في مختلف فترات ما بعد استقلال السودان. أعتقد أن هذا الأمر لم يكن صدفة، بل بتخطيط من أصحاب الامتيازات التاريخية وأصحاب المصالح المشتركة.
في ظل هذا الوضع ينبغي أن يستقل الفنانون والمثقفون في هذه الفترة، بصنع مؤسساتهم ونقاباتهم والأجسام التي تعبر عنهم. نحن بوصفنا نقابة للدراميين لن نترك للسياسي مرة أخرى أن يخطط لنا مشروعنا الثقافي، أو أن يخطط لنا كيف يمكن أن يكون لنا حضور في المشهد السوداني، لأنه منذ أكثر من 120 عاماً كان الفنان يعمل على وحدة النسيج السوداني، منذ خليل فرح وعبيد عبد النور الذي اصطنع مسرحاً مقاوماً بكلية غردون، ثم صديق فريد وعمل معه علي عبد اللطيف، واستمر المسرح مقاوماً حتى نظام الإنقاذ وكان منحازاً لقضايا شعبه. وأعتقد أن هذه مسألة واضحة ومعروفة، فقد أوقفت لنا أربع مسرحيات في بداية نظام الانقاذ: مأساة يرول، الناس الركبوا الطرورة، قبة النار، وغيرها، وتمت محاصرتنا لكي لا تُعرض. أعتقد أنه بوجود نقابات لديها رؤية واضحة في الشأن الثقافي السوداني، والسياسي أيضاً، يمكن أن يؤديه الفنانون أدوارهم الاجتماعية والثقافية والسياسية بشحذ الوعي.. ولدينا خطط واستراتيجيات واضحة في التخطيط لموضوع المسرح والدراما في المرحلة القادمة. ولولا ثورة الشباب لما كان هذا التغيير الذي حدث وما زال يحدث..
*كيف يمكن أن نفكر في الضمانات التي تحول دون خرق الدساتير السودانية؟ وتحول دون الرجوع إلى الدائرة الشريرة (انقلاب – انتفاضة/ثورة – ديمقراطية – انقلاب)؟
بمزيد من العمل على توعية الشعب السوداني، نستطيع إيجاد ضمانات. ومع عدم وجود برامج للأحزاب ونأيها عن العمل الاجتماعي والثقافي تصبح هذه المهمة الجسيمة تقع على عاتق المثقف. في السبعينيات والثمانينيات كنا نشاهد الأحزاب وهي تقيم ندواتها وسط الجماهير، وكنا نرى الساسة ينخرطون في توعية الجماهير على عكس ما نشهده الآن من انعزال عن صوت وبصيرة الشارع، فليس هناك أحزاب تقوم بهذا العمل. برامج الأحزاب ينبغي أن تكون في العمل المباشر مع الجماهير، فأيّ حزب الآن لديه برامج تقتنع بها الجماهير وتحميها لتنتخبه وتؤسس وعيا سياسيا؟! الضمان الآن هو الاشتغال على الوعي المستمر.
بالنسبة لي فالدراما هي من الفنون المهمة جداً التي التي يمكن أن تساهم في تشكيل الوعي، وبالتالي تساهم في وضع ضمانات للخروج من الدائرة الشريرة للانقلابات والديمقراطيات. ولدينا وسائل المسرح التفاعلي ومسرح الشارع والفرجة، إضافة إلى المسرح التقليدي. ونحن لدينا أسئلة كثيرة جداً في التجريب للمسرح، فأي مسرح نريد، وأسئلتنا ما زالت مطروحة حول إيجاد أشكال مسرحية تناسب الإنسان السوداني وطريقة فرجته. فالدراما ترتبط بأسئلة الإنسان المباشرة.
*كيف نقرأ ثورة ديسمبر جمالياً استناداً إلى ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل؟
الكثيرون يتحدثون عن ثورة ديسمبر بوصفها ثورة الفنون، وكما قالت الفنانة التشكيلية كمالا إسحق هي ثورة التشكيليين بلا منازع. وأعتقد أن ثورة ديسمبر لم تبدأ بلحظة انطلاقها المؤرخة بديسمبر 2019م، فما قبل ذلك كان هناك فعل جمالي مقاوم ومن ضمن ذلك المسرح، الذي عانى من الإيقاف طوال نظام الإنقاذ الذي كان لديه هلع من المسرح خوفاً من الإسقاط السياسي. عدا ذلك أعتقد أن الشباب انطلقوا وقدموا مسرحاً مقاوماً في فترة التسعينيات وحتى قيام الثورة في الأطراف والعاصمة، وساهم في ذلك المسرح التفاعلي ومسرح الشارع، وكانت هناك مقاومة سياسية كبيرة من خلال المسرح، كما أن هناك مقاومة أيضاً من خلال التشكيل والموسيقى. أما بالنسبة لثورة أكتوبر، فقد كانت حينها المثقفون مشغولين بقضايا مثل سؤال الهوية التي عبرت عنه مدرسة الغابة والصحراء: محمد عبد الحي، محمد المكي إبراهيم، النور عثمان أبكر، يوسف عيدابي، وكذلك مدرسة الخرطوم في التشكيل، إضافة إلى إسهام الفنانين محمد وردي ومحمد الامين وهاشم صديق على مستوى الغناء والموسيقى، لذلك كان المنتوج في ثورة أكتوبر متميزاً جداً وعظيماً. أما المنتج الجمالي في ثورة ديسمبر فيتناسب مع عصره. إن تاريخ الثورات السودانية الطويل والممتد منذ ثورة 1924م ظلت الفنون تمده بما يناسب روح العصر. وأعتقد أن هناك امتداداً جمالياً بين ثورتي أكتوبر وأبريل، فنفس الفنانين الذين قدموا منتوجهم في أكتوبر قدموا منتوجهم في أبريل، وهو جيل قاد ثورتين، لكن في المقابل كانت ثورة ديسمبر نتاجاً طبيعياً لتراكم المد الثوري في التجربة السودانية، وكل هذا يثبت أن للفنون القدح المعلى في التغيير. إن النخب السياسية السودانية كانت وما زالت تعتبر الفنون مجرد مكمل لمشهدها، كأي مكمل غذائي! ويعتقدون أن هذه هي أدوار الفنانين فقط دون الوعي بأثر الفنون على وعي الشعوب. الفنون ستظل تقود العالم وفي السودان ستقود الفنون الشعب كما قادته خلال 120 عاماً، منذ خليل فرح والعبادي ثم الجيل الذي يليهم، وكل الأجيال الفنية كان لها دور متعاظم في تراكم الوعي في السودان. الفنانون ظلوا يؤدون أدواراً عظيمةً في الثورات، لكن عندما تأتي اللحظة الحاسمة يدخل السياسيون ذوو الأحلام الصغيرة الذين لا يرون إلا ما هو تحت أنوفهم، فيسرقون الثورات، وهكذا على الدوام، فكما أن هناك دائرة شريرة للانقلابات، فهناك دائرة شريرة في سرقة الثورات. أصحاب الثورة الحقيقيون يكونون خارج مشهد التخطيط بعد نجاح الثورات ويدخل لاعبون آخرون من الأبواب الخلفية والنوافذ.
*كيف ترى طبيعة النظام الذي ثارت عليه ديسمبر؟ وكيف أثّر على الأحداث والاتجاهات السياسية بعد سقوطه؟
مؤكد أن نظام الإنقاذ (نظام الحركة الإسلامية) لم يبدأ استحواذه على السلطة في 1989م، فكثير من السودانيين تغيب عنهم هذه الحقيقة، وهي أن نظام الإسلاميين قد بدأ في العام 1977م، إبان المصالحة الوطنية مع النميري، التي كان يفترض أن تضم ثلاثة أقطاب: الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأمة، والجبهة الإسلامية، انسحب حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي، وانفرد الإخوان المسلمون بالمصالحة مع نميري ومن ثم سيطروا على كل أوجه الحياة السودانية، وبدأوا يلتفّون على الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية واستولوا عليها منذ ذلك الحين، وأول تغيير بدأ بعد ذلك كان قوانين سبتمبر 1983م، وكان كارثة من كوارث السودان التي حاقت بهذا الوطن العظيم، ثم إعدام شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه في 1985م، وهي قوانين أحدثت تغييراً كبيراً جداً في السودان وذاكرة الشعب السوداني وفي سايكولوجية وروح الشعب السوداني، وكان لها تأثير سيئ وكبير. ورغم أن الشعب السوداني بطبيعته مسلم في أغلبه، لكنه وسطي ويحترم الأديان جميعاً. ثورة أبريل تدخلت فيها الأيادي وعبثت بها ثم جاءت الانتخابات بعد عام وهي فترة مشبوهة في تاريخ الثورات السودانية.. ولم يستمر هذا النظام أكثر من ثلاث سنوات ثم تم الانقلاب عليه. حينها كانت المؤسسات الاقتصادية للإسلاميين راسخة كما قال حسن عبد الله الترابي، والمؤسسات الاقتصادية هي التي تستولي على الجماهير وفكرهم وحياتهم. ولذا أعتقد أن نظام الإنقاذ بدأ منذ 1977م، فعمره أكثر من ثلاثين عاماً، وكانت فترة الديمقراطية الثالثة فترة استراحة لينقض على النظام الديمقراطي ويستولي على كل شيء من مقدرات الشعب السوداني، وبعد 1989م فتت الأحزاب تفتيتاً دقيقاً، فحول أحزاب كالأمة والاتحادي إلى خمسة أو ستة أحزاب وغيّر الخارطة السياسية تغييراً كبيراً، مما كان له عميق الأثر في الحياة السياسية السودانية. وبعد ذلك سيطر الإسلاميون على كل حياة السودانيين، وأعتقد أن هذا التأثير انعكس على الثورة السودانية، فكانت الأحزاب السودانية بعد ديسمبر في حالة من التفكك والإعياء ولا حول لها ولا قوة، والأغرب من ذلك أننا كنا نشهد أن المعارضة السودانية تجتمع وتؤسس كل مرة تحالفاً، وهي لا تملك مشروعاً واضحاً كما ظهر بعد حدوث التغيير في 2019م، ولم يكن هناك اتفاق على المشروع الوطني السوداني، وكان كل حزب يفكر كيف يأخذ من هذه الغنيمة، وكان تفكيرهم ينحصر في كيفية إسقاط نظام الإنقاذ فقط، في الوقت الذي كانت تعد فيه الحركة الإسلامية خمسة أجيال لحكم السودان والأمر لم يكن بهذه البساطة التي تتخيلها الأحزاب السودانية. إنه أمر مؤسف!
*أنتجت ثورة ديسمبر واقعاً سياسياً جديداً، تشكلت لجان مقاومة كلاعب أساسي في السياسة، انشطرت الأحزاب السودانية في اتجاهات شتى، وتشكلت قوى اقتصادية أسهم فيها نظام الثلاثين من يونيو 89، وصار صراع الموارد مؤثراً في السياسة السودانية، كيف سيخرج السودانيون من عقبات كل ذلك للوصول إلى دولة الديمقراطية المستدامة؟
مؤكد أنه بعد كل هذه الثورات نشأ وعي جديد في المشهد السياسي السوداني، خاصة أن الثورة بدأت من الأطراف بالدمازين ثم عطبرة ثم بربر والأبيض وكسلا والشمالية وبورتسودان.. وهذه البداية عكست أن هناك وعياً جديداً بدأ ينطلق، وأن هذه الأطراف والأقاليم المهمشة لم تعد ملعباً للسياسي التقليدي، وظهرت قوى جديدة حديثة بوعي جديد. وأعتقد أن طول فترة القهر والإقصاء في ثلاثينية الإنقاذ الظلامية كان لها دور كبير في تشكيل الوعي الجديد. والأحزاب التقليدية لم يعد لها وجود مؤثر وكبير، فهذه الأحزاب بدأت تؤدي أدواراً ثانوية، ولكنها تحاول قدر الإمكان أن تستغل الفرصة وتصل إلى السلطة، وهذه إحدى مشكلاتها ومن تأثيرات تحالفاتها. مازالت الأحزاب بعيدة عن الوعي الجديد الذي يتشكل وبعيدة عن الثورة الشعبية الحقيقية، فهي دائماً ما تُسيء تقدير الحركة الثورية الحقيقية.
هناك قوى حديثة دخلت في المشهد السياسي صنعها نظام الإنقاذ، وتشكلت في الأطراف كإقليم دارفور، وصنعت مليشيات مقاومة مضادة للمليشيات التي صنعها نظام الإنقاذ، وأصبح الصراع بين الفئتين، وهذا أيضاً مشهد جديد في السياسة السودانية، والمليشيات التي تقاوم كانت تتحدث باسم الجماهير والشرائح المهمشة لكن وضح أنها تناضل من أجل الوصول إلى السلطة فقط، مما أفرز واقعاً جديداً. وتلك المليشيات ارتكزت إضافة إلى الصراع السياسي على صراع اقتصادي وصراع موارد، مما أثر على حياة السودانيين وللأسف الشديد كل الموارد والثروات المهمة في حياة الناس بأيدي هذه الميليشيات، وهذه من المواضيع التي لم يستطع شخص مثل حمدوك الوصول إلى حل فيها، والسبب أنه لم يكن سياسياً بل أهّلَه الثقل والتأييد الغربي، ولكن لم يستطع أن يكون له دور في تغيير المشهد. وهؤلاء لن يتخلوا عن مصالحهم بالسهولة التي يتخيلها كثيرون، ولكن الرهان في المرحلة القادمة على وعي الشعب السوداني.
السياسي السوداني دائما يبحث عن السلطة لذلك يتدخل – مثلاً – في تجمع المهنيين، الذي وضح أن أزمته أزمة وعي ولذلك سَهُلَ اختراقه. المرحلة القادمة هي مرحلة الوعي. مهمتنا بوصفنا فنانين هي صناعة الوعي والارتقاء به لدى الشعب السوداني.
*بعد تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، يؤكد مرة أخرى تكوين نقابة الدراميين، الجملة الثورية المؤثرة “الثورة نقابة ولجنة حي”.. كيف سيؤثر قيام النقابات – في وضع مرتبك سياسياً وحالة من انغلاق الأفق – على المشاهد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟
لحظة اندلاع ثورة ديسمبر لم أكن في السودان، لكنّنا كنا نتابع المشهد بدقة وخصوصاً نتابع كيف يؤدي السياسي السوداني دوره.. السياسي السوداني في ثورة ديسمبر كان مرتبكاً وهشاً وضعيفاً للغاية، والارتباك وضح في كل أفعاله وعدم قدرته على أن يكون هناك اتفاق على مشروع وطني سوداني، لذلك أعتقد أن التعويل على أدوار جديدة لمؤسسات جديدة هو الذي سيُنقذ هذا الوضع. وفي رأيي هذه المؤسسات تتمثل في النقابات ومن ضمنها نقابة الصحفيين كأول نقابة تشكلت لممثلي السلطة الرابعة والصحافة السودانية ذات تأثير كبير جداً رغم ما واجهته من قمع وتأميم وتكميم للحريات. ورغم الواقع المرير والثورة المضادة أعتقد أن نقابة الصحفيين ستحدث فرقاً كبيراً على مستوى الواقع. أما نقابة الدراميين فستحدث الفرق الأكبر.. نحن لدينا فن التعبير الأعلى، كما وصفه هيجل، الذي يتقارب مع الفلسفة في أسئلة الوجود: من أنا؟ لماذا أنفعل بالوجود؟ وكيف أجاري هذه الحياة؟.. المسرح يجعل الإنسان يرى حياته مرتين وهذا هو الوعي بأنك ترى حياتك للمرة الثانية وعندما يحدث ذلك ينفجر الوعي لدى المشاهد. المسرح وعي مستمر بالحياة كما الصحافة، ولكن مع هذا الانغلاق الذي تحدثت عنه نحن ديدنُنا الأمل ولن نتوقف، فإذا توقف الفنان توقفت حركة الأمل، دورنا أن نزرع الأمل ولن نتوقف.
*رغم حالة الانقسام التي كان يعاني منها الدراميون، إلا أن الكيفية التي تكونت بها نقابة الدراميين، اعتمدت على إعطاء قدر متساوٍ من التمثيل عبر كل ولايات السودان، وصارت أحد الأمثلة القاعدية التي يمكن أن تعد نموذجاً لتكوين النقابات.. كيف ترى مهام نقابة الدراميين في هذه المرحلة؟
اسمح لي أن أترحم على شهداء الثورة العظيمة الذين قدموا لنا نموذجاً لوعي السودانيين بالثورة، ووعيهم بدورهم في بناء هذا الوطن العظيم، وقد قدموا أرواحهم الغالية، وقدموا أمثلة نادرة تمثل التراكم الموضوعي لحركة الثورات السودانية.. وستُقام لهم المتاحف التماثيل بعد وصول الثورة إلى غاياتها.
بدأت المبادرة بتكوين نقابة الدراميين من الأطراف، بدأت من مدني حيث منبع الوعي ومؤتمر الخريجين 1938م، ولهذا رمزية لها دلالات كبيرة جداً، كذلك توجهوا نحو عطبرة ثم إلى الدمازين، وذهبوا إلى كل هذه الأماكن، وأسسوا النقابات الفرعية، ثم جاءوا إلى الخرطوم، وهذا يمثل مستوى وعي جديد، وسيُحدِثُ هذا فرقاً كبيراً، وتكونت النقابات الفرعية ومجالس لإداراتها، ثم اللجنة المركزية ثم المجلس المركزي الذي يراقب عمل اللجان، ووضعوا دستوراً مميزاً ومختلفاً. في كل ذلك نحن نعتقد أن الحركة الدرامية تحتاج إلى أن نعمل على لمِّ الشمل، وهذه من القضايا الأساسية التي سنعمل عليها في الفترة القادمة.
البرامج التي سنعمل عليها: إحياء الحركة المسرحية، وضمنت ذلك في خطابي، وسنعمل مع الجهات والمؤسسات التي كانت قائمة على تخطيط العمل مسرحي مثل المسرح القومي، وأعتقد أنه كان هناك تخطيط مميز حتى 1989م، وسنعمل على إعادة تكوين الفرق المسرحية وتأسيسها بشكل صحيح، وتنظيم مجالس إدارتها وعضويتها، وسنعمل مع الجهات المشغّلة للدراما والدراميين مثل الإذاعة والتلفزيون، وسيكون هناك اتفاق جديد حول كيفية التعامل مع المبدع وحقوقه، وسنعمل على رفع الأجور المتدنية، وسنساهم في التخطيط للشأن الدرامي مع الجهات التي ستتولى أمر الثقافة. ولن يكون لنا أي علاقة مع أي مؤسسة حزبية تريد أن تدجن الفنان لصالحها. وسنعفي الدراميين ممن تجاوزوا الستين عاماً من الاشتراكات.
أما بالنسبة لتمثيل الدراميين هناك تمثيل للدراميين بالولايات رغم الثقل الخرطومي.. وكان هناك توافق على القائمة التي انتُخبت، وهي كانت بمقاييس دقيقة جداً. إن المرحلة القادمة هي مرحلة لمّ الشمل لأن النقابة ليست حزباً سياسياً، لكن هذا لا يعني أنا لا يكون للفنان الدرامي رأي مستقل.. سنعمل من خلال النقابة على الحفاظ على حقوق الدراميين والارتقاء بالمهنة والفنان والمساهمة في وضع السياسات الثقافية فيما يخص الجانب الدرامي. والمهام في المرحلة القادمة مهام معقدة جداً خاصة أننا ورثنا حطاماً على مستوى البنيات التحتية، وسنبحث عن شركاء جدد لتأهيل المسارح ولا بد أن يعرف من هم على رأس الدولة أننا سنقود مؤسساتنا ونؤهلها ولن نترك بلادنا للصدف أو للظلاميين.