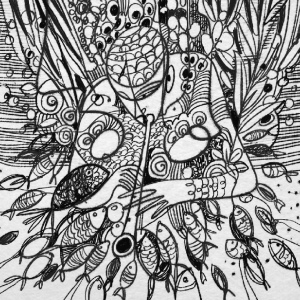غفاري فضل السيد
يُعتقد، على نطاق واسع، أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي العلم الذي يسعى إلى فهم الإنسان من حيث كونه جزءاً من كُـلٍ أوسع منه، هو المجتمع البشري الذي ينغرس فيه الأفراد جميعاً عبر شبكة أو منظومة علاقات متعددة ومعقدة، تنشأ عنها مؤسساتٌ ومركبات ثقافية شتى، تشكل معاً، وتعيد، بالمقابل، تشكيل الإنسان على نحو دائم؛ ويصبح في أحيان كثيرة للإنسان بدوره القدرة، وربما الحق، في تشكيلها على نحو دائم أيضاً، من خلال الجهد الواعي وغير الواعي في علاقة دينامية تتبادل التأثر والتأثير أبداً.
وإذا كانت الأنثربولوجيا الاجتماعية، بمعنى إمكانية فهم الإنسان وسلوكه ومؤسساته ومركباته وأنظمته الثقافية تلك، على نحوٍ علمي، أي موضوعي، مرتبطةً بإسهامات ابن خلدون (1332- 1406) وعصر الأنوار ومجهودات أوجست كونت (1798-1857) وغيرهما من مفكري أواسط القرن التاسع عشر وما بعده، فمن الخطأ البيـِّن إذاً ربط هذا العلم بظاهرة الاستعمار الذي لم يكن قد تبلور بعد على نحو كامل حتى العامين (1884- 1885) عندما تداعى المؤتمرون في (مؤتمر برلين) لتقاسم العالم.
لذلك فإن معاداة بعض الأنظمة السياسية الأفريقية في حقبة (ما بعد الاستعمار) لهذا العلم لم تكن موفقة، بل لقد كانت مؤسفةً للغاية، لأنها حرمت نفسها، أي هذه الأنظمة، من الاستفادة المبكرة في مراحل البناء الوطني الأولى المفصلية في تاريخها، كما ثبتَ لاحقاً، من نتائج بحوث ودراسات الأنثروبولوجيا الاجتماعية بما يمكنها من تحقيق وعيٍ أفضل بذواتها والاسهام بطريقة أكثر فاعلية في عملية تحرُّرها من الاستعمار نفسه، ناهيك عن غيرهما من المجالات.
لقد كانت أحد أفكار عصر الأنوار الرئيسية (القرن الثامن عشر) هي “فكرة التقدم” التي تقول إن التاريخ البشري على ظهر هذا الكوكب يتقدم إلى الأمام دائماً، وأن ما تخلى عنه الإنسان خلال مسيرته الطويلة من مؤسسات، كمؤسسة الرق، مثلاً، وما استحدثه من مؤسسات جديدة كمنظمة الأمم المتحدة، كحكومة عالمية، قد جعلت من العصر الحالي الذي نعيش فيه خير العصور التي عاشتها البشرية أبداً، وأنه إذا كان في إمكان أي امرئ عاقل المفاضلة بين العصور الكثيرة التي تصرّمت لما اختار عصراً ليعيش فيه سوى عصرنا الحاضر، بل سنتنا هذه، لا بل هذه الساعة التي يكتب فيها هذا الكلام.
ويبدو الآن أن فكرة التقدم المستمر، كانت من الرسوخ بحيث لم تستطع موجات متعاقبة من الحروب الأهلية والعالمية، امتهنت فيها كرامة الإنسان على نحو غير مسبوق ودُمرت في هيجانها الجنوني مظاهر الحضارة، كما لم تستطع أيضاً عقود من الفقر المخيف والتفاوت الطبقي السافر والاستغلال على الصعيد العالمي ومظاهر التدهور البيئي الذي تسبب فيه الإنسان نفسه، لم تستطع جميع هذه المظاهر وغيرها زلزلة الرسوخ المدهش لهذه الفكرة في المخيلة والذهن الإنساني. بل لسنا نُـبعد كثيراً إن قلنا بأنها تحولت إلى نوعٍ من أنواع الدوغماتية العميقة والمتأصلة في الفكر المعاصر.
دُفعت هذه الفكرة إلى الأمام أكثر بواسطة الحداثة الأوربية نفسها(Appleby et al., 1995: p. 78)، وهي حركة ذهنية في الأساس، تسيَّدت الفضاء الأوروبي منذ نحو ثلاثة قرون، على أقل تقدير. وأحد أهم مرتكزاتها هو أن الإنسان هو المالك الوحيد لمصيره، وأن بإمكانه لذلك تحقيق استقلاله العقلي والوجداني وحريته ورفاهيته المادية جميعاً استناداً لمجهوده هو دون كل عون خارجي: أي خارج ذاته (Giddens 1998: p. 94). بيد أن ذلك لن يكون ممكناً بالطبع إلا عبر امتلاك “المعرفة العلمية” بالقوانين التي تحكم تطور المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان على تنوع هذه القوانين وتعقدها.
ولذلك كانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية منذ بواكيرها الأولى أداة لتحقيق هذا الفهم، فهي عندما سعت إلى فهم “الشعوب البدائية” كانت تتطلع في الأساس إلى تحقيق فهم أعمق للتطور الذي أصاب مجتمعاتها هي، أي المجتمعات التي انتجت الانثروبولوجيا الاجتماعية نفسها كعلم، فعبر تحقيق ذلك الفهم وحده يمكنها إدراك المراحل المختلفة التي تطورت منها المجتمعات الغربية، ويمكن، بالتالي، العمل على معالجة مشكلاتها وتوجيه تطورها المستقبلي اتجاهات معينة مرغوبة.
وفي هذا السياق يمكننا الاِقتِباس من ايمانويل فالرشتين (في سعيد، 2003: ص. 74) عندما أثبت أن: “العلوم الاجتماعية ]وأحاجج أن الإنسانيات الحديثة ولدت هي أيضاً[ رداً على مشكلات أوروبية ]في بلدان خمسة هي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية[ في لحظة تاريخية كانت فيها أوروبا الغربية تسيطر على النظام العالمي. فكان مفهوماً تقريباً أن يأتي اختيارها لموضوعها وتنظيرها ومنهجيتها ونظريتها المعرفية انعكاساً للقيود المفروضة على البوتقة التي نشأت بها“[i]. أضف إلى ذلك أن نتائج هذه الدراسات التي قام بها الانثروبولجيون الأوائل قد تم استغلالها فعلاً في وقت لاحق للتحكم في الشعوب المستعمَرة، عندما حلت مرحلة الاستعمار المباشر، ولكن كان ذلك منتوجاً جانبياً (By-product) وليس هدفاً مقصوداً لعملية البحث ذاتها. [i] الأقواس داخل النص من عمل ايمانويل فالرشتين نفسه.
وبهذا فيمكننا إدراك أن الانثروبولوجيا الاجتماعية كانت علماً تطبيقياً منذ بواكيره الأولى. لذلك استطاع، بعد تخلـُّص الشعوب من عبء الاستعمار المباشر المبهظ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وابتدار عمليات إعادة الإعمار في القارة الأوروبية نفسها التي كانت أكثر القارات تأثراً بالحرب، استطاع علمُ الانثروبولوجيا الاجتماعية بكل يُسـر تصدر مشهد ما عرف حينها بنظريات التحديث (Modernization theories) في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في بلدان “العالم الثالث” كما كانت تعرف شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في حقبة الحرب الباردة، حيث كانت تسعى جاهدةً إلى التخلص بدورها من تبعات فترة استعمارها الثقيلة.
تحولت قضيةُ التنمية ذاتها شيئاً فشيئاً في مثل هذه المجتمعات إلى جزء من عمليات إضفاء شرعية متوهمة على الأنظمة التي أعقبت الحقبة الاستعمارية. ولكن بعد انهيار مشاريع الدول القومية في كل مكان عبر القارات الثلاث وتأكـُّد العجز الواضح لدولة ما بعد الاستعمارة منفردةً عن ابتداع أي أنموذج تنموي فعال أو مستدام بعيداً عن الشروط المسبقة التي تفرضها قوى العالم المستعمِر السابق. تحولت التنمية، أو بالأحرى تحول التبشيرُ بها، إلى أداة من أدوات السيطرة والتحكم التي تصطنعها النخب لمقارعة المنافسين من الخصوم من الراغبين في تحقيق نماذج تنموية بديلة أو ينافسونهم من أجل محض السلطة، هذا من جهة. أما من الجهة المقابلة فقد استخدمت الكلمة أيضاً على نطاق واسع من قبل دوائر السلطة حيث كانت لاقناع الشعوب بالبقاء منتظرةً لأن: “هناك شيئاً ما يفعل من أجلها”.

تلقف المصطلح أيضاً العديد من المنظمات الدولية العابرة للقارات والتي هي بالكاد تفعل شيئاً، كما اختطفه كذلك عددٌ كبير من الشركات الكبرى متعدية الجنسية على المستوى العالمي أو تلك الشركات الأصغر داخل كل قطر على حدةٍ، واصبح اقتران لفظ “التنمية” مع أسماء برَّاقة ومتفائلة من كل نوع موضةً استطاعت أن تعبر بنجاحٍ يقتضي العجب العقود الأربعة الأخيرة. ذلك رغم الشك الواضح في جدوى النماذج التنموية التي تقدمها الليبّـرالية في نسختها الجديدة (انظر أمين، 2014) والتي اندغمت، من أسف، بدورها على نحوٍ متزايد في المِـخيال الشعبي العالمي، وتسربت عميقاً إلى أدمغة النـُخب في كلّ مكان، وارتبطت عضوياً بفكرة التقدم التي هي وليد شرعي للفضاء الحضاري الغربي فحسب، لاسيما في شقه الأوروبي.
ورغم اليقين المتزايد بأن مختلف مشكلات التخلف تتناسل أميبياً اليوم في كل مكان من الدول النامية، وهو بالمناسبة، تلطيف منافق لتعبير آخر أكثر سذاجةً ولكنه أكثر صدقاً وهو “الدول المتخلفة”. رغم هذا اليقين، وبروز أوضاع تنبيء بأن الأمور أبعد ما تكون عن الحـل أكثر من أي وقت مضى في “دول الجنوب”، تعبير لطيف آخر ولكنه مخادع، إلا أن الإيمان بالتنمية كـَقـَدر (بمفهومها الليبّـرالي بالطبع) لا يجد في عالم اليوم إلا القليل من المقاومة بين الحكومات غير الشرعية المثقلة بالمشكلات، والتي لا تمتلك أية رؤية ولا تبشر بأي مشروع والمثقفين المتحذلقين عديمي الحيلة الذين تقطعت بهم السُـبل وخبراء التنمية الدوليين ذوي السُـترات الأنيقة والإبتسامات المتخشبة.
إلا أنهم جميعاً، فيما يبدو، قلما يشيرون إلى حقيقة واضحة لا تتطلب إمكانات عقلية خارقة كي يتم إدراكها على نحوٍ جيد، وهي أن البناء القِـيمي المتخلف – ولا أقصد بهذه الكلمة سوى التأخر عن الآخرين– لا يمكنه أبداً وتحت كل الظروف، مهما بلغت القدرة على ترقيعه وأقلمته، أن ينتج تنمية حقيقة وفقاً للنمط الغربي الليبّرالي، في كل نطاقات الاقتصاديات التابعة، تمكنه من تجاوز شروط تخلفه. كما أن القليل من النقد، أيضاً، تم تقديمه لحقيقة أن المظاهر المادية للتنمية من بـُنى تحتية وخدمات اجتماعية مختلفة، على افتراض كمالها وكفايتها، لا يمكن لها وحدها أن تنتج الحالة الذهنية التي يجب أن تسود قبل وأثناء وبعد استحداث عملية النمو نفسها ضماناً لاستدامتها على الأقل.
قليلون فقط من بين الكتاب كانوا من الرصانة بمكانٍ ليشيروا إلى أن هذه الكلمة السحرية “التـنـمـية”، ليست طرقاً تنبسط أو جسوراً تـُبنى أو متنزهات ومبان عامة تـُنشأ على افتراض أدائها وظائف للجميع، ولكن التـنـمـية، قبل ذلك وأثناءه وبعده أيضاً، يجب أن تكون حزمةً من القيم الإيجابية الحافزة للنمو والمحافظة عليه – أي ببساطة الهادفة الى تحسين ظروف حياة الناس– مثل المحاسبية والمؤسسية والشفافية والمشاركة والتشاركية واستدماج لكافة شرائح المجتمع وانحياز ايجابي لمختلف مجاميعه المـُبعدة، والعدالة في توزيع فوائد النمو رأسياً وأفقياً والتوازن بين السلطات والمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل تبعاته وتوزيع مراكز اتخاذه مع التنسيق بين هذه المراكز في نفس الوقت، إنها، بعبارة أخرى، حفزٌ للعوامل الداخلية– الجوانية – من الإنسان بما يدفعه إلى تحسين ظروف حياته إلى الأفضل عبر الجهد الإرادي الواعي والخلاق في نفس الوقت، بدلاً من المجال الخارجي – الموضوعي – الذي غالباً ما يشار إليه.
كانت لذلك مؤسسات برايتون وودز (البنك والصندوق الدوليان) صادقةً مع نفسها، جزئياً على الأقل، عندما أكدتا، وغيرُهما، لزومَ الحاجة إلى وجود، أو ايجاد، سياقاتٍ وأنظمة سياسية معافاة ومسؤولة قبل الشروع حتى في إجراءات واستراتجيات التنمية كما تقترحها هذه المؤسسات التي لم تنجح، من أسف، حتى الآن في انتشال بلدٍ واحد عبر القارات الثلاثة من ربقة التخلف وإلحاقه بزمن الحداثة الفائق ووعودها الرائعة. وغني عن البيان أن تواطئاً يقوم على الخدمات المتبادلة قد تم تطويره بين هذه المؤسسات جميعها والبلدان النامية، أو السـُـلط في هذه البلدان، التي يُـفترض أنها تسعى إلى اللحوق بركب النمو.
لكل هذه الاعتبارات يمكننا الخلوص إلى استنتاجين هامين، الأول هو أن قضية التنمية تعتبر في الأساس، لاسيما في مثل بلداننا، الميدان الأهم لعمل الانثروبولوجيا الاجتماعية التي خصصت أحد فروعها الرئيسية لدراسة هذه الظاهرة الإنسانية المثيرة واسمته انثروبولوجيا التنمية. كما يتبدى الإستنتاج الثاني في أن الشكوك التي ما أنفك يبديها دارسو الانثروبولوجيا حول العالم للتنمية كفكرةٍ ومفهومٍ وايدولوجيا، فسُـلطة تتأسس على كل ذلك، لها ما يبررها خاصة بعد أن ظهر بجلاء أنه، أي هذا المفهوم، أحد أدوات استدامة السيطرة والقوة والنفوذ على المستويين الدولي والمحلي في آن.
المراجع
أمين، سمير. (2014). هل تمثل مجموعة الدول الصاعدة بديلاً للعولمة الفجة؟ مقال نشرته صحيفة الاهرام المصرية، متاح على الربط: https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=192506. (تمت زيارته في 2017.08.03)
سعيد، إدوارد (2003). الأنسنية والنقد الديمقراطي. ترجمة (فواز طرابلسي). دار الآداب – بيروت.
Appleby, Joyce; Lynn Hunt, and Margaret Jacob (1995). Telling the Truth about History. W.W. Norton, p. 78.
Barnett, H. G. (1958). Anthropology as an Applied Science. Human Organization. Vol. 17, No. 1 .
Giddens, Anthony. 1998. Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity. Stanford, Calif.: Stanford University Press